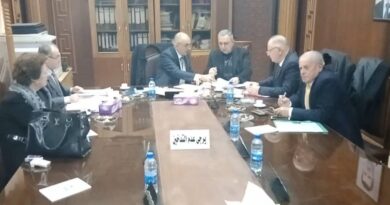تأثير الأحلاف والسياسات القطبية في علاقات الدول
ترجمة: إبراهيم أحمد
عن لوموند ديبلوماتيك
تربط فكرة الحلف بفكرة العدو، وبفكرة الزمن المديد رابطة قوية، والحلف – يُعرّف – في قاموس العلوم السياسية: بأنه علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب، وسياسة هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي، التي من حيث المبدأ، تعمّم مبدأ التحالف، حتى تجعله عالمياً بحيث يردع العدوان، ويتصدى له عند الضرورة. إن للتحالفات وظيفة ضرورية لتوازن القوى تعمل ضمن نظم الدول المتعددة، لذلك فهي قديمة قدم انشطار العالم إلى كيانات سياسية تصطرع على القوة والنفوذ.
والحلف كان ينشأ عن الحاجة إلى إقامة ميزان قوة، وإلى حماية من قد تهاجمهم القوى الأخرى، وإلى ردعها، وفي القرنين اللذين أعقبا سلم فيستفاليا 1647، كانت الأحلاف ضعيفة التماسك، وتصدعها “تكتلات” مفاجئة وطارئة تؤدي إلى سياسات وموازين جديدة ومختلفة، كما أن اختيار دولة ما لطريق الأحلاف ليست مسألة مبدأ، بل مسألة ملائمة، فالدولة تستغني عن أحلافها إذا ما هي اقتنعت بأنها من القوة بحيث يمكنها الصمود أمام أعدائها من دون دعم أحد، أو أن أعباء الارتباطات الناتجة عن الأحلاف تفوق حسناتها المرتقبة، فلأحد هذين السببين، أو لكليهما معاً، فعلى سبيل المثال: رفضت بريطانيا وأمريكا الارتباط فيما بينهما بأحلاف زمن السلم في الماضي، لكن اتساع رقعة اللعبة الدولية بين الكبار المتصارعين على النفوذ في العالم جعلت الأحلاف ضرورة لهما في الخمسينيات، وخاصة مع هبوب رياح الحرب الباردة.
التحالف يتطلب وجود مصالح مشتركة وثيقة لقيامه، يقول أحد المفكرين: “وحدة المصلحة هي الرباط الأكثر قوة سواء بين الدول أو الأفراد، وهذا ما يُعبّر عنه في اللغة السياسية بالقول “ليس في العلاقات الدولية صداقة دائمة أو عداوة دائمة، بل مصلحة دائمة”، ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، استقرت التكتلات، وشُيّدت أحلاف تخطت الظروف الطارئة التي دعت إليها، وعقدت هذه بين دول تشترك في غايات واحدة، وتُشخّص الأخطار التي تتهددها معاً تشخيصاً متقارباً، ودوام الأحلاف على هذا النحو توّج حلفي وارسو والأطلسي، ونجم عن صوغ العلاقات الدولية على مثال عام وشامل، شمل وجوه العلاقات الدولية كلها، ونحن إذ نشهد تصدع الأركان التي كانت قد استقرت عليها هذه العلاقات في القرن الماضي، ذلك أن فكرة العدو تنزع إلى الضعف، ويصيبها الارتخاء، وربما التلاشي، ولعل السبب في هذا الحال هو تعاظم تبعية الأطراف بعضها لبعض، والتغيرات التي طرأت على الأخطار نفسها، فهي صارت أقل تحديداً ووضوحاً، قياساً على حالها السابقة، وأقل ثباتاً.
ويقود غموض الأخطار والتهديدات، وتغيرها إلى اضطلاع الوقت، أو مدة التحالف بدور مختلف، فالصدام بين الدول قد ينشأ عن ظروف متقلبة تبطل مثال الحلف الثابت والمستقر، والعولمة على ما هي اليوم، تعد باستقلال القوى أو الدول بنفسها فوق ما تعد برابطة التحالف، وهي تضعف فكرة انخراط الدول الثابت في روابط عضوية. وعلى هذا، فالأحلاف ينتابها ضعف بنيوي يصيب روابط التضامن التي تشد الدول بعضها إلى بعض، وتعود العولمة من باب آخر إلى دائرة المصالح وتعريفها. فتزيد تعريفها تعقيداً على تعقيد، وتقلب مواقع حلفاء الأمس القريب رأساً على عقب ومؤقتاً، ولا ريب في أن السبب الرئيس في إضعاف شبكة الأحلاف التي نسجتها الولايات المتحدة حولها، هو أثر العولمة في العلاقات الدولية، أي في تعريف المصالح واضطرابه وتقلبه، والمفارقة هي أن تعريف المصالح بات أكثر مرونة بكثير من حاله في عهد القطبية الثنائية، لكن المرونة والتوسع ينتج عنهما الرخاوة والهلهلة.
وليس مستقبل الحلف الأطلسي بمنأى عن آثار الظواهر الطارئة أو المستجدات هذه، وتتطاول آثارها إلى روابط بدت مستقرة ومنيعة زمناً طويلاً، شأن روابط الدول الأمريكية، أو تلك التي افترض أنها تشد بعض دول الشرق الأوسط في الفلك الأمريكي، ففي عهد الثنائية القطبية كان بمستطاع الولايات المتحدة جمع هذه الدوائر وشبكها بذريعة تهديد النظام السوفييتي أجزاء العالم المتفرقة.
لم تبق الحكومات والدول وحدها من يعقد التحالفات ويختارها ويرعاها، فأصبح بعضها يتعلق باختيارات اجتماعية، وبعضها الآخر تقوده نزعات الرأي العام، أو سياسات أصحاب أدوار دولية فاعلين وراجحين في التأثير، ويقوّي النازع المجتمعي التنديد بالولايات المتحدة، وبالهيمنة الأمريكية، كما أن النكسات الاقتصادية، والخسائر الاجتماعية، والرضّات الثقافية، تحتسب كلها على علاقات السيطرة والهيمنة الدولية، والتنديد بالولايات المتحدة يترتب ترتيباً آلياً وتلقائياً على الاحتساب هذا، ويلاحظ المراقب الأمر في أمريكا اللاتينية من غير عسر، ولا تكلّف، ولا جهد، وهو اضطلع بدور راجح في خروج هذه المنطقة من دائرة النفوذ الأمريكي، ويشهد الشرق الأوسط الظاهرة نفسها مضاعفة أضعافاً، فمناصبة أمريكا العداء بلغت مستويات قياسية، وتتفق الحال هذه ليس مع أفول مزعوم يصيب الولايات المتحدة، بل مع أفول مثال القوة الدولية في صيغته التقليدية والمعروفة، ومهما بلغت الولايات المتحدة من القوة، اليوم، فهي خسرت مع طي صفحة الثنائية القطبية شطراً من جاذبيتها، فانكفأت العلاقات الدولية إلى تعددية قطبية بارزة، ففي وسع إحدى الدول الكبيرة أن تمتلك عوامل قوة راجحة، بل أن تفوق مواردها اليوم ما كانت عليه بالأمس، من غير أن تترتب على هذا جاذبية تضاهي الجاذبية السابقة، فالاستقلال بالنفس أصبح نهجاً أكثر عقلانية، ومكاسب الدول من استقلالها في تدبير شؤونها أكبر من مكاسب الالتجاء إلى قوة تلوذ بها.
ومنذ انهيار القطبية الثنائية استمات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب في محاولة المحافظة على أركان علاقات التحالف القائمة، فأقر الحلف الأطلسي على دوره، ووسّع دائرته، وأراد بناء عالم متماسك حول قطب واحد يقوم مقام مركز أحلاف جزئية تقود كلها إلى واشنطن.
لم تبق فكرة العالمي الواحد والمتصل في منأى عن المناقشة والتشكيك، وهي تترنح تدريجياً، فقد انحاز باراك أوباما إلى عالم تعددي لا تضطلع فيه الأحلاف، حكماً، بدور راجح، فمنذ عقد التسعينيات وحتى الآن، ومع تغير العالم، وانتهاء القطبية الثنائية، وتفكك الاتحاد السوفييتي السابق، ومنظومة الدول الاشتراكية، تثير التحالفات الدولية– التي تزعم تشكيلها واشنطن ولندن، وشاركت فيها الكثير من الدول الغربية والعربية– الشكوك على جميع الأصعدة والمستويات من حيث الأهداف المضمرة، أو من حيث النتائج العملية التي انتهت إليها، خاصة في واقع المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، وحالياً، يثير التحالف الدولي ضد ” داعش” الكثير من الأسئلة بأكثر مما يقدم من إجابات، وبالرغم من أن المقدمات التي يبني عليها التحالف صحيحة، المتمثّلة بخطر “داعش” على الإقليم والعالم، وعدائه للدولة الوطنية ومنظومة القيم الكونية التي ينشدها العالم الخاصة بالمساواة والمواطنة، فإن صحة المقدمات لا ترتب بالضرورة صحة التوجهات، وصدق الأساليب والوسائل التي ثبت فشلها، وسواء تعلق الأمر بالتحالف الدولي السابق ضد الإرهاب، أو التحالف الدولي ضد “داعش” فإن مفهوماً موحداً للإرهاب لم يطرح بعد، والأمر يخضع لمواجهة انتقائية وفق الأهواء والمصالح المضمرة، فالإرهاب واحد لا يتجزأ، إن كان في العراق، أو سورية، أو نيجيريا، وغيرها من البلدان، وما لم يكن هناك تعريف موحد للإرهاب، فسيظل أمر المواجهة محكوماً بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.