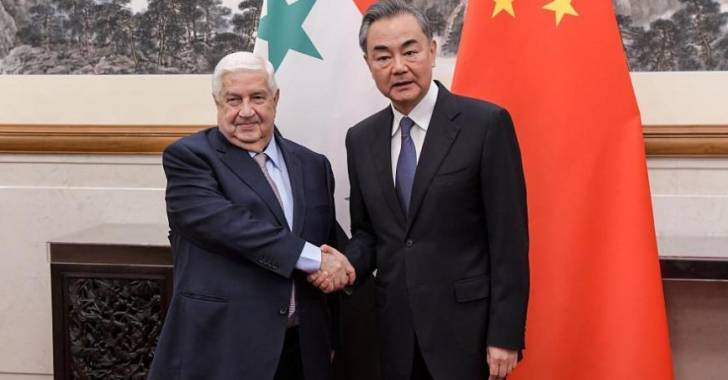كاتبة تستكشف العلوم الاجتماعيّة وتطبيقاتها
لطالما كانت القدرة على فهم الآخر والتفاعل والتجاوب مع تجاربه أهم وسائل التواصل وبناء العلاقة. وإذا لم يتم تفعيل مشاعرنا أو الاعتراف بها، عندها ينتفي شعورنا بأن حياتنا لها معنى حقيقي، فنحن ننجذب لا إرادياً إلى الأشخاص الذين يتفهمون مشاعرنا ونبتعد عمن لا يشعرون بنا، ولكي ننجح في قراءة مشاعر الآخرين يجب أن نستطيع قراءة مشاعرنا، عندها فقط نستطيع أن نجري قراءة معاكسة وأن نعرف مشاعر الآخرين من خلال تصرفاتهم.
ويبدو أن قساوة المشاعر البشرية هذه الأيام وسوء التواصل مع الآخر رغم توفر العديد من الوسائل والتسهيلات هو ما دفع بالكاتبة الأمريكية “كريس بيم” المختصة بالروايات الواقعية، لتقديم كتاب هو رواية من حيث المبدأ لكن المضمون ينحو منحى الأعمال العلمية النفسية على وجه الخصوص (وهذا يدل على تعمق الكاتبة بهذا المجال وغنى معلوماتها).
اعتماداً على وجهة نظرنا، قد يبدو كتاب “أشعر بك” مثيراً أو ساذجاً، بل وربما متعمداً. فبعد كل شيء، عصرنا عصرٌ يهتم فيه ترَمب ببناء الجدران أكثر من إطعام وتعليم الأطفال الفقراء، ولا يبدو هذا العالم مثالياً لنمو وانتشار شجرة البونساي (الشجرة الموجودة عل الغلاف) رمز المحبة.
يدرس الكتاب التعاطف بكلّ أشكاله، الفيزيولوجية والتاريخية والاجتماعية وحتى الشخصية. وتناضل بيم لتتجاوز أحداثها الأقل من التعاطف وتستكشف نفورها من الافتتاحية نفسها للتغيير. تشرح في حفل التوقيع على الكتاب “كان التعاطف الذاتي رمزاً للأنانية، هذا كتاب جذري لأنه يتحدى الحكمة التقليدية بأن الدفاع عن النفس والنظم العقابية هي السبيل الوحيد للحفاظ على أماننا الجسدي والنفسي” وربما أكثر أهمية، لأنه يؤكد أنه من الممكن العمل من أجل تحسين المجتمع دون التأثيرات الجانبية.
يمكن النظر إلى الفكرة على أنها رحلة سياحية تعرفنا فيها الكاتبة بالأماكن التي أدى فيها الفهم الجديد للتعاطف إلى تطبيقات جديدة وناجحة. وفي وقت مبكر توفر تمييزاً حيوياً بين المحاولات الحقيقية للتغيير الاجتماعي وما تصفه بـ “التصميم التعاطفي” كمحاولات الشركات بجعلنا نشعر بأننا محبوبون أو محتاجون أو متصلون مع هدفنا “اشتري أكثر”. فالشركات المستنيرة تدرك بشكل متزايد أن تقديم التعاطف مع عملائها وموظفيها والجمهور هو أداة قوية لتحسين المنتجات، والرموز التعبيرية على فيسبوك مثال على ذلك. تتعامل بيم في بداية الكتاب مع الإجبار الأمريكي الافتراضي على تحقيق دخل قوي، ومثالها، عنوان مقالة لمجلة “فوربس” الأمريكية المشهورة، التي تقترح أن أفضل سبب لتدريس التعاطف هو “تحسين التعليم ونتائج الاختبارات”.
وتمضي الكاتبة في بحثها لتتساءل ما إذا كان التعاطف فطرياً أو مهارة يجب تعلمها، ثم في أيٍّ من الحالتين، للتحقيق في كيفية تطبيقها على بعض أكثر مشكلاتنا استعصاءً. تأخذ الرحلة الإلزامية عبر تاريخ كيف تمت دراسة التعاطف في الماضي ورحلات إلى مختبر علم الأعصاب لمعرفة ما هي الاكتشافات التي يتم إجراؤها حول كيف يشعر البشر.
في الواقع، البيان اللطيف في هذا الكتاب يحثّ القرّاء على تغيير نظرتهم إلى أنفسهم والآخرين. وإذا كنت تميل إلى فكرة حضور مؤتمر حول الاتصال اللاعنفي، فإليك الفرصة التي تدور بها لاستكشاف السبب ومحاولة عدم الاكتراث، لوضع نفسك في مكان العدو. قد لا تكون فكرة جيدة أن تبدأ مع الأشرار مثل دونالد ترامب أو نانسي بيلوسي. في المرة القادمة التي تتشاحن فيها مع شريكك أو زميلك في العمل أو مراهق ما، توقف عن مشارعته لمدة دقيقة وحاول أن تعيد إلى مستمعه ما قاله لك بالضبط دون تحرير أو مبالغة. إنها تجربة تواضع.
تستشهد الكاتبة عند الانتقال من تعاطف الفرد إلى التعاطف المجتمعي، بما فعله يوجين دي كوك، رئيس فرق الموت الجنوب إفريقي سيء السمعة الذي أسر وعذب وقتل الكثيرين في المقاومة المضادة للفصل العنصري. أرادت أن تفهم كيف يمكن أن يصبح الرجل العادي تجسيداً للشر، لكنها ذهبت أبعد من ذلك لفحص كيف بنى حياة من الندم خلال فترة سجنه وبعدها. ومما يثلج الصدر أن نراه يستعيد إنسانيته بالاعتذار لأسر ضحاياه واحدا تلو الآخر. ربما لا تكون فكرة ستعمل مع المرضى الاجتماعيين، ولكن لا يضرّ أن يتم تذكيرهم بأنه عادة ما يكون هناك نوع من التفكير الجماعي وراء أعمال الإرهاب الجماعي. إذا كان لابد من إعادة بناء المجتمع، كما هو الحال في رواندا أو يوغوسلافيا السابقة، يصبح السؤال كيف نتحرك سويةّ؟ “عندما يعترفون بالخطأ ويظهرون الندم، ماذا يجب أن يكون ردنا؟ هل نرفض اعتذارهم ونواصل معاقبتهم بالكراهية؟ أم ينبغي لنا أن نوسع رحمتنا وأن ندعوهم إلى السير معنا على طريق الإنسانية الأخلاقية؟”.
والجزء الأخير من العمل الأكثر صرامة. فجنباً إلى جنب مع سبرها للفظائع التي ارتكبت بحق الأمريكيين الأصليين ومحاولاتهم اللاحقة لصنع السلام مع الظالمين البيض، خصصت الكاتبة جهداً كبيراً للتحقيق في كيفية عمل التعاطف بين البيض والأمريكيين من أصل إفريقي. ورغم افتقاره للحلول العملية، هو كتاب مهم، وإذا لم يستميلنا إلى التعاطف ربما يجعلنا أقرب إلى الكياسة، وهذا بداية جيدة.
نشرت الكاتبة أوّل أعمالها “الشفّاف” عام 2007، ولم تكن مشهورة حينها، ولولا أن توفرت الظروف السياسية في أمريكا وأوروبا الغربية لما لاقى عملها الأخير كلّ هذا الروّاج، وكأنه صرخة شعب لتغيير نهج ووجه العدالة الغربية، تلك العدالة التي طالما تغنت بالحريّات والديمقراطيّة.
سامر الخيّر