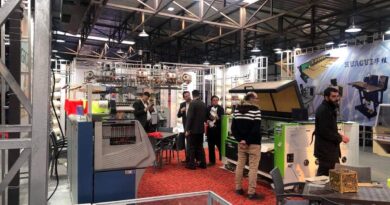في ذكرى التأسيس: نظرة إجمالية على مسيرة البعث النضالية
عبد الرحمن غنيم
كاتب وباحث من فلسطين
من واكب المسيرة النضالية لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ مرحلة البدايات لا بدّ وأن يسلّم بالحقيقة القائلة بأنّ التحديات الأخطر التي واجهها الحزب كانت تلك التي انبثقت من داخله، لا لأنّ التحديات الخارجية كانت قليلة أو سهلة، ولكن لأن هذه التحديات الخارجية كانت من طبيعة الأشياء أولاً، ولأن الحزب وُجد من أجل مواجهتها ثانياً. أما التحديات الداخلية فقد لعبت دور المعرقل لمسيرة الحزب، خاصة حين وصلت إلى إيجاد حالة انقسام بين دمشق وبغداد كان لها تأثيرها السلبي الكبير على الصعيد العربي القومي.
أن يكون الحزب قومياً غايته تحقيق الوحدة العربية الشاملة، يفرض عليه بطبيعة الحال –وهو ما عمل من أجله– أن يوجد الطلائع الثورية المناضلة العاملة من أجل الوحدة في جميع الأقطار العربية، وأن يجهد عملياً لتحقيق نواة للوحدة تكون بمثابة النموذج والمثال الحيّ الذي يستقطب بقية الأقطار. وهنا لا بدّ وأن نسلّم بأن هناك ثلاثة أقطار عربية يفترض التركيز عليها في البداية، وهي مصر وسورية والعراق. ومعروف تاريخياً أن دولة الخلافة العربية الإسلامية وحتى زمن السلطنة العثمانية اتخذت من دمشق وبغداد والقاهرة عواصم لها.
الإنجاز الوحدوي
من هنا نستطيع أن نفهم حجم الإنجاز الوحدوي الذي نجح الرفاق البعثيون في تحقيقه حين دفعوا باتجاه الوحدة بين مصر وسورية وقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، كما نستطيع أن نفهم حجم الأمل الذي واكب ثورة 14 تموز في العراق بأن تكون هذه الثورة مدخلاً لخطوة وحدوية إضافية تجمع الجمهورية العربية المتحدة والعراق معاً وتكون النواة الصلبة لوحدة عربية شاملة. لكن هذا الأمل سرعان ما تعرّض للطعن مرّتين: مرّة على يد عبد الكريم قاسم بحرفه للثورة في العراق عن المسار القومي، ومرة ثانية بالانقلاب الانفصالي في دمشق في 28 أيلول 1961. وهكذا وجد البعث نفسه، مثلما وجدت الثورة في مصر نفسها، أمام التحديات، وكان لا بد من العمل على مواجهة هذه التحديات واستعادة مسيرة النضال الوحدوي.
في تلك الظروف الصعبة، وخلال العام 1962، بدا أنّ التيار القومي يحاول استدراك الوضع الطارئ والتحديات المعترضة من خلال توجيه البوصلة نحو فلسطين. ففي القاهرة كان عبد الناصر مهتماً عدا عن العناية بطرح رؤية ثورية فلسفية بدءاً من طرح شعار المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني إلى تبني أهداف الحرية والاشتراكية والوحدة وتأسيس الاتحاد الاشتراكي العربي، برعاية قيام منظمات فلسطينية جهادية ونقابية تمهد لإنشاء الكيان الفلسطيني الذي تجسّد عام 1964 في منظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذا السياق أيضاً نظمت القيادة القومية للحزب اجتماعاً موسعاً لممثلي المنظمات الفلسطينية في الحزب عُقد في طرابلس بلبنان عام 1962 وتقرر فيه تشكيل حركة للمقاومة باسم “حركة تحرير فلسطين”. ومن المؤكد أن عبد الناصر لم يكن ليعارض هذا الاتجاه بدليل أن رفيقنا محمد عبد العزيز أبو سخيلة كان قد أسّس جبهة ثوار فلسطين في قطاع غزة، كما أنني وفي ضوء تكليفي من قبل قيادة الحزب بالشروع في التحضير لتأسيس الحركة كتبت في ذلك الحين دراسة حول الحركة وموجبات تأسيسها، وقد نشرت في جريدة “أخبار فلسطين” في غزة، ولكن شيئاً ما طرأ في أواخر العام 1962 جعل القيادة القومية توجّه بتجميد العمل في التحضير لقيام “حركة تحرير فلسطين” بانتظار بروز معطيات جديدة في الوضع، حيث إن الحزب على وشك استلام السلطة في بغداد ودمشق.
والواقع أننا لم ننتظر طويلاً بعد هذا التوجيه، حتى كان الإنجاز الأول يتحقق بثورة 8 شباط 1963 في العراق، ثم جاء الإنجاز الثاني بعد شهر بثورة 8 آذار 1963 في سورية. وصار الأمل بقيام الوحدة الثلاثية بين مصر وسورية والعراق قائماً، وبدأت محادثات الوحدة الثلاثية بالفعل. ومن المؤكد أنه لو نجحت هذه المحادثات لكانت الوحدة قد تحوّلت إلى رباعية بانضمام اليمن ولكانت مسيرة الوحدة العربية قد شقّت طريقها على الصعيد القومي.
من أين جاءت العقبات التي أعاقت مسيرة الوحدة وأوجدت مشكلة ولو مؤقتة حول العلاقة بين البعث وعبد الناصر، أو بين البعثيين والناصريين، مع ملاحظة أن مسألة ظهور تنظيمات ناصرية باتت تظهر بعد ذلك الزمن لا قبل؟.
لا داعي لأن نشغل أنفسنا بالإجابة عن هذا السؤال، إذ أن هناك وجهاً آخر للمشكلة برز منذ ذلك الحين، ويتمثل بالعلاقة بين البعثيين أنفسهم. وهذا الوجه الآخر للمشكلة عبّر عن نفسه وبشكل دموي حين عقد المؤتمر القطري للحزب في العراق في تشرين الثاني 1963.
مؤامرة المخابرات المركزية الأمريكية
إن استحضار ما حدث في المؤتمر القطري للحزب في العراق آنذاك، وما تسبّب به من تمكين عبد السلام عارف من الانقلاب على سلطة الحزب، مثلما أدّى لاحقاً إلى قيام الحركة التصحيحية في دمشق يوم 23 شباط 1966، سيضعنا أمام الحقيقة القائلة بأن الخلاف مع القادة الحزبيين اليمينيين الذين أحبطوا مشروع الوحدة الثلاثية لم يكن خلافاً بين هؤلاء وبين عبد الناصر فقط بل كان خلافاً بينهم وبين قواعد الحزب أيضاً. ومن هنا نستطيع أن نفهم السرّ الكامن وراء قرار عبد الناصر الذي أعلنه يوم 1 أيار 1966 في خطابه أمام مجلس الأمة باستئناف العلاقة مع سورية، أي مع البعث. فاستبعاد تلك القيادات كان يعني استبعاد مصدر الخلافات، ولقد قدّر لي آنذاك أن أطلع على حيثيات هذا التطور الأساسي المهم في استعادة العلاقة. وأكتفي هنا بالإشارة إلى أن سرّ هذا التطور يكمن في تحقيق صحفي نشرته صحيفة المحرر الناطقة بلسان حركة القوميين العرب في بيروت. وكان هذا التحقيق يتحدث عن مؤامرة تديرها المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع نظام عبد السلام عارف في العراق للإطاحة بالنظام السياسي الجديد في سورية والذي تشكل بعد حركة 23 شباط التصحيحية. وكان هذا التحقيق الصحفي حاسماً في تحديد خيار عبد الناصر لسبب بسيط، وهو أن اللاجئين السياسيين السوريين في القاهرة كانوا قد زعموا أن النظام الجديد في سورية وراءه المخابرات البريطانية. وقد أوضح عبد الناصر في خطابه أنه اطلع في وقت واحد على تقريرين قدمهما له مكتبه الخاص، أحدهما يقول إن المخابرات الأمريكية تتآمر على النظام الجديد في سورية، والثاني يقول بأن هذا النظام تابع للمخابرات البريطانية، فاستدعى مدير مكتبه ليسأله: أيعقل أن تتآمر المخابرات الأمريكية على نظام تابع للمخابرات البريطانية؟ لا بد من وجود خطأ في أحد التقريرين. لم يشر عبد الناصر وقد اتخذ قراره باستئناف العلاقة مع سورية والبعث في ضوء هذه المفارقة إلى نظام عارف، ولكن من الواضح أن التحقيق الصحفي الذي نشرته حركة القوميين العرب أقنعه بأن نظام عبد السلام عارف لم يكن أهلاً للثقة، وأن الانقلاب الذي كان قد وقع في بغداد ضد حكم الحزب هو ضد النهج القومي التحرري. وهكذا حسمت مسألة العلاقة بين البعث وعبد الناصر بإبعاد القيادات اليمينية المناورة والمتسلطة وتحرير الحزب من نفوذها. لكن هذا التطور لم ينه مشكلة الحزب في العراق، وقد قدّر لهذه المشكلة بعد ذلك أن تتفاقم.
نهجان للممارسة السياسية
إن العقلية التي أباحت لنفسها اقتحام المؤتمر القطري للحزب في العراق بالسلاح، وأن تقتل العديد من الرفاق داخل المؤتمر، هي التي تمكنت في أواخر الستينيات من الإمساك بالسلطة في العراق. ومنذ ذلك الحين صار علينا أن نعاني مشكلة الانقسام في الحزب القومي بوجود مركزين وقيادتين، ووجود حالة من التنافس بينهما، وستكون عقلية صدام حسين أو دوافعه هي المحور الأساسي الذي تتبلور حوله المشكلة.
حين نلقي نظرة إجمالية على المشهد في تطوّره منذ 8 شباط 1963 وحتى الآن، نستطيع أن نميّز حقيقةً بين نهجين أو سكّتين للممارسة السياسية، ونستطيع أن نطلق عليهما وصف: سكة السلامة وسكة الندامة، واضعين في اعتبارنا المحصلة التي أدّت إليها الطريق التي اختارها صدام حسين وتمسّك بها طوال الوقت وحكمت سلوكياته، والتي أوصلته في نهاية المطاف إلى وضع لم تنفع معه حتى الندامة.
كان أستاذنا عالم السياسة العربي د. حامد ربيع حين يقارن بين الأوضاع في سورية والعراق يقول إن صدام يمسك بالوضع الداخلي في العراق بيد قوية ولكن سياسته على المستوى الاستراتيجي خاطئة، بينما كانت سورية في رأيه تعاني اجتماعياً بعض مظاهر الفساد لكن الرؤية الإستراتيجية للرئيس حافظ الأسد كانت صائبة، وهذا ما جعله يؤثر البعث في سورية على البعث في العراق.
دعونا نقول إنه بالنسبة لنا كبعثيين كان الانقسام بين دمشق وبغداد، ووجود بعثين متنافسين، يمثل مشكلة كبرى على المستوى القومي يعرف أبعادها بشكل جليّ الرفاق الذين عملوا في مكتب التنظيم والاتصال في القيادة القومية بدمشق. فعدا عن الإشكالية ذات الطابع الاستراتيجي الناجمة عن الصراع العربي– الصهيوني، وما توجبه من أن يكون العراق وأياً كان النظام السياسي فيه عمقاً استراتيجياً وظهيراً فعلياً لسورية في مواجهة التحدي الصهيوني، وخاصة بعد قيام السادات بإخراج مصر من هذا الصراع وعقد اتفاقيات كامب دافيد مع العدو، فإن المشكلة التنظيمية التي عانى منها الحزب تمثلت في وضع الإنسان العربي أمام مشكلة المقارنة بين البعث “السوري” والبعث “العراقي”، وهي في حدّ ذاتها إشكالية لا يكفي بصددها التمييز بين يسار ويمين. وكان السؤال الأخطر الذي يواجه نشاطنا التنظيمي على الصعيد القومي هو السؤال القائل: إذا كان البعث يحكم سورية والعراق ولم يوحّدهما في دولة واحدة، فما الذي يضمن أن يوحّد الأقطار الأخرى إذا ما تولى الحكم فيها؟. وتزداد خطورة مثل هذه الأسئلة وفعاليتها السلبية بتتبع الدور الذي لعبه صدام على المستوى القومي بمعاكسة مسار الحزب النضالي حين يفكر كل واحد منا بأمرين: أولهما الأساليب التي اتبعها صدام في مواجهة سورية، والإمكانات المالية التي خصّصها صدام لهذا الغرض، حيث قاربت الموازنة التي خصّصها صدام للعمل على الصعيد القومي في فترة من الفترات ثلاثة مليارات دولار سنوياً. وكان دخل العراق آنذاك يسمح بمثل هذا الإنفاق السخيّ المنشّط من ناحية والمثبط من ناحية ثانية والمثير للبلبلة من ناحية ثالثة.
على كل حال، ورغم ما تحمله هذه المعطيات من دلالات، تظل هناك حقيقة أساسية تفرض نفسها، وهي أن صدّام قد اختار طوال الوقت سلوك سكة الندامة، ظاناً أنه يوصله إلى غايته في الزعامة، وأن هذا الاختيار هو الذي حدّد مصيره بالمحصلة. فلا الأموال الكثيرة نفعت، ولا التحالفات غير المنطقية شفعت.
من المؤسف القول بأن مشكلة صدام في سلوكه لسكة الندامة كانت مشكلة نفسية متأصلة ومستعصية، ولم تكن نتاج أخطاء عابرة في تقييم المعطيات من حين إلى حين. وما يدفعنا لإصدار هذا الحكم الذي يبدو للوهلة الأولى قاسياً مبنيّ على مراقبة انطباعاته يوم 8 شباط 1963، أي في الساعات الأولى لانتصار ثورة الحزب في العراق. ففي مساء ذلك اليوم كان آخر لقاء لي مع صدام حسين قبل أن يغادر القاهرة إلى بغداد، وكان هذا اللقاء بحضور رفيق ثالث في جروبي عدلي بالقاهرة، حيث رحنا نتبادل الحديث حول ما كان يجري في بغداد آنذاك.
إن الشيء الذي لفت انتباهي في تلك الجلسة أن صدام وكنت أتوقع أن يكون في غاية السعادة في ذلك اليوم، كان في البداية وعلى غير عادته تسيطر عليه حالة من الكآبة والشرود، وكانت انفعالاته سلبية تماماً ونحن نورد أسماء الرفاق عبد الكريم مصطفى نصرت وعلي صالح السعدي وحازم جواد وطالب شبيب، وبدا صدّام وكأنه لا يعرف أياً من هؤلاء، أو لا يتعاطف مع أيّ واحد منهم، لكن هذا الوضع سرعان ما تبدّل، وحلّت الابتسامة محل الاكتئاب، حين جرى ذكر مساهمين آخرين من الرفاق هم صالح مهدي عماش وحردان التكريتي وطاهر يحيى وأحمد حسن البكر. وكان تعقيبه وقد انفرجت أساريره أن هؤلاء الرفاق هم من تكريت، وأذكر أنه وصف أحمد حسن البكر بأنه نصير في الحزب، وبدا لي أنه قال هذه العبارة الأخيرة دون أن يكون متيقناً من صحتها.
لقد كان واضحاً من ملاحظة انفعالات صدام في تلك الجلسة أنه ميّز بين التكريتيين وغير التكريتيين، مستبشراً بالتكريتيين، وقلقاً من دور الآخرين، وهو منطق يتنافى مع روحية الانتماء النضالي في حزب البعث العربي الاشتراكي، ويمثل مؤشراً على انحراف ما محتمل في السلوك ناتج عن مثل هذا التمييز مهما كانت صفة هذا التمييز جهوياً أو إيديولوجياً. ولا تعني ملاحظتنا لهذا التمييز في الانفعال أن صدّام وإن عمل بعد ذلك بالفعل على استغلال التكريتيين في مواجهة الآخرين لم يصطدم لاحقاً بالتكريتيين كما هو معروف. ولقد ثبت أن صدام كان يفكر على هذا النحو حين أسهم في الهجوم المسلح على المؤتمر القطري للحزب في العراق في تشرين الثاني عام 1963، وحين أسهم بعض –ولا نقول كل– من راهن عليهم صدام من التكريتيين في انقلاب عبد السلام عارف على سلطة الحزب. أما صدام نفسه فإنه رغم هذه المغامرة وما قادت إليه فقد بقي خارج السلطة حتى العام 1968، متفرغاً في غضون ذلك للنشاط التنظيمي الحزبي.
وأد الوحدة بين سورية والعراق
في الواقع أنه بعد أن تمكن الحزب في العراق من معاودة الإمساك بالسلطة، وصعد صدام إلى موقع النائب “أي نائب الرئيس”، بذلت جهود ليست بالقليلة وتضحيات ليست بالقليلة من قبل الرفاق في العراق من أجل استعادة الوحدة بين دمشق وبغداد. ومن بين تلك المحاولات تلك المحاولة المبكرة التي كشف عنها النقاب الرفيق حسن الذهب عضو القيادة القومية في دمشق والتي كان وراءها سعدون غيدان قبل أن يتعرض للتصفية، وهناك محاولة بذلها الرفيق عبد الخالق السامرائي ورفاق آخرون عام 1972 لاستعادة وحدة الحزب وتوحيد سورية والعراق، وقد كنت أحد شهود هذه المحاولة، وحملتُ رسالة من الرفاق في بغداد إلى القيادة القومية بصددها، وتابعت تطوراتها في حينه، وكان الجزاء الذي تلقاه الرفيق عبد الخالق السامرائي بعد سجنه لسنوات هو الإعدام.
ولقد أنعشت مساهمة العراق بوحدة عسكرية عراقية في حرب تشرين على جبهة الجولان الأمل في أن تكون بداية مرحلة من العمل المشترك، ولكن المفاجأة كانت في مبادرة بغداد إلى سحب قوتها دون مبرر منطقي، وقد حضر اثنان من رؤساء البلديات في الضفة الغربية هما كريم خلف وعبد الجواد صالح ساعيين للدعوة لعودة القوات العراقية إلى الجبهة، وذهبا إلى بغداد معبرين عن هذه الرغبة، ولكن إجابة صدام كانت عجيبة وهي أن مثل هذا الأمر ليس وارداً لأن بغداد تنوي تفكيك الجيش العراقي وإعادة بنائه من جديد، وأن هذه العملية تحتاج إلى سنوات طويلة. وكانت المشكلة الأخرى الخطيرة والتي تكشفت أبعادها مؤخراً في ضوء معلومات أدلى بها مسؤولون لبنانيون مطلعون حول ظروف تفجير الحرب الأهلية في لبنان في نيسان 1975 تقول إن صدام حسين شخصياً كان وراء التدابير التي أدّت إلى تأسيس “القوات اللبنانية” وإلى تفجير الحرب الأهلية في لبنان واستهداف المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية، وأن “القوات” الانعزالية حصلت سراً على تمويل وأسلحة من بغداد، مع العلم بأن بغداد مع بدء الأحداث في بيروت أرسلت 3000 مقاتل إلى بيروت الغربية ليبدو وكأنها تساهم في التدابير الدفاعية بمواجهة الطرف الآخر!!. ومعروف أنها شجعت في ذلك الحين شق المقاومة الفلسطينية بين رفض وقبول، متظاهرة بمساندة جبهة الرفض ضد الطرف أو الأطراف المتهمة بالقبول في الساحة الفلسطينية!. ولم يخطر ببال أحد في ذلك الحين وجود علاقة بين الانعزاليين الذين أشعلوا الفتنة في لبنان وبين السلطة في بغداد.
على كل حال، وبغض النظر عن ملابسات الحرب الأهلية اللبنانية ومشاغلة المقاومة الفلسطينية، فإن التطور الخطير الذي شهدته تلك الفترة والمتمثل بتوقيع السادات لاتفاقيات كامب دافيد مع الصهاينة، وضع المنطقة أمام الحاجة الملحة في أن تقوم بغداد بتشكيل عمق استراتيجي لسورية والمقاومة الفلسطينية بمواجهة العدو الصهيوني. وقد توجه الرئيس حافظ الأسد إلى بغداد لإبرام ميثاق العمل القومي بين دمشق وبغداد، وهو ميثاق يعني وحدة الحزب ووحدة القطرين. ولكن صدّام ما لبث أن طعن هذا الميثاق وأحبطه، وأعدم بهذه المناسبة مزيداً من الرفاق العراقيين القياديين. وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فدفع الأوضاع بين سورية والعراق إلى التوتر حتى وصلت عام 1979 إلى ظروف يخشى معها أن تتحول إلى حرب فعلية، وتبّنى واحتضن جماعات تدّعي أنها معارضة سورية، ومنها جماعة “الإخوان المسلمين” للشروع في تنفيذ عمليات إرهابية في سورية، وهو ما راحت تنفذه بالفعل. وفي تلك الفترة تولى صدام رئاسة العراق وبات بوسعه اتخاذ القرارات السياسية والإستراتيجية منفرداً.
الحرب العراقية- الإيرانية
ضمن تلك الظروف جاء انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني وسقوط شاه إيران ليشكل مفاجأة كبرى للامبريالية الأمريكية والصهيونية. وكان موقف النظام العراقي من هذا التطور مهماً في ذلك الحين، لأن المحافظة على العلاقة مع إيران والتعاون مع الثورة فيها كان يعني، مع وجود نظام تقدمي في أفغانستان آنذاك، أن محوراً استراتيجياً آسيوياً بالغ الأهمية قد تشكل ممتداً من حدود الصين والاتحاد السوفييتي وحتى البحر الأبيض المتوسط عبر إيران والعراق وسورية. لكن القوى المعادية لمثل هذا التطور وعلى رأسها الولايات المتحدة مثلما قوّضت ميثاق العمل القومي بين دمشق وبغداد وأحبطت إمكانية قيام الوحدة بين القطرين وتوحيد البعث فيهما، سعت إلى دفع الأنظمة العربية الرجعية للشروع في إرسال المتطوعين إلى أفغانستان لمحاربة القوات السوفييتية، ودفعت نظام صدام حسين إلى التورط في حرب مع إيران استمرت ثماني سنوات. وفي موازاة هذين التطورين جرى تصعيد العدوان الصهيوني على لبنان وصولاً إلى احتلال العاصمة اللبنانية بيروت، وإخراج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت.
حين توقفت الحرب العراقية– الإيرانية في تموز 1988، وإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها الطرفان، كانت خسائر البنية التحتية لكل من إيران والعراق على التوالي 445 مليار دولار و126 مليار دولار. أما الكلفة الاقتصادية الكلية للحرب “التكاليف المباشرة وغير المباشرة” فكانت 644 مليار دولار بالنسبة لإيران و512 ملياراً بالنسبة للعراق، أي ما مجموعه تريليون و156 مليار دولار، وهذه التكاليف تتجاوز مجموع العائدات النفطية التي حصلت عليها العراق وإيران خلال القرن الماضي والتي بلغت 737،5 مليار دولار. ومثل هذه الأرقام ترجح أن العراق خرج منهكاً من تلك الحرب، وأن تلك الحرب التي استهدف من حرّضوه عليها القضاء على الثورة الإسلامية في مهدها تحت ذريعة حماية البوابة الشرقية للوطن العربي، كانت على حساب تطوير البنى التحتية في العراق. ومع ذلك راحت الأوساط الامبريالية والرجعية تتحدث عن فائض القوة العراقية حتى أنها زعمت بأن العراق يملك رابع جيش في العالم، كما أنها راحت تنسج الأخبار والأساطير عن أسلحة غير عادية يعكف العراق على إنتاجها.
احتلال العراق للكويت
وفي تلك الظروف، وفي وقت شهد مفاجأة تفكيك الاتحاد السوفييتي، جاءت مفاجأة احتلال العراق للكويت، وقد تبيّن أنّ الولايات المتحدة قد حرّضته على هذا الفعل وزيّنته له كثمن لخوضه الحرب ضد إيران. وكانت هذه الخطوة بمثابة المصيدة التي استثمرها الأمريكي لتبرير قيامه بتوجيه ضربة عسكرية للعراق أولاً، ولتبرير التواجد العسكري الأميركي الدائم في منطقة الخليج ثانياً، ولمحاصرة العراق ووضعه تحت طائلة “النفط مقابل الغذاء” ثالثاً، ولإضعاف ما بقي لديه من القدرة العسكرية تمهيداً للإجهاز عليه رابعاً. وهذه بالفعل هي الخطوات التي اعتمدها الأمريكي إلى أن احتل العراق عام 2003. وبوسعنا أن نلاحظ بأن الأمريكي ما إن تخلص من نظام صدام في العراق حتى توجّه نحو لبنان لبدء الحملة على سورية. وهذا ما يفسّر اغتيال رفيق الحريري عام 2004، واتهام سورية باغتياله، مثلما يفسّر المحاولة الصهيونية للقضاء على حزب الله في لبنان عام 2006. وهكذا تصاعدت المحاولة الأمريكية لتنفيذ المخطط الشيطاني الصهيوني وبلغت أوجها عام 2011.
لقد استهدف الأعداء عملياً كامل الوطن العربي بهجمتهم، ولكن استهداف القطر العربي السوري كان المحور الأساسي للاستهداف، أو لنقل كان بمثابة القلعة الأخيرة التي إذا ما تمكنوا منها تمكنوا من كامل المنطقة. ومن هنا نستطيع أن نقدّر حجم الأهمية المترتبة على صمود القطر، وحجم التطورات المترتبة على هذا الصمود. ففشل المخطط الشيطاني الصهيوني الذي حاول الطاغوت الأميركي وأتباعه تنفيذه، والذي كانت غايته تمكين إسرائيل من التوسع بين الفرات والنيل، يعني خلق واقع جديد في المنطقة. ولعلّ أبرز ملامح هذا الواقع الجديد يتمثل في العلاقة بين سورية والعراق وإيران والمقاومة في فلسطين ولبنان، إضافة إلى الدور الذي باتت تلعبه روسيا والصين على الصعيد العالمي.
لقد صمد القطر العربي السوري بقيادة البعث في مواجهة أعتى المؤامرات، وهذا الصمود كرّس أيضاً العلاقة بين الفكر القومي الثوري وبين الفكر الإسلامي الثوري الحقيقي، ومن شأنه أن يؤدّي إلى إيجاد مناخ جديد للنشاط الثوري على الصعيدين العربي والإسلامي، وأن يسهم في كشف القوى العميلة المرتبطة بالامبريالية والصهيونية والرجعية مهما كانت ادعاءاتها بعد أن وضعت هذه القوى نفسها في خدمة المؤامرة الشيطانية.