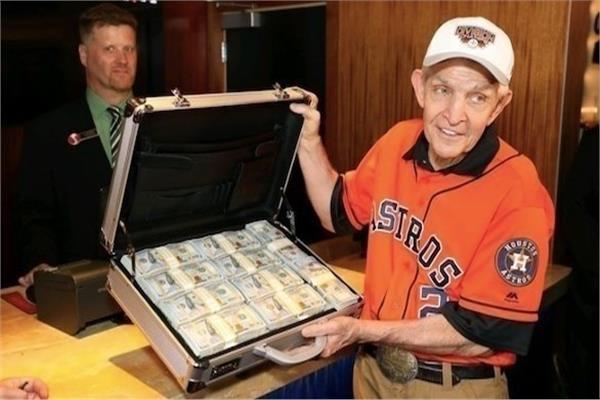“كافكا” في بيت ميلان كونديرا هذا الشتاء
“فن الرواية هو العالم الذي تتعطّل فيه الأحكام الأخلاقية”، هذا التعريف أو التوصيف توخياً للدقة، هو للروائي المعاصر الأكثر جدلاً ربما بين معشر القراء والنقاد اليوم “ميلان كونديرا” (1929)، الروائي الذي يرى كبار النُقاد أن أهم ما يميّز مشروعه الروائي، هو قدرته التفكيكية في بنى شخصياته الروائية، والنبش في عوالم الشخصية المدفونة تحت أكوام من الأعباء المتوارثة كالهوية، الانتماء، الدين، الخوف، العواقب، بغية الذهاب بعيداً في جوانياتها وتشكيلاتها المعقّدة، بعد دفعها وبقوة، ليس إلى حرف الهاوية بل للسقوط عنها، تاركاً إياها تسقط سقوطاً حُراً في ما يخيفها ويلجم اندفاعاتها صوب ما تصبو إليه، وذلك لاكتشاف دواخلها الباطنة بجرأة لامتناهية، دون الخشية من العواقب والنتائج، والتي هي بمعظمها وحسب الرؤية “العدمية” لصاحب “البطء”، ليست إلا قيوداً تشلّ قدرة الإنسان على اختراق ما يقلقه ويخيفه، ما يتوجّس منه ويتركه فريسة التردّد وبالتالي الخسارة، فأياً كانت صفة ما يمكن له أن يحدث بعد هذه الاندفاعة الجسورة، لا يمكن لها أن تكون بأي حال من الأحوال، أسوأ مما هو واقع.
وبالتالي يمكن القول: إن النتاج الروائي لهذا الروائي التشيكي الحائز مؤخراً، وبعد 40 عاماً على نفيه من بلاده عقب ما سُمّي حينها بـ: “ربيع براغ” وذهابه إلى فرنسا التي حمل جنسيتها، على جائزة مواطنه “كافكا” (1883-1924) ذهب نحو إعادة النظر والتشكيك في كل المسلّمات الكبرى وفي كل البديهيات التي مارست سلطتها على الإنسان بامتياز، دينية، اجتماعية، سياسية، ثقافية، وغيرها، جاعلاً من الواقع المزري للإنسان منطلقه في عمليه الهدم تلك، ليس بهدف إعادة التشكيل أو الصياغة وفق النظرة “العدمية” التي تُوصّف فلسفته الحياتية وبالتالي أعماله الأدبية، بل للتحفيز على ارتياد المجهول، والخوض في كل ما يُصمت عنه عادة، أو مناقشته من وجهات نظر مواربة، غالباً ما يرفع أصحابها راية الرمزية، في مواجهة ما ليس رمزياً، وهذا السياق العام لأدب صاحب “خفة الكائن التي لا تحتمل”، يجيء منسجماً وما سبق ذكره عن رؤيته لهذا الفن ووظيفته الأسمى، فالرواية أولاً فعل خلق وتكوين، وهذا ما يجعل شخصياته الروائية أكثر اندفاعة وجسارة في الخوض وبحدة مع كل اليقينيات وما لها من أثر رجعي على النفس البشرية وعلى العالم برمته، المحكوم سلفاً بحتمية الزوال، تلك التي تفرضها اليقينيات والمسلّمات العامة، قبل أن تفرضها طبيعة الحياة نفسها، وما فيها من متناقضات كبرى، تروح وتجيء بين لججها النفس البشرية، حياة الإنسان فرداً كان أو منخرطاً في منظومة اجتماعية ما، لها مالها من ضوابط ومعايير أو “قيود”، يراها كونديرا وشركاؤه في هذه الرؤية التي صاغ مفرداتها في أوروبا الفيلسوف”شوبنهاور” (1788-1860) صاحب مقولة: “كل إنسان يعتقد أنه حرّ منذ الأزل حرية كاملة، وأنه يظن باستطاعته أن يبدأ بحياة جديدة، ولكن التجربة سرعان ما تعلمه أنه ليس حراً، وأنه خاضع للضرورة، وينفذ نفس الأخلاق التي كان ينتقدها هو نفسه”، العائق الأكثر تجذراً في النفس البشرية، الذي يُحبط أي محاولة للإفلات من هذه الصيرورة الحتمية للرتابة والعدم، إلا أن قلّة ممن يستطيعون تجاوزها للتجريب بغض النظر عن النتيجة، قاموا بذلك، في محاولة جسورة لشق الطريق ومن ثم تعبيده لمن يريد السير عليه.
التشيك التي أعادت الجنسية لكونديرا، بعد قرابة الـ 40 عاماً من نزعه إياها أثناء الحقبة السوفييتية إثر نشره مجموعته الشعرية “نزهة سوداويّة”، ثم منحته بعد ما يقارب العام على ذلك الجائزة الأرفع لديها، يبدو أنها أدركت أخيراً الدور المهم والكبير الذي لعبه هذا الشخص الذي خرج من رحمها في حركة الأدب العالمي الحديث، خصوصاً في الفترة التي ظهر فيها ودون أي مداراة، التشكيك بالمطلق وبالمسلمات والبديهيات واليقينيات، والعمل على نسفها، حسب رؤية ما عُرف بـ: “التيار العدمي”، الذي جاء أساساً للردّ على تيّار “الطوباويّة” في أوروبا العصور الوسطى، التيار الذي يجد أن على المثقف وضع قدراته وثقافته من أجل الوصول إلى عالم أفضل، مقابل النظرة العدمية للعبثية التي تكتنف كل أفعال الإنسان، كونها محكومة باللاجدوى، طالما أنها لا تفضي إلا إلى العدم في نهاية الأمر، لذا فهي تعلي من شأن أفعال الحياة العادية، وتوليها العناية الأكبر، فهي فقط من تجعله إنساناً بكامل إنسانيته، دون عقد نقص يكون أثرها تدميرياً على الإنسان نفسه وبالتالي على الوحدات الأكبر التي تحيط به. والقارئ لأعمال ميلان كونديرا، سيرى هذا التوجّه أو الانخراط الفعلي في تفعيله بداية بعناوين أعماله الروائية، ومنها: “غراميات مضحكة، المزحة، كتاب الضحك والنسيان، الخلود، الحياة هي في مكان آخر، الجهل، الهوية، فالس الوداع، البطء، حفلة التفاهة”.
ليست جائزة “كافكا” هي الجائزة الأرفع بالنسبة للأدباء عموماً، سواء سعوا إليها أو سعت إليهم، لكنها بالنسبة لكونديرا، هي ردّ اعتبار إنساني وأخلاقي أولاً، واعتراف بأن الاختلاف في التفكير والنظر إلى كينونة الإنسان من خلال إنسانيته نفسها، حالة طبيعية بل وضرورية في الحياة، تلك التي لا يزال الصراع على تحديد طبيعتها وجوهرها مندلعاً، ليس منذ كونديرا وشركاء مذهبه الروائي، بل منذ أول فعل وصلنا كحقيقة مطلقة، فالقتيل الأول هو صاحب القربان المقبول من القدرة الكليّة، والحق إذن -وهذا الحال- ينتحله العبث منذ البداية وحتى النهاية، فلسفة ميلان كونديرا الروائية باختصار شديد.
تمّام علي بركات