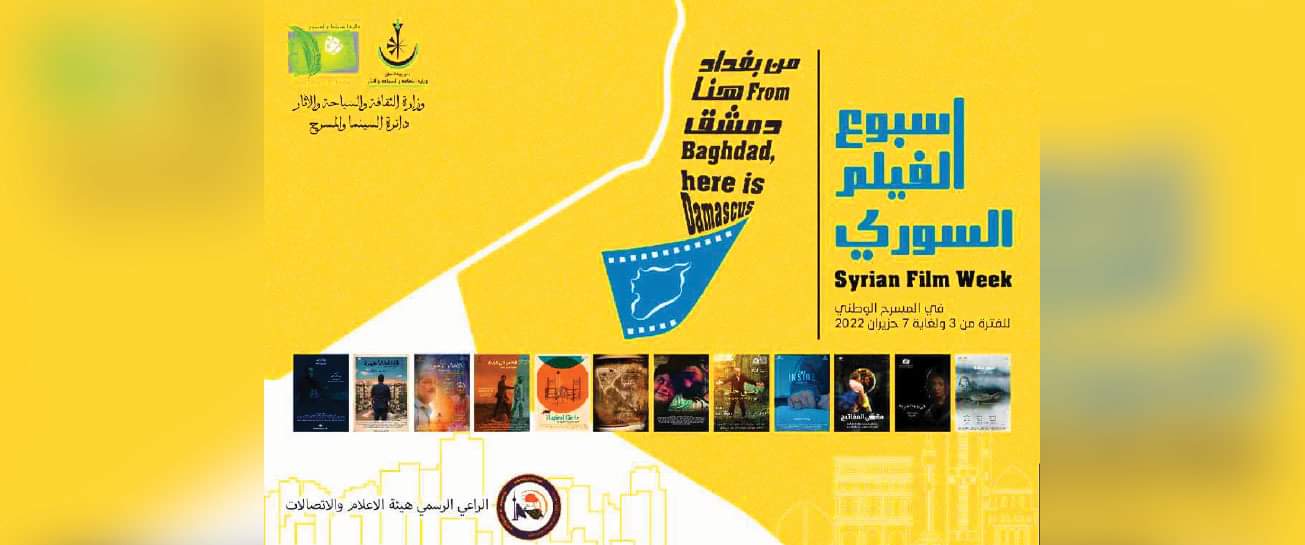أفلام افتتاحية مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الأول في سورية: ســـــويـــة فنيـــة معقولـــــة.. ورؤى ســـهلة فــــي متنــــاول اليــــد..
ستة أفلام انتخبها منظمو مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الأول، الذي انطلقت فعالياته، من صالات ودور عرض دار الأسد للثقافة والفنون في عاصمة الحب والحرب “دمشق”، أول أمس، لتكون هذه الأفلام المنتخبة بعناية “كما اعتقد”، لتعرض في يوم الافتتاح، هي الاستهلالية التي ستقدم للجمهور ملمحاً أو سمة مميزة عن المزاج العام لطبيعة ونوعية الأفلام المشاركة. فهذا المهرجان الأول من نوعه في سورية، باعتباره خاصاً بعرض الأفلام السورية الفائزة بالمنح الإنتاجية، التي قدمتها المؤسسة العامة للسينما لأكثر من ثلاثين مخرجاً، هو حصيلة عامين بقياس الزمن، من الجهد الشبابي الصافي (2013 – 2014)، خلال ظروف صعبة نسبياً، نظراً لمحدودية الخيارات في أماكن التصوير، بسبب الوضع الأمني الحالي الذي تتنفس البلاد على إيقاعه اليومي منذ ما يقارب الأربعة أعوام، ولا ننسى هنا طبيعة الوعي الذي أنتجته هذه الحرب المسعورة على بلدهم، لدى الشباب المتحمسين للتعبير عن جوانياتهم المشحونة بوقائع يومية، هي أقرب للهذيان، ما جعل البعض منهم يغامر بأن يغرف من الراهن السوري في أول فرصة إخراجية أو تأليفية تتاح له، هذا الراهن الغارق بالعبث والدم.
إشراف الجهة المنتجة جاء غير ذي وصاية أو تدخل من المؤسسة العامة للسينما في سورية، فالقرار الذي اتُخذ بتقديم الدعم المفتوح لكل صاحب موهبة سينمائية جديرة ومبشرة، يفضي بأن يذهب هؤلاء الشباب خلال فسحة زمنية قصيرة، إلى أقصى أحلامهم دون أن يعيقهم أي تابو من التابوهات المتعارف عليها، أو حتى دون أي شروط ولو جزئية للجهة المنتجة، الأمر الذي أكده مدير المهرجان ومدير عام المؤسسة العامة للسينما “محمد الأحمد”، إن كان في فيلم “السينما الذهبية” تأليف وإخراج “محمود عبد الواحد”، الذي يعرض لتاريخ السينما السورية ومقارنة الحياة السينمائية في سورية، قبل وبعد إنشاء مؤسسة السينما، مقدماً مشاهد نادرة من كنوز السينما السورية كـ “فيلم “المتهم البريء” عام 1928 وفيلم “تحت سماء دمشق” عام 1932 للمخرج إسماعيل أنزور، وبعض أجمل المقاطع من حفلات الافتتاح لمهرجان دمشق السينمائي، أو بالكلمة الترحيبية التي ارتجلها “الأحمد” من القلب، قبل أن يدعو وزيرة الثقافة د. “لبانة مشوح” لاعتلاء المنصة وإعلان بداية فعاليات المهرجان، لتأتي كل من كلمة “مشوح والأحمد” عفوية ومن القلب، وفيها الكثير من الثقة بقدرة صناع هذه الرؤى والأحلام الجدد، على إنتاج قيمة مضافة مهمة، ستسبغها نتاجاتهم السينمائية المستقبلية، على مسيرة السينما السورية ماضياً وحاضراً. سنمر على بعض الأفلام التي حملت إشكاليات وجماليات تسترعي الوقوف عندها.
“رحيل”..
فيلم جاء بتوقيع “تأليفاً وإخراجاً” (حنان جوزيف بشارة)، وتمثيل كل من الفنان رامز أسود والفنانة رنا كرم وخريج الدفعة الأحدث للأكاديمية السورية للتمثيل ريمي سرميني، قدم الفيلم حكاية شخصانية المضمون، فيها شيء من محاولة عقلنة وشرعنة اللامألوف واللامقبول، في المجتمع السوري المعروف بأنه مجتمع تحكمه العادات والأعراف الاجتماعية الأخلاقية بشكل كبير، فالمربية التي استقدمها الأب لتشرف على تربية ابنه الرضيع بعد أن ماتت زوجته أم الطفل، ستجد نفسها بين خيارين مضطربين عندما يصبح الطفل مراهقاً، خيار الأب الأقل اضطراباً، عندما يعترف لها بحبه وحاجته لها بعد أكثر من 15 عاماً من وجودها معه في البيت نفسه وبألفة تامة حكمت علاقتهما، وبين حب المراهق الذي ربته كما تربي الأم ابنها.
دعونا لا نسميه حباً إذا أردتم، فلنسمه “مراهقة، حاجة، طيش” ولكن ما هكذا يقول الجانب الأخلاقي للموضوع، على الأقل هذا ما يقوله علم النفس السلوكي والتحليلي المنطقي والوعي الجمعي لمتفرج، يعيش في الوسط ذاته الذي تعيش به “بشارة”، وهنا أتساءل: ما جدوى تجاهل قيم ووعي متفرج هو بالمقام الأول كائن تاريخي وجغرافي، محكوم بمقامات مجتمعه، الأخلاقية منها على الأقل.
لانستطيع القول هنا: إنه تم تخطي عتبة التابو الجنسي، فهذا ليس “تابو” جنسياً أبداً، هذا ابتعاد شديد التطرف عن مسلمات عامة، لا أدري ما الغاية من تسليط الضوء على هذا التصور الشخصاني كما قلت، لحالة ليست غريبة، بل شاذة.
قد يكون “رحيل” الذي قُدم على أنه “أنشودة سريانية للمحبة” بما تحمل كلمة سريانية من إيحاءات لها دلالاتها الدينية غير الخافية على أحد، في الفترة التي تمر بها البلاد حالياً، قد يكون رداً متطرفاً على محاولات متطرفة جداً تعمل على تجريد المجتمع السوري من كل قيم المحبة التي اعتادها.. ربما. إلا أن هناك قاعدة هامة جداً في ألف باء السينما، التي تعتبر واحدة من القوى التربوية وأهمها في المجتمع تقول: السينما لا تقدم لنا أفكار الإنسان كما فعلت الرواية من قبل، بل تقدم لنا سلوكه وتقترح علينا مباشرة ذلك الأسلوب الخاص.
خطوة أمل
الفيلم الذي جاء بسيطاً وواضحاً ومباشراً بحامل واقعي، ليقدم مقولة أو رأياً يدلي من خلاله “فراس كالوسية” مؤلف ومخرج الفيلم، بدلوه بما يجري في بلده، فخطوة أمل جاء بمثابة تحية وفاء، للجيش العربي السوري، الذي يحمي قيم العلمانية والمدنية في البلاد، حيث شاهدنا الجندي السوري العائد من الميدان بعتاده الحربي وبزته العسكرية، إلى بيت “قد يكون أي بيت في سورية لا بيته بشكل خاص”، متعباً ومرهقاً حد التهالك والموت، تدب في عروقه الحياة، وينبض قلبه في صدره مرة أخرى، عندما تناديه الطفولة وهي ترتاح بحضنه: أن تعال لا خلاص لطفولتنا من الأسى إلا بك.
المميز في “خطوة أمل” أنه لم يُضِع زمنه في التفاصيل، التي وضعها غيره من الأفلام الستة لإطالة زمنها، كما حدث في فيلم “حلقة مفرغة” المأخوذ عن قصة لـ “ناجي وردية” وسيناريو بصري وإخراج “أيهم سليمان”، بل عمد إلى تقديم موقف لا لبس في تأويله، كشهادة على مرحلة من المراحل الكارثية التي عاشها في بلد نعم بأمنه طويلاً.
الزخم الذي أعطاه الفنان الخاص “حسين عباس” بالإضافة لكادر التصوير المريح للنظر، نظراً للخضار الحاضر بقوة في الطبيعة المكانية لفيلم “حلقة مفرغة”، ترك انطباعاً جيداً عند المتفرجين، خصوصاً وأنه قدم حكاية مألوفاً وقعها على الجمهور، حيث جاءت قصة الفيلم كعبرة من عِبَر كليلة ودمنة، فالحمار الذي جر عربة المزارع طويلاً، يموت وهو يؤدي العمل الذي مارسه طيلة حياته، فما يكون من صاحبه إلا الحزن والبكاء على فراقه، قبل أن يضعه على العربة ويجرها بنفسه، متجهاً نحو منزله ليدفنه قريباً منه، ومن ثم يحل الرجل مكان الحمار في العمل، ويموت أيضاً بذات الطريقة، ولكن دون أي تواجد لمن يدفنه ويحزن عليه.
نستطيع القول إنه وبشكل عام جاءت الأفلام الستة الافتتاحية، جيدة وذات سوية فنية معقولة بالنسبة لشباب يختبرون لأول مرة أجنحتهم في عالم الفن السابع الأكثر تعقيداً وصعوبة بين الفنون، فالإخراج والكتابة هما من المهن الأصعب في العالم، بعد مهنة ريادة الفضاء والعمل في المناجم، فما بالنا وهاتان المهنتان، يخوض في غمارهما هؤلاء الشباب في ظروف أمنية صعبة جداً، تجعل من الإبداع في فن شاق كفن السينما، أكثر مشقة، وأكثر تشويشاً على انتقاء الأفكار الأصفى والأكثر عناية وعمقاً.
تمام علي بركات