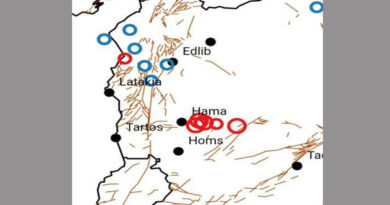يا خَجلَ الموت!؟
د. نهلة عيسى
يموت كثير من السوريين وبعض العرب على شاشات التلفاز كل يوم, كما يموت في كل مكان كثير من البشر, ولكن موتنا لا يشبه موتهم, فهل يستوي الذي يموت في غيلة الشيخوخة أو المرض أو ربما السأم كرهاً, مع من يموت طوعاً, وهو يواجه المجازر, والتجويع, والتعطيش, وتدمير البيوت, وجز الرؤوس, وتجريف الأحلام والمشاعر!؟.
لا أظن أن موتنا هنا يستوي بموتهم, رغم تشابه النتيجة, لأن الفرق كبير بين موت يطال جميع البشر, وموت قام بإعادة الاعتبار للموت, وحوّله من فعل قدري, حتمي, نمطي, إلى حالة أشبه بالتحليق والتعالي فوق كل ما هو معتاد, ومدرك, ومفهوم, ومبرر, ليصبح فعل إرادة, وعبادة وتبتل, وفعل نبل, يخجل أمامه الموت ومن يموتون, لمجرد أن يومهم قد حان!.
موتنا (رغم بشاعته) قضية, لأنه هنا, حيث بيوتنا وقلوبنا وجروحنا وعدونا, وحيث نطالع بالتجربة والعيش, وليس بالسمع, كيف دخلنا قاموس أقل الأمكنة أمناً في العالم (بعد أن كنا أكثرها), للإقامة والعبور ناهيك عن الحب والزواج وتربية الأطفال, وإرسالهم إلى المدارس كل صباح بين هاون وآخر, وعدو مترصد يعادي حياتنا, وهو مدجج بالكراهية والسلاح من رأسه إلى أخمص قدميه.
موتنا موقف, لأننا بقينا وأوطاننا تنزف جرحاً تلو الآخر, وجنوناً بعد آخر, وضحية بريئة بعد أخرى, بقينا.. بينما من يحاولون تركيع الأوطان, يتوقون لتهجير عشاق الأوطان من أوطانهم, ولتكميم أفواههم وقلوبهم وعيونهم, وثم تحويل الأوطان إلى وليمة يتزاحم عليها الشقيق والصديق والعدو, ويتناوشها القتلة وقطاع الطرق وفارضو الخوات وعابرو الذمم ومرضى الزهو المسلح!
موتنا ثأر, لأننا بقينا رغم كل الرهانات التي ليست في صفنا, بقينا بدون كلمات محشورة في رداء الرياء, لنلامس بحنان, الجدران التي نحبها, والزمان الذي مضى في الزمان, ولكنه لم يمض من القلب, والأصوات التي همست لنا يوماً, وروائح من رحلوا, ولكن كل الرشاوى التي قدمها العالم عجزت عن شراء ذاكرتنا لننساهم, إذ لا رشوة في الدنيا قادرة على أن تجلينا عما نحب.
موتنا قضية ردت للموت كرامته, لأننا بقينا وعرس الدم في أوجه, نجابه المخرز بالعين, ونرد الرصاص باللحم, ونرفع الأعلام فوق جثث الشهداء, فتبكي الأعلام , ويصير موتنا قضية, قضية نبيلة, لأننا بقينا بتاء التأنيث وجمع المذكر, نقطب بالدموع الجروح, ونكفكف بالتحدي الأسى, ونرد على الهاون بأرجيلة على الرصيف, ونفتح النوافذ والجحور والصدور, وحتى القبور لشمس يحجبها دخان الغدر, ويرسمها أطفالنا في أوراق امتحانهم, عندما يكون السؤال: ما معنى وطن؟
موتنا يُخجل الموت, لأن المؤتمر تلو الآخر, والرصاص يلاحق الرصاص في أجسادنا, يعقد لتجرع دمائنا في جلسات ادعاء الخوف علينا, يعيدوننا قسراً للتجول داخل الجرح, وللخوض في دوائر أسئلة مراوغة, إجاباتها تبدو سهلة ولكن النجاح فيها عسير, والمشاعر أمامها مبهمة, تستنفر في داخلنا الشعور بالخطر والخوف والقهر, واليقين أن موتنا هو مجرد أحرف في لعبة المصالح السياسية المتقاطعة, لدول أدمنت تقاسم القوة والسلطة والمال والرفاهية فوق قبورنا!.
دولٌ لا تحب الشعر, ولا تغريها الخطابة, ولا تجيد التلميح ولا تحبذه, وتكره الظلال المخاتلة, وتعشق المحسوس والملموس وتتقن صناعتهما بكل الأدوات, ولا يخجلها أن يكون الدمار واحداً من تلك الأدوات, ولا يقض مضجعها أن يدفع الثمن ملايين من البشر, وأن تتحول أوطانهم إلى مقابر, مادام هدفها يتحقق, ومادامت هيبتها مصانة, ومادام الإخراج محكم!.
موتنا قضية, قضية كبيرة, لأنه رغم كل ما كان وما سيكون, ستظل أوطاننا مثل الحياة التي نأتيها كرهاً ونغادرها كرهاً, ونتذمر منها, ولكننا نلعن كل من يقصر أعمارنا فيها, وندعو كل لحظة لنا ولكل الناس بطول العمر والبقاء, مادام لنا وطن, وسيبقى لنا وطن, بل الأصح سيبقى لنا الوطن, لأننا لم نكن لغيره, والوجع عابر سبيل, مهما أقام, ونؤمن أننا على حق هنا وفي فلسطين, أليس من خلف الجبال العالية تشرق الشمس كل نهار؟.