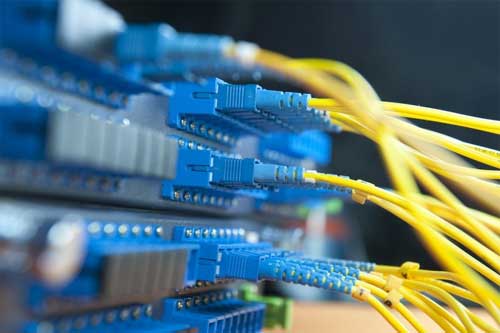محمد أبو خالد .. انفعالات نبيلة تتوق للبقاء والحياة
تتطلب الفنون استعدادا ومؤهلا من الخبرة والموهبة للذين يحلمون بوجود مؤثر فيها، وتعتبر الموهبة الفطرية هي الملكة الأولى والأساس في تجربة معظم الفنانين الذين استطاعوا أن يقدموا نموذجا إبداعيا مختلفا، وبالطبع لا يمكن إغفال المؤهل التربوي والصقل التدريبي لهذه الموهبة التي تتطور من خلال التجريب والممارسة العملية، واختبار الخامات المختلفة والكشف عن إمكاناتها المطواعة لتلك الحواس التي يمتلكها الفنان النحات خصوصا. ولتناول تجربة محمد أبو خالد الطويلة لا بد من التعريف بتلك الشخصية التلقائية المحببة لزملائه وطلابه ولمعارفه، فحياته الفنية لم تكن منفصلة عن سلوكه الشخصي وعن قناعته بأن للفن قيمة يجب أن يعيشها الفنان ويجتهد لتوسيع أثرها في المجتمع والحياة، وأن عمل الفنان المحترف مثله كمثل العامل الذي يذهب إلى ورشته كل يوم ليبدأ بعمل النهار الجديد أو يستكمل الذي لم ينهه بالأمس، وأن أدوات العمل تتعدى المادي منها إلى النفسي، وما يبعث على الحيرة أمام أي خامة أو مادة بين يديه ليجعل منها روحا جديدة في حيز من الزمان الذي يسعى النحات لإيقافه عند هذا الحد من الحركة في المكان، حيث نادرا ما تتكرر هذه اللحظات في الحياة، لكن الفن يجعل منها خالدة وعظيمة، لذلك سمي هذا الفن بأنه فن النحت العظيم بمواضيعه وسلطته أمام الزمن.
تعود معرفتي بالنحات أبو خالد لفترة تصل إلى أربعين عاما مضت عندما كان مدرسا لمادة الرسم في إحدى مدارس ريف دمشق الإعدادية وكان لا يزال طالبا في كلية الفنون الجميلة، ذلك الشاب القريب والصديق لطلاب المدرسة، والذي يتمتع بروح الفنان التلقائية والبسيطة المتواضعة والمستمعة لأي أسئلة مهما كانت، ولا يتورع عن طلب سيكارة من أحد مدخني المقاعد الخلفية في الصف في نهاية الحصة لاغيا سلطة المعلم التقليدية بابتسامته العريضة وبالأخص حين يلاقي تلميذه يرسم أكواخا من الخشب والقرميد الأحمر تحاذي نهرا ينساب من جبال مكللة بالثلج، وهذا هو المنظر التقليدي الذي يرسمه أغلب الطلاب في المدارس.. لكن هذا المعلم لم يرق له هذا المشهد فقد كان يطلب منهم رسم الواقع والبيئة ومفردات البيت وأدوات اللعب والوجوه، ويطلب من البعض التلوين فقط دون موضوع تحقيقا لمتعة خفية في أنفسهم.
تظهر خبرة الفنان على إشادة التمثال من خلال النسخة الأولى التي تجري عليها عمليات النسخ والصب، ونلاحظ شغف محمد أبو خالد بتلك المحاولات المباشرة لجعل العمل الفني مكتملا بين يديه الممرغتين بالصلصال أو الجبس، مثله مثل الطفل الذي يتحسس رطوبة الطين بين أصابعه لتلك الأشكال التي يعجنها بكفه دون خوف من النتيجة، لأن المسافة بين العقل والدهشة هو اللعب بحرية المنعتق والباحث عن نبل يختبئ وراء المادة، مترافقة مع حواس الفنان الشغوفة بتلك الطاقة التي تتضمنها الخامة والحلم بالفكرة.
لا يحتاج النحات الخبير إلى الكثير من الحذف في جسم الصخرة أو جذع الخشب حتى يصل غايته، بل يكتفي بتوقعاته عن إمكانية المادة وكتلتها ليجعل من الأمر شيئا ممكنا وبقليل من العناء، فالعملية هنا هي الذهاب من السطح نحو الداخل، إلا أن فناننا المشتغل بالطين والجبس، يبدأ من لب العمل ومن داخل الفكرة ونواتها نحو الخارج والشكل، حيث يتبلور العمل ويتجلى بما يضاف إلى تلك النواة أو المركز وصولا إلى الرتوش النهائية التي تجعل من السطح كسوة تليق بمصداقية الحضور للمجسد نحتا في شروط الزمان والمكان التي أنتجها الفنان، مضيفا في مفردات الحياة أمرا عظيما وخالدا.
أكسم طلاع