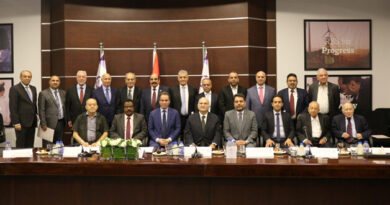النّقد كمساءلة دائمة للنّص
يجب ألا ينحصر دور القارئ في تفسير أو شرح النصّ (الشعريّ خصوصاً والثّقافي عموماً) بحثاً عن نوايا وغايات المؤلّف، لأنّ قراءته هذه، لن تكون أكثر من مراكمة شروحات حشويّة لا طائل من ورائها، وهذا النّوع من القراءة الاجتراريّة يطبّقه الأصوليّ الإسلاميّ على النصّ الأصلي كنوع من المطابقة والمماهاة، باعتباره سادن الحقيقة المطلقة كما يدّعي، كذلك يمارسه العلماني رافع شعارات الأيديولوجيا الشموليّة. ولا بأس هنا بالتّذكير بتلك المقولة التي لم يفهمْها الماركسيّون التقليديّون وهي أنّ ماركس نفسه لم يكن ماركسيّاً، بمعنى أنّ النصّ ليس سوى ظاهرة ثقافية تاريخيّة متغيّرة، لولبيّة التطوّر حسبَ المعطيات التي شكّلتْه، القابل للتّفاعل بحيويّة مع المعطيات الجديدة فيما لو استثمرَتْ الأساليب النقديّة الحديثة حفريّاتها المعرفيّة فيه.
وإن ظنّ القارئ أنّ مهمّته التّأويل باستنطاق النص وأخذه إلى مطارح ومعانٍ لا يحتملها، فإنّ ذلك قد يعني إخراجه إلى دلالاتٍ فضفاضة على جسده، ليبدو مغايراً لمجرّد المغايرة دون أن ينتج بالضرورة فكراً مختلفاً. بينما المطلوب استنطاق النصّ بإمكاناته المتاحة ومخبوءاته غير المكتشفة لتوليد إمكانيّات جديدة تفتح نوافذ النص على رياح القراءة الجديدة.
إن وعى القارئ أنّ مهمّته هي فكفكة النص بإحداث فعل قطيعة مع نوايا المؤلّف ومعاني خطابه المحتملة على اختلاف أنواعها، وبأنّ المطلوب هو تجاوز ملفوظ الخطاب إلى ظلاله وعتمة تضاريسه، فهذا هو شأن كلّ من أراد التخلّص من سطوة النصّ المتعالي وهيمنته المطلقة بابتداع آلية تنفي كلّ سلطة للحقيقة وتقوّضها. ولعلّ القراءة الخلاّقة المنتجة ستكون كلّ ذلك. ولا بأس بخيانة المسلّمات وخلخلة بداهات النصّ الأصلي أيضاً. فالمجتمعات التي تعاملتْ مثلاً مع مفهوم الديمقراطية أو الاشتراكية كنسخ جاهزة للتطبيق تحت حججٍ تحرّريّة، فإنّها لم تحصد سوى حالات استبداديّة مزمنة، حيث حلّتْ أنظمة شموليّة محلّ أخرى بعباءات وطنيّة أكثر توحّشاً، وبالتالي كانت النتيجة الفشل الذي كرّس ديمومة الاستبداد. ومن يدّعي الحلّ بالعودة إلى الأصول الصحيحة للإسلام زاعماً أن هناك مرحلة ذهبيّة ماضوية كانت تمثّل نقاء النصّ، فهو يجهل حقيقة النصّ التاريخيّة، حيث لا حقيقة مطلقة لا في الزمان ولا في المكان. وما النصّ سوى استجابة العقل لمرحلة فكريّة كانت لها أسئلتها المقلقة ككل المراحل التاريخيّة التي تنتج ظواهرها الفكريّة المشرعة على احتمالات مختلفة قد يُجهضَ بعضها لصالح الآخر حسب الظّرف الموضوعي الذي ينتجها.
إنّ الفكر لا ينمو إلا بالتجارب والبيئة الصحيّة التي ترعاه وتعيد ترجمته أو تحويله بشكلٍ مختلف يتناسب والجديد الحاصل دوماً في محيطه، ولا توجد ترجمة بلا خيانة ضروريّة تمثّل انتهاكاً للأصل، لأنّ النصّ هو بالذّات محصلة تجاربه وتواريخه وتطبيقاته ومستجدّاته ومؤسّسات إنتاجه.
فالذي يفكّر حسب عقلانية “أرسطو” أو منطقيّة “ديكارت” أو بهدي الأيديولوجيا الماركسيّة التقليديّة مثلاً، لن يرى بمنهجيّة “نيتشه وفوكو وديريدا” التفكيكيّة التي سعت لتقويض منظومات الأصل والمركز، إلّا دعوات عبثيّة هدامة لا طائل من ورائها سوى الهدم لمجرّد الهدم، لكن يكفي هؤلاء الفلاسفة أنّهم نجحوا في إضاءة المناطق المعتمة والهوامش المنسيّة من الفكر وحرّكوا المياه الراكدة وحرثوا أرضاً بوراً لم تكن معروفة من قبل، وساهموا بتوسيع المفهومات والعقلانيّات الضيّقة المتوارثة بنقدها ونقضها إذا اضطّر الأمر. أليست هذه هي مهمّة العقل التنويري الكبرى والطريقة الفعّالة لزحزحة الجمود الفكري والعقائدي؟ حيث نعلم أن لكل معقوليّة حجُبُها ومناطقها المقفلة ولا معقولها، وطالما أنّنا نتعامل مع الفكر فقط، كحالة معقولة تخلو من لا معقولها، فنحن ننحاز إلى الفكر كجوهر خالص من الشوائب، ونتبعه بيقينيّة جامدة، فعلاقة الفكر بما ينفيه تغذيّه أكثر من تلك التي تحاول ترسيخه وتثبيته. فالفكر الصّوفي مثلاً بطرقه الاستكشافيّة، الإشراقيّة التي تبدو غير معقولة، فهي تضيء جوانب من النصّ وتخصبها بلقاحاتٍ مغايرة لم توفّرها معقوليّة ومنطقيّة النصّ المباشرة، لأنّ لا معقوليّة النصّ هي إمكانية أخرى من إمكانات قراءته والإضافة إليه لو شئت.
لم تقف محاولات القراءة الجديدة، عند نقد البنية العقليّة العربيّة وتراثها النّقلي منطلقةً من الإيديولوجية العربيّة المعاصرة، بل تعدّت ذلك لتصبح نقداً “إبستمولوجيّاً معرفيّاً” لم يكتف بنقد المعرفة بل تعدّاها إلى نقد أسسها وأدواتها وطبيعتها الفكرية، “الجابري، ومحمد أركون وغيرهم” ثمّ أتى من يشتغل على مبادئ العقل ومادّته تفكيكاً وحفراً في البداهات والمفاهيم وفضح ألاعيب وعيوب سلطة الخطاب “جورج طرابيشي، علي حرب وغيرهم”. ولكنّنا نرى أنّ كلّ المشاريع التي ادّعتْ الجذريّة كان لها أوهامها الخاصّة كما يقول “علي حرب” حيث لم يحدث انقطاعا كلّيا ولا تحوّلا جذريّا إلّا في أذهانهم كحالمين. فما حدث مع الغزالي مثلاً بمحاولة نفيه لأعمال الفلاسفة، ومحاولات ابن رشد التي قلّلتْ من أهميّة ما قاله الغزالي، لم يكرّس حالة جديّة مثمرة في تاريخ النّقد التفاعلي. النّقد الحديث مطلوب منه إيجاد إمكانات جديدة للفكر عبر التّأويل والتفكيك اللذين يحرّران النصّ من حصريّته ذات الدلالات المغلقة ويزجّانه في فضاءات ومستويات مختلفة، وبذلك يكون لكلّ نصّ بهذا المعنى طزاجته شرط أن نملك آلية سبر إمكانياته واحتمالات فكفكة معانيه المحتجبة، في لا معقوليّته كما في معقوليّته. لا نص رجعي بهذا المعنى بل يوجد قارئ رجعيّ. إنّ هاجس المعرفة هو السؤال الوجوديّ الأهم، قبل هاجس التّراث، وللخروج من الهواجس القوميّة والأيديولوجيّة الضيّقة، يجب قراءة التّراث العربي كمنطقة من مناطق اشتغال الفكر الإنساني عموماً، إذا أردنا المساهمة بإنتاج معرفة جديدة ذات بعد عالمي. ثمّة فرق بين “نقد العقل ونقد النصّ” لأنّ نقد العقل هو تعيين للحدود وكشف للإمكانات ونقد النصّ اجتياز للحدود وتغيير للشروط كما فعل “كانط” بنقده للعقل إذا نظرنا إليه بعين التفكيك، فعمله لم يقتصرْ على كشف إمكان أو رسم حدّ، بل كان اختراقاً لأسوار العقلانيّة المسيطرة وتغييراً لشروط المعرفة. فالحقيقة هي أقلّ حقيقيّة مما ينبغي، والواقع أقلّ واقعية مما نحسب، كما يقول “علي حرب”.
أوس أحمد أسعد