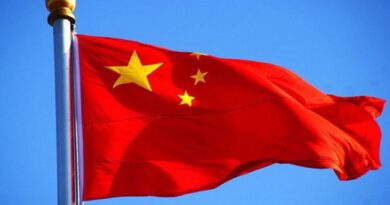طمئنونا عن صمتكم!؟
د. نهلة عيسى
تسألني إعلامية عربية في مهرجان الإعلام: كيف استطعت العيش على حد السكين لسبع سنين؟ وكأنها ترجوني أن أشكو, أن أصرخ, أن أبكي, فقلت لها بهدوء: أزعم أن ضمير المتكلم فيما أقول, هو ضمير جمع كل السوريين, وعليك أرد: رغم الوجع لم أكن عاجزة, بل مقاتلة, رفضت الدخول في سباق الكراهية, مع العبوات الناسفة, والمسدس, ورضيت بتأميم الوجع, الذي غادر المساكن الشعبية, والشوارع الخلفية, وقلوب الأمهات, ليختلط بكل الناس, بالغيوم العابرة, والورود التي تذبل قبل أن تكبر, والشجر الذي يموت واقفاً على أقدامه, والشوارع التي ترتدي جواربها السوداء عند كل مغيب, والحب الذي لا تستدعيه طبول العالم, ويأتيك طائعاً دونما مواعيد مؤجلة, والكلمات التي لا تقرع باب أحد مرتين, حيث صارت في بلادنا جملة “البقية في حياتك” مثل صباح الخير!.
كيف عشنا؟ تسألين: كانت تقص رؤوسنا كل يوم, لسبب مبني للمجهول, وعندما كنا نطالب أن يبنى موتنا للمعلوم, كان العالم “الحر” ومعظم العرب يقفون فوق تلال رؤوسنا المقطوعة, ليشجبوا صفاقتنا, ولا إنسانيتنا, لأن مطالبتنا بالموت في العلن, تفخخ عقود ياسمين السلام, فنستحي لأننا حقاً همج! فالواجب علينا أن نخرج من موتنا, ونرمم رؤوسنا المقطوعة, ونقف في الساحات والميادين نرحب بصناع السلام الميامين, ونرجوهم أن يأخذوا وقتهم في صنع السلام, إذ لن يضير الشاة بعد الذبح الانتظار!.
تسألين كيف عشنا؟ هذا سؤال لا يحتاج للنبش في الحقائب العتيقة, لمعرفة ما فيها: شهادة ميلاد, أم صك وفاة, أم تميمة تطرد أشباح الماضي من بيتك الجديد!؟ ولن أجيب على سؤالك بسؤال, بل باعتراف بسر صغير: يوم التحفتم أنتم الصمت على موتنا كفناً, أقمنا نحن على أرواحكم الصلوات, وتقبلنا التعازي, بيقين العارف: أن لا (كان وأخواتها), ولا (أنَّ وأخواتها), ولا الأفعال التامة, أو الناقصة, أو المتعدية, ولا حتى (لا) النافية للجنس قادرة على أن تعيدكم من منافيكم, بعد أن جرتكم (حروف الجر) إلى الخوف, فماذا نفعل, و(ما) بعد إذا, هي حرف زائد, ببساطة حملنا البندقية ودافعنا عن حياتنا وحياتكم!؟.
تسأليني, وفي السؤال شراك: كيف عشت؟ تريدين جواباً؟ إليك الجواب: رأسي ليست مخبأة في الخزائن الحديدية, إنها مذياع أحمله في رحلتي النهارية, وكل شيء حولي بحالة رحيل من المحطات الحزينة: الصداقة, الفرح, الحب, الأشياء المُتوهمة, والأشياء المُبالغ فيها, وأنا مع كل رحيل, أولد من جديد, وأنتمي إلى يقين, أنتمي إلى وتد: أن يوماً في الوطن يعادل عمرين, وأنني فيه على الأقل, أتقاسم الخبز, الحزن، الموت مع من أحب, تراك اصطحبت في صمتك من تحبين؟ تسأليني عن عيشي.. موتي: الحرب في كل أوراقي الشخصية, فيما أكتب, وما أقول, هي حافز كل ما أقوم به من فعل, هي سبب في أنني في كل الجبهات, أطبطب على كتف شاب, حبيبته باتت بندقية, وأعانق آخر, وأتناول الطعام مع الرجال في كمائن عرائشها رصاص, وأسرّتها رمال وحصى, وأضحك من قلبي على حكايات رعب يروونها نكاتاً, ثم أبكي أنني ربما في المرة القادمة, لن أرى بعض هذه الوجوه!؟.
تسألين كيف عشت؟ سامحيني إذا انتابني سعال الضحك, لأن سؤالك جاء بين شوطين!؟ فالحرب ربما تغلق أبوابها في بلادي, ولكنها في مستطيل النور عندما يشع في انفراج باب أي من أبواب العرب, وفي وهج اللفافة الأخيرة قبل النوم, وفي تواقيع الرسامين في لوحاتنا المعلقة, في أغلفة الكتب, وذوبان الثلج في الأكواب, ورنة الملاعق الصغيرة في كأس الشاي, وفي صمت المذياع برهة قصيرة, يتوقف القلب فيها.. ترى من مات؟ وفي غبش زجاج السيارات بعد أن ينقشع الضباب, وبخصلة شعر كنت قد قصصتها, وأهديتها يوماً لجندي صغير, قال لي: أمي شعرك جميل, وردوها لي منذ حين, وقالوا لي ببساطة الصفاقة: أنه مات, ويا صديقة: كل جندي في بلادي مات, مد يوماً في أعمار العرب, تسألين عن عيشنا: موتنا بخير, كيف صمتكم!!.