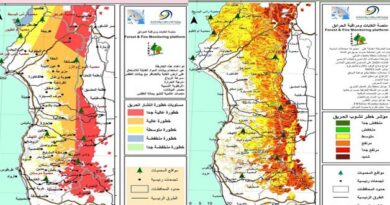الذاكرة زهيدة الثمن!؟
د. نهلة عيسى
لعن الله من كان السبب، ولعلمكم أنا لا أشتم، ولكنه كلام جميع من قابلتهم في إيران عند الحديث عن الحرب علينا، خاصة وأن كل أسباب الحرب تبدو من وجهة نظر الشاتمين ضباباً، وظلال أفاعٍ، ونوارس تحوم فوق البحر، يظنها الرائي من بعيد أنها في انتظار اصطياد السمك، ووحدهم المتبصرون يدركون أن النوارس ترسم الأفق.. وآه! ما أوجع أن تكون الحرب دافعاً لرسم الأفق!.
أسبوع قضيته خارج الحرب، شكلا،ً وسط صحبة العقل والقلب نتبارى على حب الوطن، نتساءل عن هويتنا، عن غدنا، ونحلق فوق غيمة من الرضا بأن الغد لابد لنا، وجاء اليوم الثامن ليقيدني إلى حجارة الرصيف في المسافة بين البكاء والكبرياء، وليطلق في رأسي نواح قبيلة من الرجال والنساء على وطن كان مطاره يعج بالبشر من كل حدب وصوب، والآن يعج بالصمت الوقور، كعجوز منهك الجسد, حاضر البصيرة، يتأمل فيما مضى، ويتمتم: الذاكرة زهيدة الثمن.. زهيدة إلى حد أنها بسعر شظية!!.
على الرصيف في مكاني أتعرق وجعاً, وسكاكين الغضب تمزقني قطعاً،وكأني على ظهر شعرة، لا أملك خياراً، وشعرت وكأن الهواء مات.. والطريق مات، والبشر والشجر والرصيف والسفر والرحيل وأنا مقيمة في قاعة انتظار، بلا أحد، سوى صوت قلبي يخاطب الرب.. يسأله: لماذا غامر آدم بأكل التفاح، تراه من الضجر؟! ولم عوقب بالنزول إلى الأرض!؟ والغريب أن أول ما فعله هو زرع التفاح، فقضينا العمر نأكل من الشجر المحرم، حتى وصلنا زمناً أصبح كل ما نأكله ونفعله ونجزيه محرماً، ترانا نكفر عن ذنوب آدم، أم ترانا فعلنا بأنفسنا ما فعل آدم!؟.
على الرصيف في مكاني، كطفلة حافية القدمين تحت المطر، بلا قبعة، ولا مظلة، ولا وجوه حانية، أرتعش من البرد، وأتساءل: من أنا؟ وأين أنا؟ ثم يرتد عقلي لثانية، فأحاول أن أتذكر أني في دمشق، وأنني في حضرة الجميلة حيث لا يليق بها سوى الحديث عن النجوم، والمدى، والقمر، وعن البهجة ترسم حدود الوطن، وعن التزلج على دانتيلا القلوب، وذاك البوح بين رأسين مرغمين على الحب، ليزدهر الحب صيفاً من شغف، ليس يعنيه قصر عمر الشغف، ثم يعاود العقل الغياب، فيحتلني صوت جميع أبناء الوطن يتساءلون: من باع الوطن؟! من جعله مقبرة مسورة بالميكرفونات، تمجد الكراهية؟! من جعل الموت أرخص ما فيه؟! من صيرنا كلنا متمتمين يرسمون بهمهماتهم خارطة لوطن يموت فيه من يدافعون عنه، ويعيش باعته؟!.
على الرصيف في مكاني أتعرق وجعاً، خوفاً أن نفقد الصبر، وأن يأتي يوماً نلملم فيه الجروح حقائب سفر، ونترك الجنود في جبهاتهم عراة من دعواتنا> وأن.. وقبل أن أتابع هواجسي، هطل في قلبي المطر، فسارعت بالتذكر قبل البكاء، عندما في فجر ربيعي، وصلت مطار دمشق بعد سنوات طويلة من الغربة، شابة صغيرة، متوجسة، تغادر مهد الدراسة في خطواتها البكر نحو الغد، وليس في خزان التجربة سوى دكتوراه وبضعة أحلام صغيرة، ويخيل إليها في كل متر تقطعه، أن سيف الحجاج في آخر المتر, فتقف في منتصف المتر عزلاء بين السيف والجدار، وكأنها كانت كزرقاء اليمامة ترى الحرب قبل الحرب!! وها هو خوفي يعود إلي في نضجي، يفترش الرصيف معي، فأشعر بالعار، أتخيل دمشق تضحك وهي على الأخشاب مصلوبة، فأتلمس أصابع قدميها ما بين الدهشة والتكذيب، وأشاهد العالم يحشو جراحها بالورق، وبالثرثرة، حول ما يجب، وما سوف،وما سيكون، وكل أحرف التسويف والمذلة، فيعكس مصباح المطار وجهي المكلل بالوجع، فأبدأ أنا وخوفي نغني رغم أنف صقيع المطار: “خبطة قدمكم على الأرض هدارة، أنتو الأحبة وإلكم الصدارة..، ونراقب ظلال القتلة تحت وهج المصابيح صماء مغبرة، فنتمتم أنا وخوفي للذات: ربما يخفت صوت الحق، لكننا مع جنودنا نجيد رفع الصوت ليعرف العالم كله أن وطننا لا يقول سوى الصدق.. امتلأ المطار أم فرغ!!