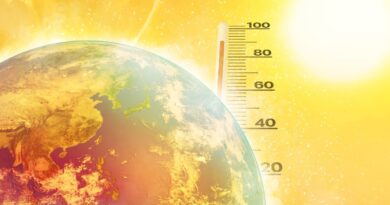ياسر العظمة.. في الليلة الظلماء يُفتقد البدر
قبل رمضان بفترة قصيرة عرضت بعض القنوات التلفزيونية المحلية، جزءاً من السلسلة الدرامية “مرايا” وإن مشاهدتها في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدراما السورية، تدفع المرء إلى متابعتها بكثير من الحنين، إذ تعود بنا إلى عصر ذهبي مرت به الشاشة المحلية الصغيرة، كان فيه الفنان القدير، “ياسر العظمة”-1942-، سيدا لهذه الشاشة دون منازع.
الرجل الذي زاول الكوميديا الرصينة والثقيلة في مختبرات “محمد الماغوط” بداية، سيشق لنفسه خطا تلفزيونيا جديدا، يحمل فيه لواء الكوميديا، عن أعمال “نهاد قلعي” التلفزيونية، مع تعديلات على مستوى الشكل، الذي أخذ شكل اللوحات المنفصلة، والتي تطول أو تقصر بحسب مدة الحكاية.
خلال ما يزيد على الربع قرن، كان الجمهور على موعد في كل عام، مع جرعة عالية من الانتقاد للمظاهر السلبية في المجتمع، وفي الحياة الثقافية والفكرية، والعادات السيئة، وغيرها من الثغرات التي قد تعترض حياة الناس، أو مفاصل الدولة والمحسوبيات، وانعدام روح المسؤولية، مستعينا بذلك بنخبة من الممثلين الأفضل في تاريخ الدراما المحلية؛ (عصام عبه جي، حسن دكاك، سليم كلاس، سلمى المصري وغيرهم)، مفسحا الطريق لصناعة نجوم جدد، كان ينتقيهم وفق معايير فنية صارمة، (قصي خولي- عبد المنعم عمايري- رهف شقير- مديحة كنيفاتي- نسرين الحكيم وغيرهم)، وكان يحرص على حضور مشاريع تخرج المعهد العالي للفنون المسرحية، ويجلس ليشاهد بعين الخبير الفاحصة مَن الذي يستحق من الخريجين أن ينتسب إلى مشروعه، طبعا ذلك لا يعني أنه كان يعتمد فقط على الأكاديميين من الممثلين، بل كان دائما في حالة بحث عن ضالته بين الكفاءات والمستويات الرفيعة.
الرجل لم يكتفِ بإعطاء الفرص للممثلين الجدد، بل كان يمنحها أيضا للمخرجين، فالعديد من مخرجي الدراما المحلية اللامعين، تخرجوا من مدرسة “ياسر العظمة”. إن من يحاول تقييم تجربة “ياسر العظمة” يخطر بباله أولا كممثل بارع، ولكن ذلك من التفاصيل والأمور الفرعية، فالأساس في تجربته، هو قدرته على التقاط روائع المواقف، العبر، اللحظات الكوميدية، والانتقاد الشفاف من الواقع، ومما يسمع أو يشاهد، تارة يأتي بقصة وقعت في إحدى الأرياف السورية مثل لوحته الشهيرة، عن الرجل الذي كان ذاهبا لبيع بقرته، فتوقف ليركب معه في القسم الخلفي من سيارته “البيك أب” رجلا مضطرا تقطعت به السبل، ثم توقف وأركب رجلا ثانيا، فيبيع الرجل الأول البقرة للرجل الثاني الراكب معه في الخلف مدعيا أنها له، وينزل بعد قليل، وطورا يأتي بقصة، من نفائس الأدب العالمي، من كنوز “أنطوان تشيخوف”، ” أو هنري” و”عزيز نيسن”، ولكن بعد أن يلمس فيها إسقاطات واضحة تتقاطع مع الواقع المحلي.
إن توقف هذه التجربة العظيمة، وانكفاء رائدها عن الأضواء، التي لم يكن يحبها أصلا، تدفع بنا إلى سؤالين: هل نستطيع الآن وقد أصبحنا على مسافة زمنية كافية من هذه التجربة الدرامية، أن نقيمها ونلم بأبعادها؟ وهل يجب مناشدته للعودة إلى هذه الدراما؟ ذلك أن غيابه القاسي عنها والمفاجئ، ربما يكون من أهم أسباب ضعفها الأخير؟
قد يكون حاله الآن، وهو يشاهد الويلات التي ألمت بالبلاد والمنطقة، كقول الشاعر: (وحين تطغى على الحران جمرته/ فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم).
تمّام علي بركات