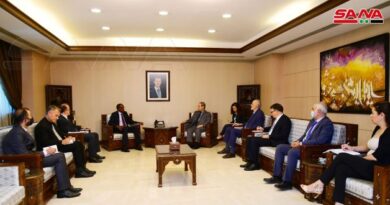جرعة ضحك!؟
د. نهلة عيسى
أجلس في غرفة الانتظار, وعيوني على باب قاعة واسعة, فيها عشرات الكراسي الجلدية الطبية, تتربع على عرشها نسوة موصولات بأكياس الكيماوي, بينهن أختي, تقاريرهن الطبية تقول: أنهن في دائرة الخطر الشديد, بينما أصوات ضحكهن الذي لا يكاد ينقطع تشي بأنهن في صالون للتجميل, خاصة وأن جل حديثهن يدور حول الرجال, الذين يبدون على ألسنة الضاحكات وكأنهم ركام الأعوام المكومة كأثاث عتيق معروض للبيع أو للتبرع, فتنتابني عدوى الضحك, فيتجهم وجه جاري على الكرسي المجاور ينتظر بتوتر زوجته المشاركة في الضحك, ويتمتم بصوت مسموع: صحيح ناقصات عقل! فأرد عليه باللاشعور: يخزي العين عنك, الله يكملك بعقلك, فيدرك قبل أن أدرك أني أسخر, فيغادر مقعده هارباً متعثراً, وأتابع الضحك!!.
أدخل إلى القاعة, أخبر زوجة الرجل: ستتطلقين بسبب الضحك, فترد مهللة: الله يبشرك بالخير, “بخلص من النكد”! وكالجوقة تتعالى دعوات معظم الضاحكات المراوحات بين الموت والحياة: “عقبالنا جميعاً”! وتسارع صبية صغيرة للقول: “عقبالي بس استنوني لأتزوج”, فيصبح الموقف شديد العبثية, مرن يتسع لكل صيغ ردود الفعل, ضحك, بكاء, غضب, هرب, فأهرب دامعة ضاحكة, غاضبة من أن دواء الوجع, وجع, ومن أن الحياة على بعضنا قاسية!!.
أعود للجلوس في غرفة الانتظار, وكل ما حولي غريب ومختلف عما ألفته, حتى الوجوه تبدو رغم نصف الابتسامة, أكثر حدة, وعمقاً في التقاطيع, وشراسة في التعابير, وكأنها تسأل: لماذا نحن؟ فأجيب في سري: ليس هناك طريق مختصر للحياة رغم الأكاذيب البيضاء للأمهات التي تعدنا في الصغر بالأمير “وحذاء سندريلا”, متجاهلة الجزء الكبير من الحكاية, الخالة زوجة الأب, والعمر الحزين, والغريب الجميل, أننا مثل أمهاتنا نعيش متجاهلين الجزء الكبير من الحكاية وننتظر الأمير!!.
أغادر المستشفى مع أختي واهنة القوى بعد أن أنهت الجوقة الضاحكة جرعتها, وتبادل أفرادها القبلات, ونالني من الحب جانباً باعتباري مرافق لذيذ, وأتسكع بها في الطرقات, تراقب عبر نافذة السيارة المارين والمارات, والسيارات الفارهة والنساء الثريات يترجلن منها إلى محلات الماركات, فتشير إليهن قائلة: لو يعلمن أن الصحة أجمل الأثواب, فأرد ضاحكة: كل الأوثان المعبودة, مصنوعة من ذهب وماس, فتجيبني ساخرة: الآن أعرف لماذا ترتسم دائماً على وجهك لا مبالاة الفقراء, سارعت بالرد: ماذا أفعل والماس عزيز!؟
نتابع التجوال في الشوارع المزدحمة, وتغفو أختي على صوتي يعلو بالشتائم على الراكبين والعابرين كجميع السائقين, فأقفل فمي وزجاج السيارة, وأشق طريقي نحو البيت أدندن في سري أغنية رقيعة من أغاني الكراجات, لست أدري من أين حفظت لحنها والكلمات, ولكنها كانت أول ما خطر على بالي للدندنة وأنا من التعب في طور التحول من عنب إلى زبيب, وكأنها كانت استمراراً لعبثية يوم, نصفه الأول تنين ونصفه الثاني إخطبوط!.
أطيل الطريق إلى البيت, وفي الحلق ضحكات غافيات لكي لا يعكرن غفوة أختي, والرأس طاحونة تعيد شريط وجوه السيدات الضاحكات, تتلاقى أوجاعهن فتتحول إلى لوحات انتصار, مكتوب عليها: ربما بعض أعضائنا مبتورة, ربما الدواء سم ونار, ولكننا نحتفل بالحياة يوماً بيوم, لأن المرض علّمنا أن الجمال يعيش في ما يظنه الأصحاء توافه الأشياء, وأن كل صعب إلى زوال, هكذا نتمنى, هكذا نريد, هكذا ندعو, وبهذا نأمل أننا سنعيش.
نصل البيت وينتهي الطريق, فتعانق أختي سريرها كأنه المنى, كما ترفع القلاع العتيقة جسورها لتقطع صلتها بالداخلين إليها, لتعيد تحديد موقعها من نفسها ومن العالم, بلا أقنعة ولا تبريرات, ولا لعبة مرايا الآخرين, بل فقط أمام “مرآة الذات”, لتزرع في حضن وسادتها ما يبدو خجولاً في مآقي عينيها, لتعود بعد ساعتين إلينا فنمسح نحن ما تحت هدب العين, ونتجادل حول أينا أجمل!؟.