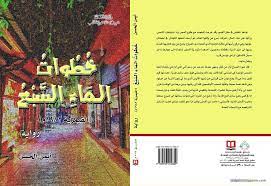تطبيع أم تطويع؟!
حرب المصطلحات والمفاهيم ليست بالجديدة بيننا وبين العدو الصهيوني، الذي غزا أرضاً عربية وطرد سكانها الأصليين، وادعى حقه التاريخي فيها تحت مزاعم وأباطيل دينية ومرويات تاريخية مزيّفة، وأمعن قتلاً وتنكيلاً وتهويداً بالأرض والتاريخ، وسطا على الثقافة الوطنية ونسبها زوراً وبهتاناً لقطعان مستوطنين جيء بهم من كل أصقاع الأرض ليقيموا أكبر مستوطنة استعمارية احلالية وعنصرية في القرن العشرين. والتطبيع يعني كسر حاجز العداء في العقل العربي للعدو الصهيوني، وتشكيل منظومة قيم صهيونية تضرب فكرة العروبة والعداء للعدو، ثم نزع السلاح من يده واستسلامه وخضوعه بالنتيجة لإرادته.
مفردة التطبيع مفردة دست في خطابنا الإعلامي والسياسي، لتشكّل الانطباع بأن لا عداوة أساساً بين العرب والصهاينة، فتعود الأمور طبيعية بينهما، وهذا افتئات على الواقع والتاريخ وحقائق الأشياء. إن التطبيع كحالة تعكس علاقات بين دول يعني أن العلاقة كانت ودية وطبيعية بين دولتين ثم شابتها خلافات أو صراع أو نزاع وحلت على إثرها حالة من العداوة بينهما، فتحدث ظروف وتطوّرات جديدة تستدعي الحاجة لعودة العلاقات كما كانت في الأصل، أي علاقات طبيعية، بعد تجاوز أسباب الخلاف أو النزاع بين أطرافها، ويمكن أن نضرب مثالاً على ذلك ألمانيا وفرنسا، أو ايطاليا وبريطانيا، أو اليابان وأميركا، على خلفية الحرب العالمية الثانية، فحالة الحرب والعداء التي حكمت فترة الحرب بينهما أعقبها تطبيع للعلاقات بين تلك الدول، بل تحوّلت إلى دول حليفة، لأنه لم يكن، قبل نشوب الحرب، حالة صراع بينها، أما في الحالة العربية الاسرائيلية فإن المسألة مختلفة تماماً لأنها أساساً حالة صراع، فنحن أمام عدو هو كيان استعماري احلالي عنصري غاصب محتل غاز لأرض عربية فلسطينية استولى عليها بالقوة المسلحة، وبالتآمر مع قوى دولية، على رأسها بريطانيا، كقوة احتلال، تحت مسمى انتداب، مهدت ووفرت ظروفاً وأوضاعاً وبيئة للغزاة الصهاينة كي يستولوا على فلسطين بالقوة ويطردوا سكانها الأصليين منها، ليحل محلهم قطعان المستوطنين من كل أرجاء المعمورة ليقيموا كياناً دخيلاً وبؤرة عدوانية، مارست وتمارس كل أشكال العدوان على الدول العربية المحيطة بفلسطين وخارجها، وتتمدّد على حساب أرضها وسيادتها، وتشكّل حالة توتر وصراع دائم فيها، بل وتهدد أمن المنطقة، والعالم بفعل سلوكها وطبيعتها العدوانية التوسعية، فأي تطبيع هذا الذي يجري الحديث عنه مع هذه البؤرة الاستيطانية السرطانية المعتدية، من هنا يصبح الطبيعي معها هو الأصل والأساس الذي نشأت عليه العلاقة والتماس معها، ألا وهو القتال والمواجهة والصراع، وما عدا ذلك فهو الخضوع والاستسلام والتطويع لا التطبيع.
لقد سعى العدو الصهيوني وأدواته حثيثاً كي يصبح جسماً مقبولاً في المنطقة، وينزع حالة العداء المترسّخة في وعينا الجمعي ضده، ويجعلنا نمد يد الصداقة له بدل رفع البندقية المقاومة المقاتلة في وجهه، ولكنه فشل وسيفشل، ولعل تجربة معاهدة “كامب ديفيد”، التي وقّعت قبل أربعة عقود ونيف، هي المثال الحي على ذلك، فإقامة سفارة له وسط القاهرة زادت أسوار الكراهية له ولمن وقّع معه معاهدة “الصلح”، التي أودت بحياته، لأن العداء لعدو تاريخي لا تزيله أو تمحوه معاهدات واتفاقيات سياسية، لأن حالة العداء الحاصلة لم تكن أساساً وليدة قرار سياسي بل نتاج تاريخ من العدوان والقتل والإرهاب والتوسّع مورس ضد أبناء الأمة وأرضها ومقدساتها، فهي حالة مترسخة في الوجدان والضمير الجمعي لأبناء الأمتين العربية والإسلامية والأحرار في العالم، لأن قضية فلسطين هي أساساً قضية تحرّر وطني بمواجهة قوة استعمارية استيطانية عنصرية من مخلفات عصر الاستعمار الكولونيالي.
لقد فشل العدو الصهيوني، عبر ما سمي معاهدات “سلام” أو العلاقات الاقتصادية بينه وبين بعض الأنظمة العميلة، في كسر حاجز العداء الشعبي له، فبقيت المسألة مقتصرة على البعد الدبلوماسي والسياسي، ولم تخترق الجدار الوطني، ما جعله يلجأ في الفترة الأخيرة إلى محاولات اختراق هذا السور الحصين عبر بعض الأقلام المأجورة والموتورة، أو الأعمال الفنية في دول الخليج، لتكون بوابة الاختراق المتخيّل لذلك، وهذا كله وليد ايحاء سياسي وليس نتاج محاكمة ثقافية موضوعية وقناعة شخصية أو ضمير مهني، لجهة أن الكتاب والمثقفين يفترض بهم أن يكونوا نبض وضمير الشعب والأمة، وليس لسان حال السلطان، ما يعني أن هذه الأقلام والدعوات محكوم عليها بالإخفاق، وسيلحق بدعاتها ومروجيها الخزي والعار، لأنهم بدعواتهم تلك تنكّروا لدماء عشرات الآلاف من الشهداء، الذين قضوا دفاعاً عن فلسطين والقدس، وطننا الروحي، وتجاهلوا حقوق الملايين من الفلسطينيين وغيرهم من العرب ممن احتلت أرضهم وانتهكت حقوقهم وأعراضهم وشرّدوا في أصقاع الأرض تحت مسمى لاجئين، وهم أصحاب الأرض والتاريخ والثقافة، ليحل محلهم مستوطنون غزاة هم نتاج مجتمعات أوروبية رفضتهم وعاشوا حالة من الغيتو والعزلة وتعرّضوا لاضطهاد انتج ماسمي “المسألة اليهودية”، وهو مشكلة غربية، لتصدّر إلينا وتحل على حساب الشعب الفلسطيني، وتدخل المنطقة في حالة من اللااستقرار والصراع الذي لا نهاية له إلا بزوال أسبابه المتمثّلة في الاحتلال والتوسع والغزو.
إن الفشل في “التطبيع”، عبر البوابات السياسية والاقتصادية والإكراه السياسي والضغط والابتزاز من قبل الأنظمة الخليجية، هو الذي يدفع بالعدو الصهيوني وأعوانه للدفع باتجاه البوابات الثقافية والتربوية والقوة الناعمة لإحداث اختراق ما في المجتمعات العربية والإسلامية. من هنا تأتي أهمية التصدي لتلك المحاولات من خلال النخب الفكرية والثقافية والمنظومات التربوية والمنابر الدينية والمقاطعة الشعبية لكل منتج صهيوني، إضافة إلى تعرية أي حاكم عربي يتبنى هكذا سياسات تجعله معزولاً شعبياً وفاقداً للشرعية، إضافة إلى التركيز على الخيار الأصيل في مواجهة العدو ألا وهو خيار المقاومة والبندقية المقاتلة، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإحياء المناسبات الوطنية والقومية، ومنها يوم القدس العالمي، والتي تستنفر فيه كل طاقات الأمة النضالية والايمانية، لتقول للعدو الصهيوني وأذنابه: إن للقدس وفلسطين أهلها وحماتها الذين لن يهدأ لهم بال حتى تعود لأصحابها حرة عزيزة مستقلة متحرّرة من دنس الصهاينة وأعوانهم الامريكيين وتوابعهم السياسية من أنظمة غارقة بالخيانة والعمالة للغرب الاستعماري، العدو التاريخي للعرب والمسلمين.
د. خلف المفتاح