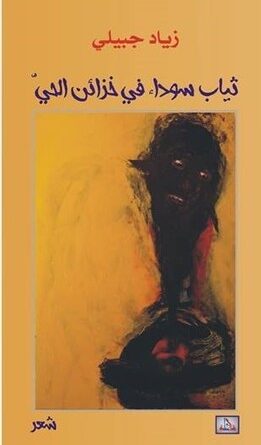“ثياب سوداء في خزائن الحي” هذيان له رائحة ولون
“ثياب سوداء في خزائن الحي”، عبارة فجائعية، يمكن أن تكون عنوان فيلم لـ تاركوفسكي في دلالتها التي تُبرز ميله الشديد لإظهار الأثر الذي تتركه بصمة الزمن على الأشياء، وما تتركه على روح الشخصيات، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون عنوانا مناسبا للوحة من لوحات لؤي كيالي نظرا لواقعيتها الشديدة مع جموحها الشديد للرمزية، ربما قصة قصيرة لأديب روسي كون البؤس يلفها كوشاح، لكنها في الواقع ليست لا للأول ولا للثاني ولا لغيرهما ممن يمكن أن يكون هذا العنوان الجنائزي لواحد من نتاجاتهم.. “ثياب سوداء في خزائن الحي” هي ما حمله غلاف المجموعة الشعرية الثانية للشاعر السوري زياد جبيلي بعد مجموعته الشعرية الأولى “لا غيم يقود العربة”، كرد أدبي عنيف في منحاه العام على الحرب وأفعالها الكارثية على كل شيء، الحجر والبشر وما بينهما، وبهذا تكون واقعية العنوان المفرطة، هي في ذاتها رمزية كثيفة تجلب من الواقع مادتها البصرية، ومما وراء هذا الواقع روحها ومعناها.
هذه المزاوجة التي تشبه سيلا متدفقا من الرؤى التي لا تستطيع اللغة مجاراة كثافتها أحيانا، تنسحب كتقنية سردية على بقية المجموعة التي تتنوع عناوين نصوصها، لكنها تبقى معلقة في الفضاء ذاته، خصوصا وأن المزاج العام للمجموعة بمثابة ترجمة “هذيانية” ليوميات شاعر وجد نفسه في مواجهة الموت دفعة واحدة، في الفترة التي قضاها في مدينة حلب، عندما كانت 5 دقائق نوم مستمرة بلا انقطاع أو موت، هي حلم لرجال كثر، كان منهم وهم يطلون على الوجه الأكثر خسة في الحياة “قاتل أو قتيل”، والهذيان الذي زاره على هيئة تواريخ وبشر وأمكنة، كان ملاذه من الهذيان المقابل، عندما لا تُقاس الحياة بالسنين، بل بالأنفاس.
يبدأ جبيلي سرده الانفعالي المتقطع، من اللحظة التي دخل فيها المدينة التي عاش فيها جده الأكبر “المتنبي”، وكل المسرات البهية التي يدركها بوجدانه أولا، لم يبق منها حتى في البال إلا الأنقاض والركام، إنه وبشكل تلقائي يجد نفسه يقف في بداية المرثية المطولة على الأطلال، كما فعل أجداده قبل اكثر من 1500 سنة، فهو بشكل فعلي يقف عليها، يحاول أن لا يطيل الوقوف، إلا أن التفاصيل التي تتناثر في المكان والزمان، تشغله حتى عن أزيز الرصاص ودوي الانفجارات، لتذهب حساسيته التي مرنت رهافتها، اللاذقية بين جبلها وبحرها، صوب ما يلتقطه بحسه الإنساني أولا: “الصور الملقاة على بلاط محروق، دليلك في التعرف على من لو كان هنا، لعرفت حكاية الابتسامات الموزعة في كل صورة، وعرفت الأصدقاء الذين ما عادوا أصدقاء، وكيف تبدلت الأحوال وأصبحوا يستعينون بثوب واحد لقضاء كل الفصول، لكل المناسبات والأحلام والأمنيات، ثوب واحد يكفي لحياة واحدة”.
يجيء منطق السرد في لغة جبيلي شعريا في توصيفه حالته المنفعلة عنه، لا في الأشغال اللغوية، لكنه يحكم إغلاق تلك الدائرة بحبكة شعرية نقية وصافية كما في نهاية المقطع السابق “ثوب واحد يكفي لحياة واحدة”، وهو يجيد ببراعة، حياكة جملة لها أكثر من واجهة تطل على المعنى، كما أنها تكتفي بذاتها لتكون بمثابة هويته الحسية، التي تحمل وجه أسلوبه في السرد الشعري، نقطة تمايز ينفرد بها بين جيله من “شعراء” كان التشابه في ملامح نتاجهم، هو السمة الأبرز التي تجمع بينهم ومن الجنسين.
لا انعطافات حادة في السياق العام للمجموعة، رغم وجود انقطاعات شكلية في الحالة السردية، انقطاعات هي عبارة عن عناوين مسارب أخرى في وجدانه، شردت لوهلة عن المشهد المُستعاد دفعة واحدة، كما لو أنه كابوس طويل لا يريد أن ينتهي، من تلك العناوين ” الطريق إلى حلب/ وصول القوافل/ نهش النهار/ الكمين/ عدد خفيف يُهمل بعد الفاصلة/ ابتسامة المصيدة/ أمنية الجندي/ وغيرها”، ومن “أمنية جندي” نورد التالي: “أن تترك رفيقك ينزف حتى الموت دون المغامرة بكشف موقعك/ أن تُغمض عينيك وتفتح فمك وتتجمد حين يمر العدو أمامك يتفقد طرائده/ أن تأخذ دور العدو أيضا/ كل شيء مباح في سبيل أن تحيا –هكذا تقول- وترى رفيقك يُذبح أمامك/ رفيقك يميزك في الليل/ يتعرف عليك من انكسار وقوفك أمامه لكنه لا يتكلم/ يُثبت عينيه فيك ويُذبح”، يُدرك زياد أن ما يقوله ليس شعرا، فإنه لمن الترف المخزي بالنسبة له، أن تكون حالة فجائعية بل أقسى من الوصف كأمنية جندي، بتفاصيلها الدامية، هي للصور الشعرية والتوليف اللغوي الشعري، حالة لم يرها أو يسمع عنها بل عاشها، حتى أن رائحتها المرعبة لا تزال تبعث من بين الكلام، لذا فهو هاهنا لا “يشعرها” بل يترك تلك الصور بقسوتها، تخرج على هيئة كلمات عادية، تحمل في حروفها أصعب وأقسى وأحزن ما يمكن لإنسان نبت وعيه في نبع، أن يحملها كجثمان فوق ظهره، أينما ذهب أخذه، وحيث غفا وسهى، اتكأ عليه.
كان لهذه التجربة الوجودية الحارة والمضطربة، القاسية والمحزنة، الرهيبة والموحشة، أن تكون أكثر اكتمالا أو نضوجا في حال خرج الشاعر من أتونها ليكتب عنها من الخارج، بعد أن خاض تفاصيلها وخزّنها في ذاكرته إلى الأبد، لكن الوجع الذي تتقد ضفافه وتتالى مشاهده طازجة، لزجة، شديدة الوطأة، لم يكن على ما يبدو قادرا على احتمال استعادتها بصريا وذهنيا، نظرا للسياط المشتعلة التي تتركها على كل ما فيه، لذا أرخى قليلا ثقل هذه المرحلة الكثيفة الظلال عن كاهليه، ولا ريب أنه سيعود إليها يوما ليعيد تجميع ما تمزق وتناثر في روحه، بينما كان ينظر من نافذة مكشوفة للموت يدخن لفافة تبغه على النافذة المقابلة.
تمّام علي بركات