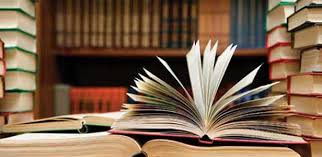سامحني يا أبي سأقتلك حبّا !
في المسرود الإنساني عموماً حظيتْ المرأة بمكانة عالية، وصلتْ حدّ التّقديس، خصوصاً في المرحلة الأموميّة من عمر البشريّة، ثمّ مع تبدّل مواقع القوى والسيطرة لصالح الذّكورة وتغيّر طبيعة المجتمعات وثقافتها، تدنّت مكانتها لتصبح ملحقة بالذّكر “أباً وزوجاً وابناً” ليبقي حضورها المعنوي عالياً شكليّاً، أشبه بحنين لماضٍ مغيّب في الذّاكرة الثقافيّة الشّفويّة والكتابيّة واللّاوعي الجمعي نتلمّس شذراته في الأمثال التاريخيّة، من عبارة “الجنّة تحت أقدام الأمّهات” إلى قول “حافظ إبراهيم” الشعري التربويّ “الأمّ مدرسةٌ إذا أعددتَها/ أعددتَ شعباً طيّب الأعراقِ” إلى الكلمة العاطفيّة الملحنّة التي تردّدها حناجر كبار الشّعراء والمغنّين كـ”مارسيل خليفة” أحنّ إلى خبز أمي وقهوة أمّي”، وسعدون جابر “الذي يتعلّم منها الصّبر ويصفها بأغلى وأعزّ المخلوقات”، إلى الأعياد الاجتماعيّة التي تُشيد بفضائلها “عيد الأم، عيد المرأة العالمي.. الخ”.. وهاهي حديثاً تستعيد مكانتها المهدورة تدريجيّاً على يد حركات التّحرّر النسويّة، بعد أن دخلت بكفاءتها العالية كل المجالات، لكن ماذا بشأن الأب المسكين؟.
حقيقةً، تُقتل الأبوّة أدبيّاً وثقافيّاً ونفسيّاً على المستوى الرمزي بلا رحمة، تحت شعار رُفِعَ يوماً من قبل دعاة القطيعة مع الموروث: “اقتلْ أباكَ وابدأ بالثّورة”، وما زال يُرفع بصيغ مختلفة وقائلٍ: (وإنّي وإن كنت الأخيرَ زمانِه/ لآتٍ بما لم تستطعْه الأوائلُ)، ومتقوّل: أن المجتمع العربي قبل الإسلام كان عبارة عن غابة لا قانون أخلاقياً يحكمها، يسبح أهلها في ضلالٍ مبين، حيث أتى الإسلام وأحيا كلّ شيء من أرض موات. هذا هو شأن الثّقافة المنتصرة فهي تجبّ ما قبلها كما يُقال. ولا نعترف بأنّ ثمّة خطى قد عبّدتْ الطريق من قبل. كما تؤكّد الدّراسات النّفسيّة بأن أغلب الذّكور يعانون من “عقدة أوديب وقتل الأب”، وهذا ما نجد صداه في الأدب والمجتمع والفنّ عموماً. هكذا، لا يكاد أحد يعترف بريادة أحد، ولو في المستوى التاريخي الزمني، ويعمد الكثيرون إلى التّغييب القسري لفعل التّراكم التّاريخي. فإذا نحن أمام نتائج دائمة تتنكّر بغباء لمقدّماتها، وريادات مستمرّة لا تعترف ببعضها وبدايات ومشاريع ثقافيّة نهضويّة مجهضة لا تكتمل، مع أنّه من البداهة أن أيّ تأمّلٍ نقديّ لهذه الرؤية المتشاطرة، سيثبت تهافتهَا وسقوطهَا بالتّأكيد أمام المعطيات والبراهين الدّامغة لمقولات الفكر المتجّدّدة دوماً. وهنا لا بأس أن نلقي الضّوء على مفهوم الشّطارة في ثقافتنا. تقول لغتنا العربيّة ممتدحةً الولد أو البنت بكلمة “شاطر وشاطرة”، مع أنّ الشّاطر في الأصل هو الذي شطرَ على أهله وانفصل عنهم، وتركهم، يقول “ابن منظور” في لسان العرب: “الشّاطر هو الأخذ في نحو غير الاستواء، لذلك قيل له شاطر، لأنّه تباعد عن الاستواء، ويقول “الفيروز آبادي” في القاموس المحيط: “الشّاطر هو من أعيا أهله خبثاً”!.
لنعد الآن، إلى فكرتنا الأساسيّة، وهي قتل الأب الرمزي، الذي يُشبّه بجريمة قتلٍ حقيقيٍ وثأر متعمّد من الآخر ومن الذّات أيضاً، ومن المشين تكرارها، يقول شاعرنا المعري “هذا جناه عليّ أبي/ وما جنيتُ على أحد”. ويقول شاعرنا “محمود درويش” في قصيدةٍ قديمةٍ نُشرَتْ في جريدة “اليوم السّابع” التي كانت تصدر في باريس، بين عامي “1984م و1989م” راثياً والده المتوفّى عام 1987م عنوانها “ونهاني عن السّفر”: “سامحني لأنّني لم أنجبْ لك حفيداً يفعل بي ما فعلتُ بكَ”، ويسترسلُ في القول: لا أحد يتذكّر متى تعرّف على أبيه، لا أحد يتذكّر متى تعرّف على أمّه، فلماذا أضرب قلبي بهذا السؤال: متى التقيتُ أبي لأوّلِ مرّة؟ لا أعرف إلّا اختلاط اللّيل والنّهار، ووجهاً يتردّدُ على لغة الأرض، لأنّ أبي لم يكن أبي بقدر ما كان أباً للنّبات والشّجر. كان أبي يزورنا في الليل، يزورنا لينام، ثمّ يوقظ الفجر، ويسوقه إلى الحقل.. الحقل كان بيتَه، والنباتات كانت أسرتَه، لذا كنتُ أظنُّ أنّ جدّي هو أبي، ونادراً ما كان يكلّمني، هل امتصّت الأرض عاطفتَه؟ كنتُ سعيداً بهذا الصّمت، سعيداً بهذا الإهمال، لأنّه لم يضربْنِي كما كانت أمّي تفعل، لم يضربْنِي مرّة واحدة، حتى حين أحنيتُ ركبتي وغرزتها في السّكين الضّخمة، لا لشيء، إلّا لأعرف إن كانت تجرح، ولأعرف إن كان الجرح يؤلم، كلّ ما فعله هو أنّه أخرج السّكين من لحمي الطّري، وناولني إلى أمّي. هل السّكينُ تجرح؟ هل الجرحُ يؤلم؟ كان عليّ أن أكبر أكثر لأتعرّف على أبي. لم يكن يُدرك أنّ الرّحلةَ هجرةٌ، فصار في حاجةٍ إلى الشّكوى والكلام، بعدما أُصيبَ بلفظة لاجئ، أبي جفّ فجأة. تيبّس كالشّجر المهجور، أبي مات هناك، أبي دُفنَ هناك في التّلّ المطلّ على مشهد حياته المنهار، فأين أموت يا أبي؟ سامحني يا أبي لأنّي لم أنجبْ لكَ حفيداً يفعل بي ما فعلتُ بكَ يا أبي! أبي الذي قال مرّة: الذي ما له وطن، ما له في الثّرى ضريح، ونهاني عن السّفر! سامحني يا أبي.
أوس أحمد أسعد