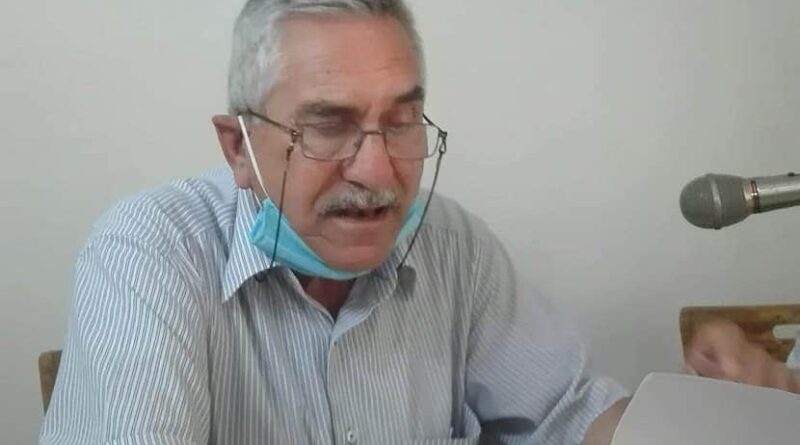وهم القطيعة الفكرية بين الماضي و الحاضر
عندما نقض نيكولاس كوبرنيكوس نظرية بطليموس التي تقول بمركزية الأرض ودوران الشمس حولها، وهي نظرية تبنّتها الكنيسة حينذاك، اعتُبر هذا الحدث من الناحية المعرفية حدثاً ثورياً بالدرجة الأولى، فقد حدث، بظهور كوبرنيكوس ومن بعده جاليليو، في المعرفة العلمية ما يطلق عليه (القطيعة المعرفية)، ويشير هذا المصطلح إلى لحظة يتحرّر فيها العقل من أسر مسلّمات وأفكار مسبقة اتخذت طابع القداسة. وقد تمّت القطيعة المعرفية بظهور نيوتن وكانط، ولكن ما كان لها أن تتبلور في صورتها النهائية إلا بفضل محاولات سابقين أرادوا الخروج من حلقة الفكر الماضي، ولم تكن الظروف مهيأة لهم لإحداث تلك القطيعة.
وحدثت القطيعة المعرفية مرة أخرى في أوائل القرن التاسع عشر، وبالتحديد فيما بين 1900 و1905، عندما دشّن العالم الألماني ماكس بلانك ميكانيك الكم، وتلاه إينشتاين بتدشينه نظرية النسبية الصغرى، وتغيّرت جذرياً النظرة إلى العالم، وأحدثت النظرية النسبية تصدعاً هائلاً، إذ لم يعد الزمان والمكان مطلقين كما كان يقول نيوتن وكانط، وإنما صارا نسبيين.
هذا المفهوم للقطيعة المعرفية نقضه الباحث عطية مسوح في محاضرته التي قدمها في اتحاد الكتاب العرب فرع حمص، ويضيف عليه القطيعة في مجال الفلسفة والأدب، فقد انطلق من مقارنة هذا المصطلح بمصطلحات مثل الحداثة وما بعد الحداثة، والبنيوية، وموت المؤلف، وموت النص، وغيرها، لكنه رأى القطيعة الفكرية أكثر وضوحاً في دلالته، لأنه يقدم معنى محدداً كما عبّر عنه المفكر الفرنسي غاستون باشلار على أنه تيار فكري أو اكتشاف علمي جديد لا علاقة له بأصوله السابقة.
وفي المجال الفلسفي يرى مسوح أن أهم اتجاهات الفلسفة تجلّت في أعمال الفيلسوف الانجليزي فرنسيس بيكون الذي عارض في كتابه “الأورجانون الجديد” أرسطو، رافضاً منطقه القائم على الاستنباط والاستقراء، المعروف بالمنطق الصوري لأنه لا ينظر إلى الهوية الواقعية للقضية المدروسة، بل يطبق الصورة الاستدلالية على الظاهرات في كل الظروف.
كما نقض معظم فلاسفة عصر النهضة المنطق الأرسطي، واقترن ذلك بتباعد المساحة بين الفلسفة والدين كما بين العلم والدين، فتعدّدت شروخ القطيعة مع الماضي وبدأت مرحلة جديدة من حلقات نقض المنطق الأرسطي، فأحلّ هيغل الجدلية محل الصورية، وجاء ماركس ليطور المنهج الجدلي المادي والتاريخي، ومن خلال التقدم الذي حققته الفلسفة على يدي بيكون وديكارت وماركس وغيرهم ضاقت أكثر فأكثر مساحة استخدام المنطق الصوري والمنهج القائم على المبادئ الثلاثة لأرسطو التي أصبحت جزءاً من تاريخ الفلسفة. وبالنسبة لفن السرد الروائي الذي تطوّر تطوراً هائلاً في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحالي لا يرى مسوح صوابية وجود رواية عربية جديدة مقطوعة الصلة برواية محمود تيمور ويوسف السباعي وشكيب الجابري وتوفيق عواد وغيرهم، حتى في الحلقات الأخيرة من تطور الظاهرة من دون النظر إلى ظهورها وتدرجها. الجديد عنده يتجاوز القديم، هذه هي ضريبة التقدم لكنه تجاوز إيجابي، يقصد به أن الجديد يمتصّ ويتمثّل كل ما في القديم من إيجابيات وما حققه من إنجازات ويقدمها بصيغة جديدة، أي أن التجاوز ليس مطلقاً والنفي ليس مطلقاً، التجاوز في مجال المعرفة لا يعني القطيعة المعرفية وإنما يعني التقدم المعرفي أي أن التجاوز تراكم وإضافة وليس إلغاء.
القطيعة المعرفية عربياً ربما كان المفكر محمد عابد الجابري أهم من استخدم هذا المصطلح في دراساته المتعلقة بالفكر والتاريخ العربيين، لكن تناغم الجابري مع هذا المصطلح جاء مضطرباً، فهو يقصد دعوته إلى القطيعة مع بنية عقلية لعصر محدّد وقد يوحي ذلك بالدعوة للعودة إلى ما قبله، أي أن القطيعة هنا ليست مرتبطة بالتقدم كما أرادها مطلقوها بل بنقض مرحلة شاذة والعودة إلى مرحلة أسمى كالدعوة إلى القطيعة المعرفية مع بنية العقل العربي في عصر الانحطاط.
وعلى مستوى نظرية الأدب والنقد الأدبي أخذ مستلهمو المنهج البنيوي يتناولون مصطلح القطيعة بوصفه مصطلحاً بنيوياً، وامتدت البنيوية التي هي منهج نقدي أدبي أساساً إلى فلاسفة بنيويين ونقد الفكر واختلفت طرق تعامل البنيويين العرب مع هذا المنهج، وحاول معظمهم الالتزام به وتناول النص الأدبي بوصفه بنية لغوية مغلقة منقطعة عن التأثر بما هو محتواها، بل منقطعة عن الخصائص النفسية والثقافية للمؤلف نفسه وعن البنية التي وجد فيها النص أنه عالم بذاته، بينما مال بعضهم للإفادة من معطياته في دراسة العمل الأدبي مع ربطه بالواقع الاجتماعي. والتفكيكية هي متابعة للبنيوية فكلاهما تنطلقان من أن النص هو مجموعة بنى مترابطة لكل منها شكلها في النص وتكوينها ودلالتها، أي كلاهما تدرسان النص بطريقة التفكيك والتحليل. أما المنهج الجديد الذي شكل رداً على البنيوية والتفكيكية فهو منهج النقد الثقافي الذي أعاد وصل النص بالخارج فلم يعد بنية لغوية مغلقة، بل هو وثيق الصلة بالثقافة المألوفة بتنوعها البسيط والعام وهذا المنهج هو أحدث مناهج النقد الأدبي.
ويخلص مسوح إلى أن مستخدمي مصطلح القطيعة المعرفية يعدون القطيعة تمنح الفكر المنقطع خصوصية مطلقة وتميّزه عن غيره، لكن وهم القطيعة المعرفية يولد أوهاماً سلوكية فردية وجمعية تؤثر تأثيراً سلبياً بالعلاقات الاجتماعية والثقافية، ويتعاظم هذا التأثير حين يمتد إلى المجال السياسي ويساهم في نسف العلاقات السياسية بين القوى المختلفة، ويحدّد أربعة أوهام فكرية وسلوكية يولدها هذا المفهوم وهي: وهم الانقطاع الاجتماعي ووهم الانهيار والانزلاق ووهم اليقينية ووهم التميّز.
آصف إبراهيم