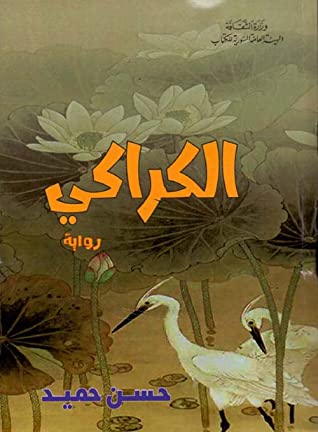المكان نجم النجوم في رواية “الكراكي”
يحتل المكان في أعمال الأديب حسن حميد الروائية والقصصية موقعاً متميزاً حتى يكاد يبدو هدفاً وغاية بحد ذاته، بدءاً من مجموعته القصصية الأولى “اثنا عشر برجاً لبرج البراجنة- 1983″، وليس انتهاء بالرواية الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب العام الماضي “الكراكي”، مروراً بجسر بنات يعقوب ومدينة الله التي تستوجب ألف قراءة حتى تنال حقها من الدراسة والتمحيص والنقد المحتفي بأهم عمل أدبي ينقل القارئ إلى القدس في رحلة أرضية وسماوية لكي لا ننسى فلسطين.
“الكراكي” أكبر من أن تكون رواية أدبية عابرة، إنها قفزة بارعة في تاريخ الوجع الفلسطيني، يحتل الوصف والسرد مكاناً لائقاً بالأمانة في نقل موجودات المكان، لاسيما طيور “الكراكي” التي جعلها الكاتب إخوة لعبودة، نجم الرواية الأول أو الثاني بعد الأب طنوس.
لم يستند الكاتب إلى الأبطال والأفعال الخارقة التي تؤهل شخصيات الرواية كي يكونوا أبطالاً بالمعنى التقليدي للبطولة، لكنه أفلح بكثير من الخبرة والحرفية العالية في جعل عبودة الشاب العاجز، وأمه، والكاهن، وابنته ماريا، وكل باقي شخصياته، ركائز وشواهد على عظمة المحبة بين الناس.
أم عبودة في صورة ما هي فلسطين التي غادرها زوجها (الدولة)، فصار همها رعاية ابنها ليكون خلفاً صالحاً لأبيه الذي لم نعرف عنه شيئاً، فنما وكبر وهو يظن أن الأب طنوس هو أبوه، ليقع في عشق ماريا التي تكبره كثيراً سبع أربعات، لكنه لم ينل مرامه ولم يهن أمام ذلك، بل راح يبحث عن ماريا كما لو أنها الحياة بكل مفردات استقامتها.
يبهرك في الـ “كراكي” أكثر من جانب حتى ما يبدو ممضاً أو قاسياً على النفس كالغياب وكان كثيراً في الرواية حتى تكاد الرواية أن تكون رواية الغياب، وبالتالي هي رواية البحث عن مفقود، وهل مثل الشعب الفلسطيني شعب عانى من الغياب والتفريق القسري، ومازال يبحث عن لم شمل وكيان ودولة، وباقي حقوقه بل أبسط حقوقه في العودة وتقرير المصير.
اللافت أن الروائي الكبير حسن حميد لم يطرح شعاراً من هذه الشعارات المطروحة، ومع ذلك كانت شخوصه أقدر على نقل الأفكار ووصولها للقارئ الحصيف.
أما الغجر وقصة فضة، وبحث الزهروري حبيبها عنها، فلم تكن مفصولة أبداً عن الكل المتكامل، وإن بدا الحديث عن الغجر صفحة ولا أجمل من الإنصاف لهؤلاء الذين يقول عنهم حسن ص 277: “هم أولاد الشمس، أولاد الطبيعة، أولاد الأزمنة، أولاد الريح لا يريدون الارتباط بمدينة أو قرية، ولا بجبل أو تل أو بحر أو واد، حياتهم معهم تمشي معهم وترافقهم، هم لا يرتبطون بموتاهم، ولا يعرفون المقابر الجماعية، أينما يموت الواحد منهم يدفن وتزرع بجواره شجرة أو أكثر، لهذا وأينما رأيت قبراً وبجواره شجرة قل هذا لغجري أو غجرية، حياتهم في غنائهم ومسراتهم وتنقلهم، إنهم يتخلصون من أعمارهم، ينفقونها في البراري والدروب كما لو أنها الريح”.
أما المكان في الرواية فقد ظل ساكناً غير متحرك، وهو مفتوح على وحدة القلب، فمن قرية (الصبيرات) تبدأ الرواية، وهي قرية على كتف البحيرة التي يقدم لنا الروائي ما لديه من معلومات تاريخية عن سبب تسميتها، ومن هذه المعلومات ما يدخل في المأثور من القصص والمنقول، وربما ما يحاكي به الأسطورة عن طب.. ريا أو نسبتها إلى الراهب طبريانوس، ولا يتعدى الخالصة وحيفا إلا إلى القدس فيفرد لها من درر الحروف وصفاً يليق بمدينة الله، ومن الأماكن إلى موجوداتها التي بين أيدي الناس، فحين يذكر نباتات الأرض لم يدع نبتة إلا وذكرها حتى لتظن أن الراوي كان يعمل عطاراً، أما الأشياء التي يحملها الجوال أو الحواج، أي البائع المتجول، فلدى الراوي معرفة تكاد تكون إحصائية.
ها هو يتوقف مع ما حملته أمه لتحضير الفطائر فيقول: “حملت معها صواني العجين والطبق وطاسات الطحين والزيت والزعتر وجبنة القريش وإبريق الماء وكوارة الأرغفة والبساط الذي تمده بالقرب من التنور، البساط الذي تسميه بالدثار”، هذه المنقولات عن الواقع الذي كان يعيشه الإنسان هناك ليست للزينة والتباهي، بل هي لبيان ماذا خسرنا هناك، حيث تختلط الوقائع بما كان يتناوله الناس بكثير من القداسة، حكايات تنعش الروح، وتدل على منسوب عال من الثقافة، يوم القمر، قصة المبروك يحيى، فدوة البحيرة، وفضة والبحث عنها ما يحتاج إلى التأمل والقراءة مرة ثانية وثالثة.. رواية تستحق المحبة لأنها تسعى إلى نشرها بين الناس.
رياض طبرة