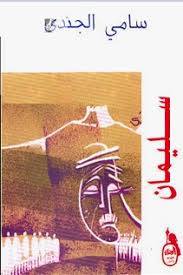“سليمان” قصة شعبية بلبوس الرواية
“نعم المدن صادقة لا تكذب أبداً، وأصدق المدن أكثرها فجراً”، الفقرة المأخوذة عن رواية سامي الجندي (1921-1995) “سليمان” الصادرة عن دار الجندي 1994، لا تتحدث عن مدينة “بيروت”، بل عن “مجيد آباد”!.
“مجيد آباد” ليست قرية من قرى بيروت، فهي تقع على أطراف الصحراء، خلافاً لبيروت التي تتوسّط الجبل والبحر، لذا من الطبيعي ألا تتلقى “مجيد آباد” التأثيرات التي تتلقاها بيروت كونها مدينة “كوزموبوليتية” مفتوحة على البحر والجو، على النقيض من مدينة الرواية التي تتلقى تأثيرات الصحراء، وما تدفعه إليها من قبائل وغجر وموروث يخبو لكنه كامن وجاهز للانبثاق مجدداً متى تأمنت له مقومات الانطلاق.
أولى مفارقات الرواية أنها تبدأ من بيروت، وتحديداً خلال الاجتياح الصهيوني لبيروت صيف عام 1982، فيخبر الراوي مشاهد متفرقة ومتقطعة من الحي الذي كان يحيا فيه في تلك المدينة المنكوبة بالحروب، من بينها بيته المحترق ومكتبته التي نُهبت، كما أنه لم يمت مصادفة، كما جيرانه الذين قتلوا فقط بما يشبه الحظ، مفضلاً الموت على الحياة في رفضه النزول إلى الملجأ، وعليه فقد بقي في المدينة، معلناً رفضه الفرار منها والانتحار، خصوصاً وأن اللاجدوى أو العبثية التي يحيا على إيقاعها، هي الدافع المحفّز له للإقدام على هذا الفعل.
وبما أن الموت لا يأتيه كما غيره بسبب موجات القصف المتتالية، فإن مرأى المسدس القابع ببرود على الطاولة أمامه يصبح مغرياً أكثر فأكثر بما راح يفكر فيه، إلا أن ثمة مسافة تفصل بين مشهد المسدس كأداة للانتحار، وبين فعل الموت، تلك المسافة هي عملية الضغط على الزناد، ولأنه لا يموت ولا ينتحر، كما فعل خليل حاوي ببندقية الصيد خاصته، يقرّر العودة إلى القرية التي تصبح فيما بعد “مجيد آباد”.
لا يتقدم الكاتب من المدخل الروائي الذي اختاره للعاصمة اللبنانية خلال ذلك الصيف الدامي، حتى أن القارئ وبعد عدة صفحات لا يلحظ وجود أي شخصيات تستمر باستثنائه هو، يحزم أمره ويقرّر العودة إلى قريته ليجد الإنكار في انتظاره، بمن فيهم رفيقة الطفولة، التي كانت تذهب معه إلى الكروم للقطاف، أول عاصفة تضرب جدران قلبه، شعوره بأن الناس في قريته فقدوا ذاكرتهم، وأن عيونهم باتت جوفاء، ومن هنا يبدأ القارئ دخول الرواية، من خلال شخصية الكاتب الذي بدأ يتدبر أمره وسط هذه الحالة، أي أن العالم الحكائي ينطلق من الراوي نفسه على غرار القصص الشعبية.
تصعيد الأحداث يبدأ فعلياً عند عودته، وهذا التصاعد الدراماتيكي في طبيعة الأحداث، يمهّد بدوره لما يليه، لكن تلك الأحداث لا تشكّل فن الرواية، وهذا ما يدركه صاحب “كسرة خبز”، ما دفعه للمزاوجة بين شخصه وبين البناء الحكائي، وربما لهذا تبدو كل فصول الرواية مشدودة لهذا المنهج، الكاتب كما يُخبر عن بعض أحداث الرواية يقول: “فتكم بالسالفة، قد لا تكون الفصول القادمة مطابقة للواقع، فأنا لم أشهدها ولم أشترك فيها، وإنما سمعت الذين عاشوها يروونها”، وهذا يعني أنه كان يتوقف عند بعض المحطات ليعلن موقفه كشاهد أو راوٍ، رغم أن معظم الأحداث مرتبطة بوجوده في صلب الحكاية!، لكن صاحب “صديقي إلياس” لا يقدّم رواية منفصلة عنه، فهو يقدم حكايته شخصياً وحكاية “السلميّة” مسقط رأسه، بعد أن غادرها فيمن غادر، عندما لم تقدم الحياة فيها كمدينة لناسها المقدمات التي لا بد أن يقبضوا عليها “كي يصيروا نسغاً في شجرة التاريخ”.
اشتغل الكاتب على رواية “سليمان” بأسلوب يجعلها بعيدة عن المناخات الفضفاضة على نسق الأعمال التي تعتمد التاريخ مسرحاً لها، محاولاً استرجاع مرحلة “التشكل” حيث الزمن الذي تمّت فيه مرحلة اجتياز تلك الوقائع، وبطريقة “الفلاش باك” يعود القارئ مع الراوي أو الشخصية، إلى لحظة البحث عن مفتاح البيت عند العودة، وشعوره بالألفة في منزل والده الذي ما زال على حاله لم يتغيّر، ثم يبدأ بالتعرف على “سليمان” الذي رافق “الحواة” حتى وصل إلى ملازمة شيخهم الأكبر، ليستقر به الحال تلميذاً عنده لـ 30 عاماً، تعلّم خلالها “كل شيء ولا شيء”!.
سليمان الذي حملت الرواية اسمه، والذي يخترق العمل من فاتحته “عودة الراوي” حتى نهايته، هو تكثيف لمأزق التشكل هذا، وهو لا يحيا وحيداً في المدينة، فمثله “شحود” الذي يريد إيقاظ الملحمة، في المدينة التي انعدمت فيها أبسط وسائل الحياة، إلا أن المدن تحيا تحولاتها التي يوردها الراوي في سرده، عندما يصبح اللص هو البطل، والبطل الحقيقي مدفون، حينها تصاب المدينة بمرضين أو جنونين، أولهما جنون الطوابير التي تنتظر تأمين ما تيسّر من خبز، والمرض الغرائبي الثاني هو “طق الناس” أو موتهم “فقعاً”.
إنها المدينة وانعكاساتها في الأزمات على طبائع الناس وشخوصهم، فالوجع يصبح بشاعة لا قبحاً.
جاءت رواية “سليمان” للمترجم سامي الجندي الذي ترجم ماركيز، إيزابيل الليندي، لويس، أراغون، مفكّكة، فالتوليف الذي تداخل في غضون حقبة زمنية طويلة، استغرقتها حياة جيله والنزاع النفسي الذي عاشه، أدى إلى ما يشبه قطعاً للخيط الناظم للعمل، خصوصاً وأن الرواية بالأساس تنتمي إلى القص الحكائي أكثر منه للفن الروائي، ما أدى إلى وقوع التباسات عديدة، عجز معها عن تقديم مأساة سليمان، وهكذا جاءت بنية الرواية السردية، متقطعة ومشتّتة في بعض الفصول، وكأنّ الكاتب يعتمد الشكل هنا ليصل إلى المضمون، فهذا الوضع المفكّك للعمل، هو نفسه ما يعايشه يومياً ويراه، لذا كان معنياً بعبثية الشكل الذي خبره وعاش تفاصيله، ليجعل منه المضمون، فواحدة من أهم نظريات النقد اليوم تقوم على فكرة أن الشكل هو المضمون، أو ربما كانت حالته المتشظية هي ما جعلته يظنّ أنه يصلح لأن يكون الراوي البطل.
تمّام علي بركات