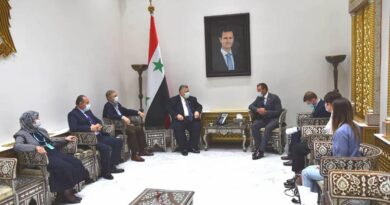إرث ترامب و”واترلو”.. الأمريكية
أحمد حسن
بكل المقاييس والمؤشرات المعروفة، نحن أمام “واترلو” بطبعتها الأمريكية، وذلك لأسباب متعدّدة، أهمها: حدة الاستقطاب السائدة في المجتمع الأمريكي، والتي وصلت إلى مسألة وجودية بمعنى نكون أو لا نكون، كما شخصية الرئيس الحالي الذي هو، بحسب “نعوم تشومسكي”، “أكثر من مهرّج وأقّل من مريضٍ نفسانيّ”.
وبكل المقاييس والمؤشرات المعروفة أيضاً، هذه “واترلو” العالم كله، بسبب استمرار الميلان الفادح لميزان القوة العالمية باتجاه واشنطن وحدها. بالتالي اليوم ليس يوم انتخابات أمريكا الرئاسية فقط، بل هو، بحقائق الواقع، انتخابات رئاسة العالم بأسره، وعلى الأقل هو اليوم الذي سيمتد تأثيره في الأيام والشهور والسنوات اللاحقة على مجمل سياسات بقية دول العالم، بل ومصيرها أيضاً، سلباً أو إيجاباً، مبادرة وفعلاً أو -وهذا الغالب الأعم- دفاعاً وردّ فعل بتفاوت ملحوظ في الحدّة والشدّة بين دولة إلى أخرى.
بتكثيف أكثر، اليوم يقف الجميع على قدم واحدة، يتساوى في ذلك قوى العالم الأول مع قوى العالم الثاني، والثالث، وما يلي من عوالم –وهنا يقبع العرب- مفعول بها.
بيد أن الاهتمام بهذا الشق الخارجي، أو الامتداد والتأثير العالميين للانتخابات، يكاد يقتصر على نخبة قليلة جداً، لكنه شبه غائب عن أجندات ملايين الأمريكيين التي لا تحفل، تاريخياً، إلا بالمسائل الداخلية، مثل البطالة، حق الإجهاض، حق حمل السلاح، الرعاية الصحية، الهجرة وسواها من أمور تشكّل، فعلياً، جوهر الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، اللذين يسيطران على الساحة السياسية، وبالتالي تتحوّل آلياً إلى بنود برنامجين انتخابيين واضحين ومتمايزين يحمل لواء كل منهما شخص محدّد في كل انتخابات رئاسية جديدة.
الانتخابات الحالية تكاد تخرج عن هذا المسار، لأنها لا تبدو، فعلياً، انتخابات بين برنامجين متمايزين، بقدر ما تبدو استفتاءً وطنياً، وعالمياً بالتالي، على شخص واحد ووحيد، ترامب، قبولاً أو رفضاً، وبالتالي فإن خسارته، إن حدثت، ستكون بسببه، وليس بسبب شعبية، أو برنامج، “جو بايدن” بالتأكيد.
هنا من المفيد التأكيد على نقطتين، أولهما: ضرورة عدم الركون إلى نتائج استطلاعات الرأي لترجيح اسم الفائز، كما لا يكفي الفوز بأغلبية أصوات الناخبين ليجلس المرشّح على الكرسي الشهير في المكتب البيضاوي لأن نظام الانتخابات قائم على ما يسمى بـ”المجمع الانتخابي” وفيه تترجم نتائج التصويت في كل من الولايات الأميركية باختيار ممثلين للولاية في هذا “المجمع” بعدد من الأصوات يوازي حجم الولاية السكاني ونسبة تمثيلها في الكونغرس، وفي هذا “المجمع” قد يُعطي الفوز لمن حاز فعلياً على عدد أقل من الأصوات الانتخابية، لكنه حاز على عدد أكبر من أصوات الناخبين الكبار. انتخابات عامي 2000، و2016 دليل بيّن على ما سبق.
النقطة الثانية: إن الخاسر قد يلجأ للمحكمة العليا، بدواع متعددة منها ادعاء التزوير، أو عدم احتساب أصوات أو..أو..، وذلك طريق يبدو أن “ترامب” عبّده لنفسه سلفاً، بعد أن نجح، وحزبه الجمهوري، في تعيين، آيمي باريت، في هيئة المحكمة العليا الأميركية، قبل أيام قليلة جداً من الانتخابات -وهو ما رفضوا مثيله وبشراسة للديمقراطيين في حالات سابقة- حيث بات المحافظون يتمتّعون الآن بغالبية الضعف، ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين.
بين قوسين كما يقال، ووفقاً للسوابق المعروفة وطبيعة الانقسام الحالي والتقلّب في الولايات المتردّدة والمرجّحة، راقبوا نتائج “فلوريدا” و”ميشيغين”، قد تكونان هما الحاسمتين في اسم الرئيس المقبل. لكن، هنا نعود للاستراتيجيا، أيّاً كان الفائز… الكارثة واقعة. الأسباب متعدّدة منها البنيوي، ومنها الشخصي المتعلق بـ”ترامب” ذاته، سواء بإرثه الاقتصادي الذي، حتى لو فاز “بايدن”، سيكون من الصعب احتواؤه على المدى المنظور، هذا إذا لم تمتدّ آثاره على مدى سنوات مقبلة، أو بإرثه العنصري التقسيمي الذي قد يدفع، في نهاية الأمر، بالأمريكيين للاحتكام للسلاح. مبيعات الأسلحة النارية ارتفعت إلى مستويات قياسية في بعض المناطق.
“توماس فريدمان” يقول: حتى تتعافى أميركا.. لا بد من “بايدن”. الوقائع تقول: إن الانحدار يتسارع، أما ما هو مداه أو توقيت نهايته، فذلك ضرب من التنجيم السياسي، لكن السوابق تقول: إن الامبراطوريات تكون أكثر خطورة في مراحل الانحدار.. سواء كان من يقودها “حماراً” أو “فيلاً”، فهم، وهي، يتحوّلان في هذه الحالة إلى نمر جريح..
بالمحصلة، ما نشهده اليوم هو الطلقات التمهيدية لـ”واترلو” جديدة، لكنها هذه المرة تُخاض على الأراضي الأمريكية، وإذا كانت الأولى جملة مفصليّة في كتاب تاريخ العالم، فإن الثانية، لأنها هنا، لا في أي مكان آخر، لن تكون أقل من صفحة، أو صفحات، مفصليّة فيما سيصبح تاريخاً جديداً في وقت لاحق.