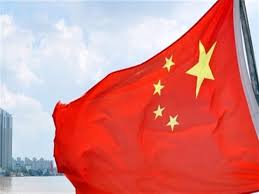الحاجة إلى استراتيجية جديدة للخطاب
* في مناسبة المؤتمرات السنوية لمؤسسات الحزب.
د. عبد اللطيف عمران
تفرض علينا متغيرات الحياة المتسارعة والمتنوعة لغة جديدة تختلف كثيراً في مفرداتها، ومدلولاتها، وأهدافها عن تلك التي كانت سائدة قبل ثورة الاتصالات والتواصل، وقبل استهداف الوعي والهوية والحياة الوطنية والقومية خاصة بعد عام 2010، ولا سيما أننا تأكدنا من الأثر السلبي الفاعل لتقنيات خطاب قنوات التضليل والاستهداف الإعلامي سواء أكانت مرئية (أثر فبركة الصورة) أم مسموعة أم مقروءة، سوشيل ميديا أم مراكز أبحاث ودراسات.
لذلك يتطلب الواقع المعيش اليوم (مخاطِباً) يكون مدركاً وعلى يقين -من أننا اليوم في عالم جديد يتلهّف الشارع فيه إلى متابعة الخطاب المغاير، بل المعادي أيضاً،، ومن أن أي موضوع سيتحدث فيه أمام الناس لن يكون جديداً أو غريباً عن ترصّدهم، إذ إنهم مدركون مسبقاً لحقائق عديدة تتصل بهذا الموضوع، ومن مصادر متعددة، ومتباينة أيضاً ما يجعلهم شركاء فاعلين في الخطاب من حيث تناول وتداول قيمته ومصداقيته وشفافيته، وقدرته على ملامسة آمالهم وآلامهم، فسرعة نقل المعلومة، وتعدد مصادرها، ووجود العين اليقظة -الوطنية أو المعادية في وقت واحد- التي ترصد تصرف المؤسسات ورجالها هي كلها، أمور تجعل المتحدث أمام تحديات متنوعة يجب عليه ويحسن به ألّا يتجاهلها.
نحن اليوم، لم نعد أمام بُنى جماهيرية تقليدية عرفناها فيما مضى، فلم يعد اليوم أحد يستسيغ التصفيق، ولا الفصاحة، ولا الصوت الجهوري، ولا حتى بلاغة الكلم. إننا اليوم أمام جمهور قارئ أكثر ممّا هو جمهور مستمع، جمهور ذو ثقافات، ومرجعيات متنوعة، ما يحتّم على المخاطِب، أو المسؤول التنفيذي أو السياسي أو الحزبي… الخ، أن يكون مسؤولاً بالدرجة الأولى عن وعي وظيفة خطابه واستراتيجيته، وقدرته على تحقيق الهدف المنشود منه.
لا شك في أن هناك كثيراً ممن يرى أن العصر الذهبي للأحزاب والإيديولوجيات قد ولّى، بل ودون رجعة، وهناك من يُقرّ بعدم وجود (عصر ذهبي حزبي)، وذلك لأسباب عديدة منها غياب (الكتلة التاريخية) -حسب مفهوم غرامشي- التي عرفناها في القرن الماضي، ومنها أيضاً أن خطاب المسؤول- أيّ مسؤول- لم يعدْ يحظى بمتلق واحد، بل بمتلقين متنوعين سواء أكانوا في المؤسسة الواحدة، أم الحزب الواحد، أم المجتمع الواحد، فالحياة الاجتماعية والمجتمعية في عالم اليوم لم تعد تنفع معها المعرفة السيسيولوجية السابقة. فأنت بحاجة عسيرة إلى القدرة على إقناع المخاطبين الذين هم عرضة لتأثيرات متباينة، كل حسب ألمه وأمله. فالأحزاب العقائدية تزداد معاناتها اليوم في قضايا الخطاب.
والحال هذه، لا بد من رصد أسباب ومظاهر عزوف الناس عن السائد في لغة الخطاب السياسي والتنفيذي والحزبي، قبل أن نعزو هذا العزوف إلى حالة من العداء، واللا وطنيّة، والشكوكيّة غير المسوّغة؟!!، فالأجيال الطالعة إلى الحياة تواجه تحديات يقينيّة في الجواب عن سؤال: من هو السبب؟!، وهي بسبب قسوة الحياة المحيطة بها، وضآلة مقاييس نوافذ الأمل فيها – ليس في هذه المنطقة من العالم فقط – لم تعدْ تستسيغ كثيراً لغة التعبئة الدارجة، وهي تنظر بعين الريبة إلى السجال المستدام بين سلطة الإدارة وسلطة المعرفة، سجال لا شك طالما كسبته الأولى منها – ترامب مثلاً -، حياة يجدر بالسياسي فيها معرفة توظيف نظرية التلقي في ضوء معطيات (النقد الثقافي).
خطاب الناس اليوم يحتاج إلى استراتيجية يكون المتحدث فيها قبل أي شيء (فنّاناً) في عرض الحقائق أمام الآخر، ينطلق في فنّه من صدق الإحساس بهموم الناس، ومن أنّ هذا الصدق هو الذي يؤدي بالخطاب إلى تحقيق وظيفته الوطنيّة المنشودة، هذه الوظيفة بوضوحها وشفافيّتها هي التي تعزّز الأمل والعمل والصمود (الصبر الاستراتيجي) في مجتمعات انتقل، بوضوح ودون مواربة، انقسامها من المحور العمودي (السياسيّ والاقتصادي)، إلى المحور الأفقي (المجتمعي والروحي). وهنا يجب أن يكون الخطاب وعداً تتطلع إليه الناس في هكذا ظروف.
مع هكذا انتقال، وهكذا أحوال لم تعدْ اللهجة الانتصارية مجدية، ولا الخطاب التمجيدي القافز فوق المنعكسات السلبيّة والأليمة للاستهداف الواضح بأدواته الإرهابيّة والنيوامبرياليّة المجرمة، والفاعلة للأسف بملاءات البترودولار، وتقنيّات الخطاب المعادي من الخارج التي صارت جماهير شعبنا وحزبنا وأمتنا، وكذلك حلفائنا وأصدقائنا الكثر تدرك بوضوح مخاطرها وجرائمها، وهي في الوقت نفسه على استعداد للمواجهة وللتضحية وللصبر على الشدائد -وقد استعدّت وفعلت ومازالت على مزيد من الاستعداد والقدرة على الفعل، والعمل الواعي على الانخراط في مهمّة تشكيل رأي عام داخليّ ووطنيّ مسعف وفاعل وبنّاء أيضاً في المسيرة المتواصلة لدحض مضار خطاب الإحباط واليأس الذي أوضح مخاطره السيد الرئيس في أكثر من مناسبة، ولاسيما في افتتاح الدور التشريعي الثالث.
فلا سلطة اليوم في الخطاب، بل شراكة في استراتيجياته، وفي تقنياته وأهدافه، فالخطاب المنشود اليوم هو القادر على حمل المشروع السياسي والاجتماعي والفكري، بعد توافر المنتصرين لأدبياته الوطنيّة: التنفيذيّة والحزبيّة.