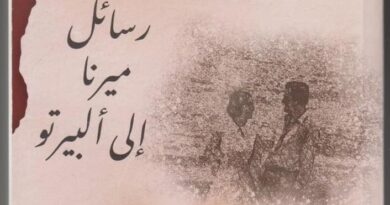الإرهاب حصان طروادة للمشاريع الأمريكية
محمد نادر العمري
مخطئ من يصدّق يوماً أن كلّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ سبعينات القرن الماضي تحارب الإرهاب الدولي وتكافحه، بل على العكس من ذلك، لطالما شكّل هذا الإرهاب بمختلف أشكاله وتسمياته، ذريعة لهذه الإدارات لتحقيق أجنداتها ومشاريعها على مستوى النظام الدولي، فهي التي تعاونت مع المخابرات البريطانية في ستينات وسبعينات القرن الماضي لتشكيل القاعدة في أفغانستان لإغراق الاتحاد السوفييتي السابق هناك، واستنزاف مقدراته وتهديد حدوده الجنوبية، وهي التي رفضت رغم كل الدعوات لوضع تعريف واحد ومحدّد وصريح للإرهاب في ثمانينات القرن الماضي بعد مطالبة سورية ودول عدم الانحياز بذلك، لأنها كانت تريد المزاوجة والخلط بين مفهومي المقاومة والإرهاب لتتمكن من استهداف أعدائها واتهامهم بالإرهاب لدعم المشاريع الصهيونية.
وحتى بعد أحداث 11 أيلول 2001 قسّمت أميركا في عهد جورج بوش الابن، بما يمثله من مصالح للبروتستانتية الغربية والمحافظين الجدد، العالم لدول الشر ودول الخير، ودول الإرهاب المارقة والدول المعتدلة المتماسكة، لتكون ذريعة لها لاحتلالها والتدخل في شؤونها وفرض الإملاءات عليها من خلال استخدام العصا الغليظة والتهديد باستخدام القوة. فقامت باحتلال أفغانستان ومن ثم العراق بذريعة نشر الديمقراطية، وهدّدت سورية بعد رفض شروط الإذعان التي حملها وزير الخارجية كولن باول، ودعمت “المعارضة الإيرانية” في أوروبا، ومن ثم وظفت ما سُمّي بـ”الربيع العربي”، وقامت بتهيئة الأجواء والظروف لنشر الإرهاب، لتعيد قواتها التي انسحبت من العراق إليها ولاحتلال أراضٍ داخل الجغرافيا السورية.
دعمت الإرهابيين بأشكال متعدّدة سياسياً من خلال منحهم الغطاء السياسي، ووصفتهم بـ “المعارضة المعتدلة” رغم خلو التاريخ الدولي الحديث والقديم والقانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية من مثل هذا المصطلح، ومن ثم أطلقت سجناءها لتوظيفهم ضمن معاركها العسكرية فتشكلت “داعش”، وسمحت للدول الغربية والإقليمية بنقل الإرهابيين إلى سورية والعراق حتى باتت هذه المنطقة تحتوي أكثر من 120 ألف تكفيري يحملون الفكر الوهابي، وفق تقدير “معهد كارتر” 2016.
ومع قدوم إدارة جو بايدن مطلع العام الحالي لوحظ انتشار وتحرك جديد للتنظيمات الإرهابية وخاصة “داعش” مجدداً في الصندوق المحدّد شرقي سورية، وبالتحديد في البادية امتداداً لغربي العراق الواقع في صحراء الأنبار وصلاح الدين، وهي مناطق يتخللها قواعد عسكرية في قاعدة عين الأسد والتنف، وهو ما يؤكد أن الولايات المتحدة في عهد بايدن عادت لذريعة محاربة الإرهاب لاستمرار بقاء قواعدها الاحتلالية في المنطقة.
وما يؤكد ذلك تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة بأن مهمّة هذه القوات في المنطقة هي محاربة الإرهاب، رغم أن الإدارة السابقة زعمت بأنها قامت بالقضاء على التنظيم بعد معركة “الباغوز” في عام 2018، وهو ما يضعنا في حقيقة واضحة وقائمة حول الاستثمار الأمريكي بالإرهاب ونفاقها المستمر للحفاظ على احتلالها للدول والمناطق. وقد تجلّى آخر صور هذا النفاق الأمريكي في مؤتمر روما الذي ادّعت أمريكا أنه سيجمع أكثر من 81 دولة لما سُمّي بدول التحالف من أجل محاربة “داعش”، فوجدنا أن هذا المؤتمر لم يستضف أكثر من 21 دولة من جانب، ومن جانب آخر كان يهدف لمنح واشنطن الغطاء لبقاء قواتها في المنطقة بذريعة محاربة “داعش”. فمشاركة 21 دولة فقط من أصل 81 هو إقرار واقعي من قبل الدول بأن “داعش” هو مجرد خديعة وواجهة تستغله أمريكا، التي لم تترك وسيلة وخدعة كاذبة إلا ووظفتها للبقاء في المنطقة، ويظهر مرة جديدة أن عودة نشاط “داعش” تمّ بقرار أمريكي تمثل في إخراج عناصر “داعش” من سجونهم بعد أن تمّ تدريبهم في التنف للقول بأن مهمتنا في المنطقة محاربة الإرهاب.
بالعودة للسياسة الأمريكية نجد أن كل محدّدات سياساتها الخارجية منذ سقوط الاتحاد السوفييتي كانت تتمثل بذريعة إيجاد المبررات لتوسيع نفوذها، فهي التي ضغطت على الحلف الأطلسي 1991 لوضع الإسلام السياسي ضمن المخاطر التي تهدّد الحلف، وذلك من أجل إيجاد عدو افتراضي للادّعاء بمحاربته، وفي الوقت نفسه بدأت بإنعاش المجموعات الإرهابية ونسبها بالشكل للإسلام حتى وصلنا أخيراً للصيغة المعدلة هجينياً عبر “داعش” و” النصرة” وغيرها من المسميات، التي هي اليوم نواة ثلاثة أجيال من الإرهاب، الذي أوجد في أفغانستان وتطوّر للقاعدة، وتحوّل لما هو عليه اليوم، وكل ذلك بإشراف ومباركة وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومذكرات الرؤساء الأمريكيين مليئة بالشواهد، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وحتى تصريح ترامب عندما اتهم إدارة باراك أوباما التي كان بايدن ركناً أساسياً فيها بإيجاد “داعش”.
هذا كلام ترامب وهذه مذكرات كلينتون، وهناك المئات مما يؤكد بأن الإرهاب هو مجرد حصان طروادة للمشاريع الأمريكية!.