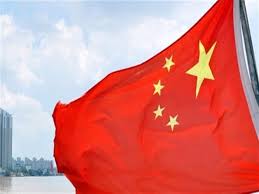الموت الاجتماعي
غالية خوجة
ماذا لو مات الموت؟..
هذا السؤال عنوان مخطوطة روايتي التي تأخذنا إلى ذاك العالم بعيداً عن الموت إلى حياة لا تتسم بالموت ولا الخلود!.
ولأن الموت بوابة تتفرع إلى عدة دروب وحيوات أخرى وتصنيفات وأنواع، منها الموت الفيزيولوجي الجسدي الذي سيصيبنا جميعاً، ومنها الموت النفسي، الروحي، الأخلاقي، المعنوي، والموت الاجتماعي الذي يموت فيه التراحم والتعاطف والذي تكاثر في زمننا المعاصر لأسباب عدة، منها الوباء العالمي والحروب الظالمة والحصار الاقتصادي.
ولننهض بوعينا التراحمي، بعيداً عن التفكك الأسري والاجتماعي، لا بد أن نعيد لضميرنا الإحساس الوجداني بالآخرين، فنبتعد قليلاً عن الأنا الأنانية، لنمنح الدائرة الأسرية حقها، ثم الدائرة الأوسع في بنيتنا الاجتماعية فالأوسع، خصوصاً لهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الوحدة والمرض أو من كليهما معاً.
ماذا لو كنّا مكان أم أو أب أو أخ أو أخت أو ابن أو صديق أو زميل، وليكن سين من الناس، وهو مريض، أو بلا معارف، أو انعزالي وانطوائي؟.
التشاركية في المودة والعمل على هذه التشاركية أحد أعمدة النقاء الإنساني والبقاء في الدائرة الإنسانية، لأنها تخفّف من آلام الإنسان طفلاً، أو شاباً، أو عجوزاً، سليماً، أو مريضاً، مما يجعله يشعر بالطمأنينة والألفة والتضامن الاجتماعي، فيطرد الطاقة السلبية، ويحرق الكآبة، ليبدأ المؤشر الإيجابي بالتحرك صعوداً إلى الأعلى، مما يساهم في التحولات الداخلية والسلوكية والتعبيرية للإنسان، فتستعيد الملامح بشاشتها، والروح إزهارها، ويشرق القلب من جديد.
المحبة والتراحم مسافة لا بد منها بين الناس، لأنها الأكثر ضرورية وضرورة في المحن والمرض والحروب والجوع والحصار، لأن هذه الظروف تظهر إنسانية الإنسان أكثر، فيزداد فرحاً لأنه يؤدي رسالته الاجتماعية بوعي مفيد ومتعاون ولطيف ومنتج وموجب.
وفي هذه التراحمية فضاء لا ينضب يصوغ الذات والآخر والمدن بأسلوب شفيف شفاف، ويمنح اللحظة الحاضرة والقادمة أملاً، ويشجّع على المزيد من العطاء، مما يساهم في صياغة المجتمع ببريق أجمل من الذهب وأكثر إضاءة من الماس وأكثر بقاء من الشمس.
وحوالينا الكثير من هذه النماذج المضحية بوقتها وأعمارها وأناها من أجل سعادة الآخرين، وهذه الفئة تمثل الجنود المجهولين في حياتنا، لأنها توقن بفاعلية مبدئها “رأس الحكمة مخافة الله”.
وبالمقابل، هناك فئة تقف على الضفة النقيضة، همّها الأساسي افتعال المسافات بينها والآخر، خشية على ذاتها من الآخر، فيضمر الوعي التراحمي بينما تتسرطن الأنانية التي لا تلبث أن ترتد عكسياً على أصحاب هذه الشخصيات، مما يجعلها مصابة بالكآبة وفرْط السلبية والعدوانية والتنمّر والإيذاء، وهي بذلك تعبّر عن ضعفها الكامن في اللاشعور، لأسباب عديدة ومختلفة، منها عدم الثقة بالذات، والآخر، والانطواء على الذات وتضخيمها مثل فقاعة صابون قابلة للانفجار في أية ثانية.
للإنسان أن يضع نفسه في أية مسافة يريدها، وأن يسأل نفسه عن نموذجه الداخلي المتفهرس، بكل تأكيد، من أسلافه، وهذا ما أدركه بورخيس عندما قال: “أنجب أسلافي”، وهذا ما يؤكده علم الوراثة والجينات، وله أن يختار من خطوط العرض والطول والارتفاع لوعيه وضميره وروحه ما يشاء من مسافات، لأنه، بالتالي، يختار أثره الذي سيبقى منه في مكانية الزمان وزمانية المكان، وهذا ما أدركته العديد من الشخصيات المؤثرة، ولا أعني المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تلك التي تبثّ سمومها، بل أعني المؤثرة في التأريخ الإنساني وعبْر الحقب والعصور، ومنها يوسف العظمة، عمر المختار، ابن النفيس، الرازي، ربيعة الرقي، ابن بطوطة، الأم تيريزا، غاندي، مانديلا، وجميعها أيقنت أن البغضاء موت ولا أحد يحب أن يكون الكفن.