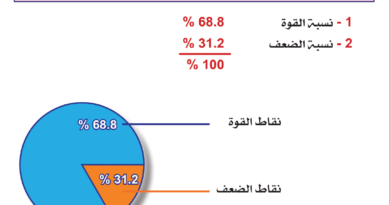أزمة كازاخستان … أردوغان خاسر أيضاً
البعث الأسبوعية – أحمد حسن
حتى الآن الرابح الأكبر من أحداث كازاخستان هو روسيا، التي وضعت بالنتيجة التي آلت إليها الأحداث حركة المرور، السياسية والاقتصادية، في منطقة استراتيجية كبرى مثل آسيا الوسطى تحت سيطرتها الكاملة، بالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي حكماً الخاسر الأكبر، وهذا صحيح، لكن هناك خاسراً كبيراً آخر هو النظام التركي وعلى رأسه السلطان ذاته.
مقدّمات ونذر الكارثة!!
عام 2014، وفي محاولة لتبيان أهمية كازاخستان في السياق العالمي قال رئيسها السابق، نور سلطان نزارباييف، إن بلاده لديها “ثلاثة جيران كبار: الصين وروسيا والولايات المتحدة كجار افتراضي”.
في تلك المرحلة كان الجارين الحقيقيين، موسكو وبكين، في مرحلة بناء قوة أو استكمالها، استعادة لدور سابق أو بحثاً عن لاحق. بكين كانت، ولا زالت، تبني ببطء لكن بدأب وإصرار طريق حريرها المستقبلي. موسكو بدورها كانت تتكأ، دبلوماسياً حتى تلك اللحظة، على القضية السورية لبناء جدار أمنها الاستراتيجي ضد الغرب. وحده الجار الافتراضي، أي واشنطن، كان من بين من ذكرهم نزار باييف ينسج شباكه بقسوة في المنطقة ليكمل غزل “دول الطوق” الروسي، وكازاخستان واحدة من أهم عناصر هذه المنظومة.
ولسبب ما، ربما يكون قلة اكتراث أو خطأ في القراءة الاستراتيجية، تجاهل الرئيس الكازاخي الجار التركي الذي اتضح لاحقاً أن أطماعه، وأنيابه، امتدت نحو الحديقة الخلفية الروسية بعد أن تحوّل تحت وهم فائض القوة واللحظة الاستراتيجية الدولية المناسبة، وكعادة أطراف المنظومة الإخوانية، من دبلوماسية “صفر مشاكل” في مرحلة التمسكن، إلى مأزق “صفر علاقات” بعد فجور وانفجار فقاعة مرحلة التمكن.
“من الأدرياتيكي إلى سدّ الصين”
وهكذا، وضمن وهم “أستاذية العالم” الإخواني المعروف، وبعد سورية ومصر وتونس وحلم استعادة زمن “الباب العالي”، سعى أردوغان لركوب موجة القومية التركية وإحياء شعار الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال الذي اطلقه عام 1991 “أمّة تركية واحدة من الأدرياتيكي إلى سدّ الصين العظيم”، فأعلن منذ أسابيع قليلة ماضية من مدينة إسطنبول، برمزيتها التاريخية ولادة مشروع “منظمة العالم التركي” التي تضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزباكستان، إلى جانب تركمنستان والمجر اللتين تحملان صفة مراقب. ومن أهدافها التحوّل إلى كيان ذي حضور دولي وازن.
هنا تبرز كازاخستان بمساحتها الكبيرة وعدد سكّانها الضئيل –ونسبة من هم من العرق التركي كبيرة جداً بينهم حيث تبلغ 70%- بوصفها الدولة الأبرز في هذه المنظمة بالنسبة إلى أنقرة، خاصة بوجود استثمارات تركية كبيرة فيها، “هناك 400 شركة تركية تعمل في كازاخستان، نفّذت إلى الآن مشاريع بلغت قيمتها 16 مليار دولار، وتوجد أيضاً اتفاقيات أخرى بين الجانبين قيد التنفيذ”.
اجتماع السبب الاقتصادي مع السياسي مع حلم الخلافة الشخصي في “منظمة أردوغان” هذه، يجعل من إمكانية نجاحها زلزالاً كبيراً يؤدي إلى خلخلة ثوابت جيوسياسية واستراتيجية مستقرة منذ فترة طويلة في المنطقة بأكملها، وتحديداً في جوار روسيا والصين أيضاً، بل في داخلهما معاً.
الدور الأمريكي
هنا، وربما دون تنسيق مع التركي، بل وقبله أيضاً، بدأت واشنطن اللعب بالمنطقة ذاتها في محاولتها الدؤوبة لحصار روسيا بالطوق “الناتوي” –حدودها مع كازاخستان بطول حوالي 7000 كلم- والتأثير في الداخل الصيني -حدودهما المشتركة بطول 1500 كلم ومعظمها يتاخم إقليم “تشينج يانغ” أو “تركستان الشرقية” حيث يقطن الإيغور– بما يجعل من كازاخستان صاحبة مكانة كبرى في مشروع “الحزام والطريق”، ومكان مثالي أيضاً لإجهاضه واللعب مع موسكو وبكين.
وبالطبع لا بد من التفتيش عن الاقتصاد في كل أزمة كبيرة كانت أو صغيرة، فكازاخستان التي تعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وثاني دولة في تعدين العملة الرقمية “بتكوين”، تطلّ أيضاً “على بحر قزوين الغنيّ بالنفط والغاز، ولها الحصّة الكبرى منهما لأنّ الجزء الأكبر من الشواطئ القزوينية هو كازاخيّ (2340 كلم)”، كما أنها مجال واسع للشركات الأميركية “مثل شركة شيفرون التي تتحكّم بـ50% من حقل “تنغيز”، أكبر حقل نفطي في البلاد، الذي يُسهم لوحده بثلث الناتج المحلّي (700 ألف برميل يومياً)، وتملك شركة إكسون موبيل الأميركية 25% منه”.
وحيثما كان لـ “شيفرون” وشقيقاتها حصة أو رغبة في حصة فإن الدماء والاضطرابات ستكون من الأمور “الطبيعية” والمعتادة.
الرد الروسي
بيد أن كل ما سبق عرضه من أطماع وأحلام سقط كله، حتى الآن، ضحية سرعة رد القيادة الروسية على طلب كازاخستان بالتدخل، وبالتالي نجاح موسكو في تحويل “الأزمة الكازاخية” إلى “فرصة لتعزيز نفوذها في المجال السوفياتي السابق”، حسب “نيويورك تايمز”، عبر تأكيد استعدادها الكامل والسريع لمجابهة كل المخاطر وتثبيت خطوطها الحمراء في وجه الجميع، وذلك درس تعلمت موسكو، بلحمها الحي، ضرورة استيعابه من سنوات يلتسين التعسة.
والحال فإن “بوتين” في تدخله السريع، والشرعي هذا –وهذا أمر ذي دلالة هامة جداً-، وجه أكثر من رسالة للجميع، أولها للغرب وأمريكا تحديداً حول جهوزه لحماية حدوده الاستراتيجية، وثانيها لكازاخستان ذاتها -التي حاولت نخبتها السياسية والاقتصادية التوجه غرباً في المرحلة الماضية- بالقول إن موسكو هي وجهتهم الوحيدة والصادقة، أما الثالثة فهي لمشروع “العالم التركي” وأردوغان معاً، فليس عابراً أن “منظمة الأمن الجماعي” التي تضمّ جمهوريات تركية تدخلت تحت عباءته، وبالتالي له فيها حصة وازنة، وبذلك يكون قد وجه ضربة كبرى لـ”لعبة المعادلات التركية الإقليمية الجديدة” في المنطقة.
خلاصة القول
بوتين هو الرابح الأكبر حتى الآن، الاعتراف جاء من الجميع، وكان من اللافت إعلان دول “منظمة العالم التركي بعد سيطرة موسكو على الموقف، دعمها السلطات الشرعية في كازاخستان وتجديد الوقوف إلى جانبها”.
لكن، يجب الحذر في التحليل وبالتالي الحرص على عبارة “حتى الآن”، لأن الملف الكازاخي فُتح على آفاق عدة لا يعرف أحداً نهايتها، ما نعرفه فقط أن الإصرار الروسي على الخطوط الحمراء حقيقي وجدي، و”صبر موسكو بدأ ينفد” من محاولات الغرب اللعب بها وعدم احترامها حسب ما قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الجمعة الماضي، وفي ذلك تهديد واضح في عالم السياسة الدولية المعقد، فهل يسمعه أردوغان أيضاً ويفهمه، أم سيستمر في أحلامه وأوهامه القاتلة.