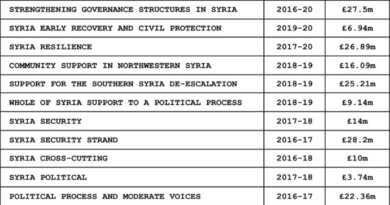الحنين لرائحة الورق والزمن الجميل
البعث الأسبوعية- جمان بركات
للورق رائحة عطر نفاذة وصاحبة سطوة، حنين الأدباء أبداً في وقتنا الحالي يكون لعوامل وطقوس كثيرة كانت تربطهم بالكتاب ولعل أهمها بل وأبرزها هو رائحة وعبق الورق المعتق، وتختلف طرق البوح والتعبير عن هذا التعلق من أديب إلى آخر، ولعلنا كلنا نجزم أن هذه السمة -سمة الحنين لرائحة الكتب- باتت حال الجميع في عصر التقانات والتكنلوجيا لكننا نحن ونشتاق لملمس الورق ورائحة الكتب وصمغ التجليد المعتق الممتزج بسللوز الورق القديم، وفي زحمة غياب الورق كانت مشاهد عديدة في الدراما السورية القديمة كفيلة بإعادة الحنين للورق والصحف، وأنها مازالت تحتل مكانة رفيعة في قلوب الكثيرين، وهذه المشاهد جعلتنا نطرح السؤال: هل بالفعل اشتقنا للورق؟ ومع هذا السؤال كان للبعث الأسبوعية هذه الوقفات مع بعض الأدباء لنسبر أغوار تلك الرابطة بين قريحتهم وبين رائحة الورق.
ويبقى الحنين
“ويبقى الحنين” بهذه الكلمات بدأت الإعلامية سلوى عباس كلامها فقالت: أنا من جيل عاصر الكثير من وسائل التواصل التقليدية كصندوق البريد حيث كان ساعي البريد صديقاً حميماً ينقل لنا رسائل أصدقائنا ومحبينا، رسائل كتبت بمداد الروح، كما عاصرنا مسجل الصوت والراديو والكاسيت وجهاز التلفزيون بقنواته الأرضية وبرامج الأبيض والأسود وغيرها من وسائل تواصلنا مع بعضنا ومع العالم التي لم نتوقع لحظة أن تصبح جزءاً من التراث.
أيضاً أنا من جيل اكتسب معرفته الثقافية والإنسانية من الصحيفة الورقية والمجلات والكتاب وليس من الانترنت الذي لم يكن متوفراً في زمني، وحتى الصحافة هذه المهنة الجميلة التي امتهنتها والتي سحرني حبرها وملمس ورقها ورائحته العطرة كانت على مر سنوات طويلة جزءاً لا يتجزأ من الطقوس الصباحية اليومية لكثير من الناس، وغذاء ثقافي روحي يومي دسم بالأخبار الجديدة والمثيرة فنقرأها بتأن بأي وقت ونحن في حالة استرخاء بدلاً من أن يأسرنا جهاز ما، إضافة لأرشيف المقالات التي كنا نحتفظ بها والذي شكل ذاكرتنا وذاكرة أجيال عديدة يعيدنا الحنين إليها دائماً، كما كانت هتافات بائعي الصحف “جرائد.. جرائد..اقرؤوا أحداثاً مثيرة ومهمة” تطرق أسماعنا بكثير من الشغف لقراءتها في زمن كانت الصحف والمجلات الورقية المنصة الأولى للإعلام والتي تراجعت أمام مد الانترنت والثورة الرقمية التي اختصرت مجمل حياتنا، ووفرت لنا بكبسة زر كل ما نحتاجه من معلومات وكتب وغيرها، وكان التحدي الأكبر لها تفشي وباء كورونا الذي لعب دوراً كبيراً في اتجاه الناس إلى الإنترنت كوسيلة أسهل وأسرع في إيصال المعلومة، مما أدى لتوقف الصحف والمجلات الورقية في العالم كله، فاختفت مهن كثيرة تتعلق بالطباعة وظهرت مهن أخرى جديدة تتماشى والتطور التكنولوجي الهائل لوسائل الاتصال الحديثة التي اجتاحت العالم، لكن نبقى نحن الصحفيون والمحبون للصحف والمجلات الورقية وشغفهم بعطر حبرها وورقها نحن للذكريات وملمس الورق ورائحة الحبر فالمقال في الصحيفة الورقية بتوقيع اسم صاحبه يمثل جزءاً من تاريخه الإنساني والشخصي وثقافته الذاتية، كما أنها الأقدر على تشكيل الرأي العام الواعي، وهي التي تحمي من الزيف وتناسب كل الأعمال وتشكل مصدراً أوثق للباحثين، ومع كل التحدي الذي تعيشه الصحافة الورقية يبقى لدينا الأمل بأن تتجاوز كل التحديات وتعود، ويبقى حنيننا إليها متأصل في ذاكرتنا ومكمّل لها، وهو نافذتنا المهمة في جدار الحاضر المقيت المحيط بنا.
رائحة الكلمة
وللكلمة رائحة أيضاً، هكذا عبر الكاتب طلال حسن من العراق، وتابع بالتعبير: ليس للزهرة الأولى، التي تتفتح في أعماقنا، رائحتها الخاصة فقط، وليس فقط للطفولة، التي نعيشها عمراً ثم إبداعاً، رائحتها المتميزة، فللكلمة، وخاصة الكلمة المكتوبة على الورق رائحة سحرية، مدوخة، لا تنسى، ناهيك عن الكلمة الأولى، إن لها رائحة الطفل الأول، الذي يزين حياة دنيانا.
ولعل كلّ عاشق للكلمة، ولاسيما المطبوعة منها، يثمل برائحة الكلمات المطبوعة على ورق الكتاب الجديد، حين يفتحه لأول مرة، وبالأخص إذا كان هذا الكتاب من خلقه وإبداعه، فهو يتنسم أطيب رائحة في العالم .
إنني أكتب منذ أكثر من خمسة عقود، ويكفي أنني كتبت في مجلة الأطفال السورية “أسامة” و”شامة”، كما نُشر لي في سورية 7 كتب خمسة منها عن اتحاد الكتاب العرب.
ورغم هذه السنين، فإنني مازلت أثمل عندما أشم رائحة كلماتي المنشورة على أوراق مجلات الأطفال، التي أنشر عليها في مختلف أقطار الوطن العربي، صحيح أنني أنشر معظم ما أكتبه الآن على المواقع الالكترونية، لكن هذه المواقع على أهميتها، لا تعطيني نفس الرائحة المفعمة بالحياة والعذوبة، التي تعطيني إياها الكلمة المطبوعة على الورق.
ثُنائيّة العِطر
وتذكر محمد جمال عمرو من الأردن لقاءه الأول مع الورق حيث قال: أذكر تماماً متى كان لقائي الأوّل بالكتبِ وأوراقِها، كنتُ حينها في يومي الدّراسيّ الأوّل، ألبسُ الزيّ المدرسيّ، وأحمل حقيبةً فارغة إلا من قلمٍ ومِمحاةٍ ومِبراةٍ ومَسطرة، كنتُ أمسكُ بيدِ شقيقيَ الأكبر، وندخلُ معاً بوابةً كبيرةً لبنايةٍ أسوارُها عالية، علمتُ فيما بعد أنّها مدرستي التي منها سوفَ تنطلقُ مسيرتي التعليميّة.
تركَني شقيقي في ساحةِ المدرسةِ بينَ أطفال في مثلِ عُمري، تفحّصتُ وجوهَهُم فلمْ أعرفْ منهُم أحداً، وسرعانَ ما قُرعَتْ أجراسٌ، وجاءَ رجالٌ علمتُ لاحقاً أنّهم مُعلّمونا، أدخلونا الحُجراتِ الصفيّة، ووزّعوا علينا كُتباً عدّة: “إنّها الكتبُ المدرسيةُ” هكذا قالَ مُعلمُنا حينَها، وقالَ بعدَ ذلكَ كلاماً لمْ أنتبهْ لكثيرٍ منهُ، ذلكَ أنَّ حاسّةَ الشَّمّ عندي غلَبتْني وتغلّبتْ على قراري، فانجذبتُ إلى رائحةٍ أشمُّها للمرّةِ الأولى في حياتي، إنّها رائحةُ الكُتب، وعبيرُ أوراقِها المصقولةِ الملوّنة، التي أشعلتْ حاسّةَ البصرِ عندي بعد أن تملكَتْ حاسّةَ الشَّمّ.. إنّه اللقاءُ الأوّلُ الذي امتدَّ معي طيلةَ عُمري تلميذًا في المراحلِ الدراسيّة، ومُديراً لدارِ نشرٍ ومطبعتِها، ورئيسَ تحريرٍ لمجلاتٍ عربيّةٍ عِدّة، ثمَّ مؤلّفاً كتبَ للأطفالِ أكثرَ منْ مئينِ وخمسينَ كتاباً، تنوّعَتْ بينَ الشّعرِ والقصّةِ والمسرح.
قالَ لي طبيبٌ ذاتَ فَحصٍ: في دَمِكَ بَصمةٌ دامغةٌ تفوحُ منها رائحةُ الكتبِ وعبيرُ الورق.. لا دواءَ لكَ عندي.
نوستالجيا
وكان لا بد من اختيار أحد الشبان من الأصدقاء للإدلاء برأيه عن الورق وعلاقته بها، حيث استرسل أحدهم بالقول: اخترعت الصين الورق في العام ١٠٥ ميلادي وكانت مكوناته الأساسية هي لحاء الأشجار، الأقمشة وشبكات الصيد، هذا في ما يخص الورق المتعارف عليه، أما الكتابة فجذورها طويلة ترجع إلى الدولة السومرية حيث الكتابة المسمارية وفيما بعد الكتابة الصورية الهيروغليفية في مصر القديمة.
مما لا شك فيه نحن نأسى على ذوبان الكتابة بشكلها المعتاد مع هذه الثورة التكنولوجية الالكترونية الكبيرة، فمن منا لا يشتاق إلى رائحة الجريدة ورومانسية الجريدة وارتباطها بأغاني الصباح والمشروبات الساخنة، ومن منا لا يحن إلى زمن الكتب المرصوفة في المكتبات والرفوف وجمال ألوانها ومواضيعها ورائحتها إذا كان الكتاب صديق وحدةٍ ومنهل علم وأدب وثقافة وأحد أركان صورة أبطالها ضوء المنضدة وفنجان قهوة وبالطبع كتاب، فهو تاريخنا ومصدر خيالنا وصفحة أولى كتب عليها إهداء، وهو كذلك مطفأة للذاكرة كما تصفه الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي وبالانتقال من جزئية الكتاب إلى عموم المطبوعات فالحديث ذو شجون أكبر وحنين، فقد شكلت المجلات والجرائد والكتب ذاكرة شعوب وأخبار أهلها وعناوين لكفاحها وأحزانها وأفراحها فكيف أمسى ذاك المقدار الكبير خبراً لأبراج الحظ وإعلانات المشمولين بالتعيينات الحكومية والوفيات اليومية؟!
وإن كنا نستعرض الأمر بعاطفة كبيرة لا يمكن أن نبتعد عن الموضوعية، أي الأمرين أكثر سهولة قراءه مجلد كبير للحصول على معلومة ما أم الذهاب مباشرة إلى محرك البحث غوغل للحصول عليها بشكل مباشر وسلس؟
سؤال كهذا يمنعنا من أن نجحف حق التكنولوجيا ومحاسنها وفضلها علينا، إذاً لنكن عادلين وموضوعيين ونحافظ على هذه وتلك، ففضل التكنولوجيا على العقل ونوستالجيا الكتاب في الوجدان والذاكرة وبالتأكيد قادرين على الحفاظ عليهما والتوفيق بينهما.