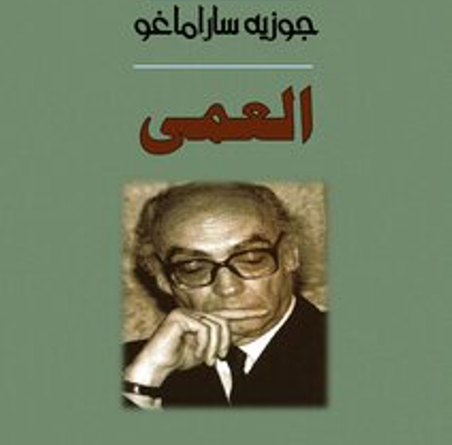بين دفتي الرواية.. “العمى عمى البصيرة”
ليندا تلي
“أضاءت الشارة الخضراء وانطلقت السيارات بسرعة، إلا سيارة في منتصف المضمار لا تزال واقفة.. سائق السيارة يلوّح بيده من خلف زجاج السيارة الأمامي، يتلفّت يميناً وشمالاً.. بدا واضحاً أنه يصرخ بشيء ما، ومن حركة شفتيه بدا كأنه يكرّر بضع كلمات”، بهذا الحدث الأساس بدأ “جوزيه ساراماغو” روايته “العمى”، حيث كان السائق يردّد يائساً: “أنا أعمى.. أنا أعمى”، وهم يساعدونه على الخروج من سيارته والدموع طافرة من عينيه يصرخ ويستغيث، يتطوّع أحدهم لإيصاله إلى منزله بسيّارته ذاتها، لكنّه يسرق السيارة بعد إيصاله.
يُؤخذ الأعمى إلى الطّبيب، يثبت الفحص عدم وجود مرض، وأنّ العينين سليمتان تماماً، خلال ساعات يُصاب سارق السيّارة بالعمى، والطّبيب أيضاً، والمرضى الذين كانوا في غرفة الانتظار، وينتشر وباء سُمّي بـ”العمى الأبيض” بين النّاس من دون معرفة السبب، فالعمى هنا كان مختلفاً عمّا هو متعارف عليه، حيث يرى المصاب كلَّ شيء أبيض وكأنّه غارق في بحر حليبي.
تفنّن “ساراماغو” عبر سرده المتواصل في إيصال رسالة قوية تصلح لكل زمان ومكان، فحواها أن الإنسان من دون سلطة يعيش حياة بهيمة ويعود إلى قانون الغاب أي البقاء للأقوى، وترجمت عبر حروفه النابضة بين دفتي الرواية من خلال سياسة السلطات الحمقاء التي ساهمت في استفحال الأمور بشكل مأساوي بدل احتوائها من خلال الإمساك بالعميان وزجّهم في السجون خشية العدوى، ما أفسح المجال للعصابات أن تعيث فساداً في المدينة وتستولي على مخزون الأغذية والدواء، الأمر الذي دفع الناس إلى الاقتتال فيما بينهم.
لم يُغفل الكاتب إبراز دور المرأة الحكيمة وقدرتها على القيادة والنجاح إن كانت كفوءة، من خلال زوجة الطبيب المبصرة التي تظاهرت بالعمى في المحجر لتبقى مع زوجها، ولأنها كانت تتوقع إصابتها في أي لحظة كانت الوحيدة التي رأت انهيار الأخلاق، ورأت القذارة والخيانة والجثث واغتصاب النّساء.
رواية عميقة ومليئة بالرموز والدلالات، فمصطلحُ العمى الأبيض، وعدمُ وجودِ خللٍ في عينِ المصاب فيه إشارات إلى عمى الفكر والوعي، إذ يظنّ البعض أنه سليم الحواس، بينما هو غارق في وحل الجهل، كما أن البشر الذين يعيّرون الحيوانات بالوحشية يتبارون في إظهار بشاعاتهم وشرورهم تجاه بعضهم، عندما تمسك الغريزة بزمام الإنسان ويغيب العقل عن الواجهة، والإسقاط هنا واضح على أننا أيضاً عميان، وإن لم يكن العمى الحسي كما في الرواية، فهو العمى الفكري والأخلاقي، هو ما نعيشه من عمى أخلاقي وإنساني، هو تجاهلنا لمآسي الفقراء والمهمّشين، وتجاهلنا لما يمارسه البعض من جرائم، أو كما لخّصته زوجة الطبيب بقولها: “لا أعتقد أننا عمينا، بل أعتقد أننا عميان يرون، بشر عميان يستطيعون أن يروا، لكنهم لا يرون”.
تقع الرّوايةُ في 380 صفحةً، وتصلح لكلّ زمانٍ ومكان، حيث لم يسمّ الكاتب البلد الذي أصيبَ بالوباء، ولم يسمِّ الأشخاص، بل ذكر صفاتهم وأعمالهم، كـ”الطّبيب والأعمى الأول والطّفل الأحول والمرأة ذات النّظّارة السّوداء”، وكأنّه أرادَ أن يُشعرَنا بنوع من العمى، وقد صدرت أول مرة في عام 1995، وكانت سبباً رئيسياً في حصول صاحبها على جائزة “نوبل للآداب” عام 1998 ولها جزء ثانٍ بعنوان “البصيرة” صدر في عام 2004، كما تمّ تحويلها إلى فيلم عام 2008 من إخراج “فرناندو ميريليس” وبطولة “مارك رافالو” و”جوليان مور”، واقتبست عنها مسرحيات عدة، كذلك وبموافقة “ساراماغو” اقتبس عرض أوبرا يحمل الاسم نفسه من تأليف الموسيقي الألماني (Anno Schreier) عام 2011.
يُذكر أنّ “جوزيه ساراماغو” كاتب وأديب برتغالي ولد في عام 1922، في قرية صغيرة تبعد نحو مئة كيلو متر عن العاصمة لشبونة، وعمل كصانع للأقفال، وميكانيكي سيارات، قبل أن يقوده شغفه الحقيقي إلى ميدان الصحافة والترجمة، التي كانت سبباً رئيسياً في إعالته مادياً ومساعدته على التفرّغ لشغفه الأعظم الكتابة.
لم يُعرف اسم “ساراماغو” عالمياً إلا بعد بلوغه الستين، كما أن آراءه السياسية لم تكن تحظى بقبول رسمي في بلده، ولاسيّما موقفه المناصر للقضية الفلسطينية والمندّد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وهمجيته، وذلك بعد زيارته إلى رام الله والضّفة الغربية في عام 2002.
بسبب هذه المواقف تعرّض “ساراماغو” لمشكلات عدة، فرحل برفقة زوجته وعاش في جزيرة “لانزاروت” الإسبانية، ثم بدأ بكتابة عمله الأكثر شهرة “العمى”، وبقي هناك حتى توفي في عام 2010، وهو مصرّ على آرائه وإن لم تكن تعجب الكثيرين.