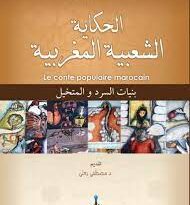أم الشهيد في الأدب.. أيقونة عزة وكبرياء
آصف إبراهيم
كانت ولاتزال سير الأبطال الذين يؤثرون التضحية في سبيل حرية الوطن وصون أرضه ورفعته مدعاة فخر واعتزاز الأمة، وملهمة أدبائها الذين يتسابقون إلى تسطير أروع ما تجود به مخيلتهم وذاكرتهم لتخلد تلك المآثر البطولية وتنقلها إلى الأجيال اللاحقة بأجمل صور لتبقى دروساً يتفاعل معها جيل المستقبل ويسير على هدي خطاها.
ولعل أكثر ما يركز عليه هؤلاء الأدباء في رسم فضاءات سير الشهداء هي الأم الشخص الأكثر تضحية وشموخاً عقب خسارة فلذة كبدها، التي سهرت الليالي وأفنت ربيع شبابها في تسبيل تنشئة أبنائها، ولهذا ففي حضورها تتجسد أغلب الانفعالات الإنسانية المؤثرة، فهل من أحد منّا لم دد بحب وانفعال وتأثر قصيدة الشاعر اللبناني حسن عبد الله “أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها.. أجمل الأمهات التي انتظرتُه، وعاد مستشهداً.. فبكت دمعتين ووردة ولم تنزوِ في ثياب الحداد.. لم تنتهِ الحرب لكنه عاد..
ذابلة بندقيته ويداه محايدتان
أجمل الأمهات التي عينها لا تنام
تظل تراقب نجماً يحوم على جثة بالظلام”.
في هذه القصيدة لا يجد الشاعر أمّاً أجمل من أم الشهيد التي طوت حزنها بفقد أغلى ما عندها وحولت صرخات الأسى إلى زغاريد عزة وفخر، فهي التي كانت تترقب عودته بقلب مليء بالشوق والحنان، وعاد مستشهداً، وهي من زرعت في قلبه حب الوطن والزود عن حماه، وهي من علمته أن الوطن لا يصونه سوى شرفائه.
ومن أروع ما سطّر الشاعر الفلسطيني محمود درويش، تلك الأبيات التي يصف فيها حال أم الشهيد، وقلبها وألمها وسؤالها وتغزلها بابنها، ومخاطبة الأشياء وخوفها عليه.. أين هو؟ أأكل أم لم يأكل؟ أنام أم لم ينم؟ وفي النهاية دموعها.. حتى الدموع قد لا تملك منها الكثير: يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن.. عن صاحبي الذي مضى.. وعاد في كفن.. ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب لأمه: الوداع!.. ما قال للأحباب… للأصحاب: موعدنا غداً! ولم يضع رسالة… كعادة المسافرين تقول: إني عائدٌ.. وتسكت الظنون ولم يخطّ كلمةً.. تضيء ليل أمه التي.. تخاطب السماء والأشياء، تقول: “يا وسادة السرير!.. راح بلا زوّادةٍ، من يطعم الفتى.. إن جاع في طريقه؟.. من يرحم الغريب؟.. قلبي عليه من غوائل الدروب!.. قلبي عليك يا فتى.. يا ولداه.. قولوا لها، يا ليل! يا نجوم!.. يا دروب! يا سحاب!.. قولوا لها: لن تحملي الجواب.. فالجرح فوق الدمع.. فوق الحزن والعذاب!.. لن تحملي.. لن تصبري كثيراً لأنه.. لأنه مات، ولم يزل صغيراً.. يا أمه! لا تقلقي الدموع من جذورها..خلّي ببئر القلب دمعتين!.. فقد يموت في غد أبوه… أو أخوه أو صديقه أنا خلي لنا.. للميتين في غد لو دمعتين… دمعتين!.
وفي قصيدة للشاعر السوري مصطفى عكرمة يصف فيها أم الشهيد التي راحت تسأل عن ولدها الذي نذر نفسه لبلاده، ودّعها وغادر ليلبي نداء الوطن، لكن غيابه طال عنها فأضناها الشوق والحنين، وراحت تسأل عن سر غيابه الطويل، فقالوا لها:
ذهبت تسائل عن فتاها
لهفى يسابقها أساها
السهد أضناها ونار الشوق يحرقها لظاها
وتكاد لولا الكِبر والإيمان تهمي مقلتاها
بالأمس ودعها، وهب يحث للساح المسيرا
وتعاهدا أن سوف يكتب بالدم النصر الكبيرا
أتراه وفى نذره، أم أنه أمسى أسيرا؟؟
قالت: سأسأل من أراه ليطمئن قلبي
قالوا: أتعنين الفتى المغوار؟ قالت إي وربي
قالوا: رأيناه بوجهك إن وجهك عنه ينبي
رأت الجراح بصدره
فاستبشرت تختال كِبرا
كانت جراح الصدر تهتف إنني وفيت نذرا
إني وربك لم أُدرْ
يا أمّ للأعداء ظهرا
فدنت تقبله فقالوا ملتقاكم في الخلود
قالت ودمع الفرحة الكبرى تلألأ في الخدود
حسبي إذا ذكر الشهيد بأنني أم الشهيد
وفي السرد الروائي، صدرت روايات كثيرة ترسم فضاءات عالم أم الشهيد وتتوقف عند مشاعرها وردة فعلها تجاه حدث الفقد والاستشهاد، ومن المناسب هنا أن نتوقف عند تجربة كتابة خطتها أم شهيد بنفسها هي رواية “يوم ارتقى الشهداء – رحلة الذات إلى الذات” التي صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن سلسلة “مدونة وطن” لإحدى أمهات الشهداء الذين حفروا أسماءهم في الذاكرة خلال الحرب على سورية هي الكاتبة سهيلة العجي التي استشهد ابنها بنيان مع مجموعة من رفاقه في مستشفى الكندي بحلب، فكانوا أيقونات الرجولة والخلود، تقول سهيلة في كتابها: “تغيّر بنيان وغيّرني معه، وسيغيّر هو ومن مثله هذا الوطن، وربما الكون”.. هذه المفردات خطّتها أم الشهيد بنيان ليس بالأحبار، إنما بدماء القلب ونزيف الروح ووجع الفراق، وأنين الحنين إلى قطعة من روحها نبضت برحمها رحم سورية التي تنجب الأبطال.
يأتي الكتاب ضمن مشروع توثيق ذاكرة الوطن وشهداء الحرب الإرهابية الذين فاقوا بتضحياتهم وصمودهم كل وصف، لتتساءَل أم بنيان في نهاية المدوّنة: “كم بنيان قضى في هذه الحرب الطويلة؟ وكم شخص عرف بنيان ونظراءَه”.
وفي رواية “دماء على قامات من نور” للكاتبة خديجة بدور ابنة مدينة حمص التي عاشت أحداث مدينة دمرها الغل الأسود، تتوقف عند حالة من حالات ثبات أمهات الشهداء اللواتي كانت مواقفهن مدعاة للفخر والاعتزاز بسيدات كنّ على قدر المصاب وثبات العزيمة: “لقد تماهت حياة الأسرة السورية ممثلة بأسرة الراوية “منيرة” في حياة الوطن، فحتى تلك الأسر التي قدمت شهيداً أو أكثر تفخر بذلك إذ “لولا الشهداء لما بقيت سورية” العبارة التي يرددها الناس بعفوية.
تقول منيرة ص ٤٤: “لا يسعني سوى أن أنحني لكل شريف في بلدي, ولكل دمعة أم سورية ولكل زوجة أبية سكبت دمعها في يوم استشهاد ابنها وزوجها وأخيها دفاعاً عن هذا التراب المقدس”.
وكان للكاتب والروائي الفلسطيني ـ السوري حسن حميد ملحمته الروائية التي صدرت عن “دار كنانة” بدمشق عام ٢٠٢٢ بعنوان: “كي لا تبقى.. وحيداً”، وهي رواية مكتوبة ببراعة وسلاسة، مفعمة بالمشاعر الإنسانية، وتروي حكاية مجموعة من شباب الجيش العربي السوري، قلوبهم متعلقة بأمهاتهم وحبيباتهم اللواتي يترقبن عودتهم بصبر نافد، الرواية يقصها مجنّد خدم في إحدى القطع العسكرية المرابضة في مدينة تدمر تتولى مهمة حمايتها من إرهابيي “داعش”، هو نزار باشقة، الذي أصيب في إحدى المعارك وبعد معاناة، مع إصابته استشهد وشُيّع في جنازة مهيبة.. تحضر والدته أوراقاً تركها لأستاذ اللغة الإنكليزية الذي أعانه حتى اجتاز امتحان الإعدادي، وبعد امتحان الشهادة الثانوية ذهب إلى العسكرية، وخاض المعارك إلى أن جُرح، ثم استشهد، وترك أوراقه أمانة بين يدي أمه، وشهادته الثمينة التي تسرد بطولة تلك الوحدة العسكرية الشجاعة التي خدم في صفوفها.. حملت الأم الأوراق إلى أستاذه وائتمنته عليها، وهو نقلها إلى أستاذ اللغة العربيّة فايز الياسين لينقحها، ففعل، وأعرب عن إعجابه حين أعادها: كتابة جميلة.. يعطي الأستاذ الأوراق لصاحب مطبعة ويطلب منه طباعة عشر نسخ، فيضحك: “عشر نسخ فقط؟!”.. ثم يتفقان على طباعة خمسمئة نسخة بحسب تكاليفها.. أُخبرت أم الشهيد نزار باشقة، فهرّت دموعها مثل حبات توت مترادفة.
نزار باشقة كتب لكي يحفظ رفاقه من الموت: “لأنني بت أراهم طيوراً تهم بالفرار من أمامي” (ص11).
هذه نماذج من حضور أم الشهيد في الأدب بصورتها المشرقة وكبريائها العظيم الذي ينبيء بسمستقبل أمة لا تبخل بالغالي والنفيس للزود عن حمى الوطن.