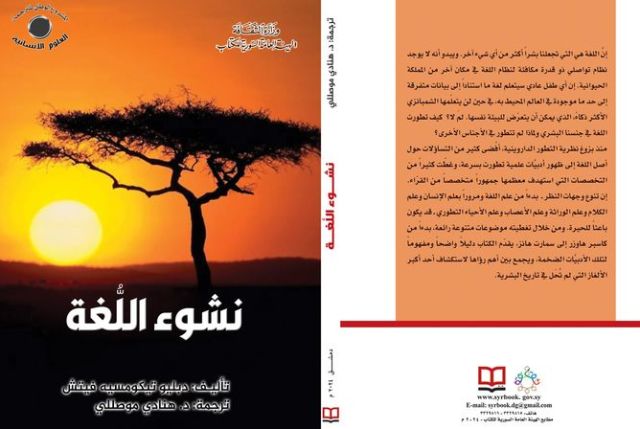“نشوء اللغة”.. بحث في نقاط ضعف وقوة الفرضيات ووجهات النّظر
نجوى صليبه
ما يزال موضوع اللغة ونشوئها يغري الباحثين والمؤلّفين، والنّاشرين أيضاً، ولأهميته، صدر عن الهيئة السّورية العامّة للكتاب- المشروع الوطني للترجمة، وضمن سلسلة “الكتاب الإلكتروني”، كتاب “نشوء اللغة”، تأليف “دبليو تيكومسيه فيتش”، وترجمة الدّكتورة هنادي موصللي، أمّا الهدف من الكتاب فهو كما يذكر مؤلّفه تقديم دراسة عن نشوء اللغة مبنيّة على منظور متعدّد التّخصصات يسلّط الضّوء على نظريّات نشوء اللغة، ويقول: “منذ ستينيات القرن الماضي، برزت أعداد متزايدة من العلماء المتخصّصين في علوم اللغة والإنسان والكلام والوراثة والأعصاب والأحياء التطوّري، أولئك الذين كرّسوا أنفسهم لفهم جوانب مختلفة لتطوّر اللغة، وكانت النّتيجة أدبيات علمية ضخمة غطّت كثيراً من التّخصصات، واستهدفت جمهوراً متخصصاً من القرّاء، فالغرض من هذا الكتاب هو إلقاء نظرة عامّة حول القضايا الرّئيسة التي نوقشت في تلك الأدبيات، من وجهة نظر غير تخصصية ومتوازنة، فاللغة نظام معقّد بشكلٍ هائلٍ”.
وينوّه المؤلف بأنّ تنّوع وجهات النّظر قد يكون أمراً محيراً، ويوضّح: “بينما يرى العالم اللغوي “نعوم تشومسكي” أنّ الأصل المجرّد للنّحو هو جوهري لبيولوجية اللغة، يجد عالم النّفس “مايكل توماسيللو”، ذلك الجوهر في القدرة البشرية للنّوايا المشتركة، ويعدّ عالم النّطق “فيليب ليبرمان” التّحكّم الحركي في الكلام جوهر اللغة، وفي علم الدّلالة ترى عالمة النّفس “إيلين ماركمان” أنّ مجموعة القيود التّفصيلية على المعاني الممكنة هي أمر مهمّ جدّاً في اكتساب اللغة، بينما يعتقد عالم الحاسوب “لوك ستيلز” أنّه يمكن للمعنى أن ينبثق عن أساس اجتماعي وإدراك حسّي وحركي واسع”.
أمّا الافتراض الرّئيس لمنهجه الخاصّ فيكمن في وجوب النّظر إلى اللغة على أنّها نظام مركّب يتألّف من مكوّنات منفصلة بشكل جزئي، ويشارك كثير منها على نطاق واسع مع حيوانات أخرى، يبيّن: “يمكن الجزم بأنّ كلّاً من هذه المكوّنات الضّرورية للغة يمتلك تاريخاً تطوّرياً ويعتمد على عصبية وجينية منفصلة تماماً، وعلى الرّغم من أنّ اللغة هي نظام يتميّز بالتّفاعل السّلس بين هذه المكوّنات المتعددة، ليست اللغة كلّاً متجانساً، ومن منظور بيولوجي قد ينظر إليها على أنّها “حقيبة الحيل” التي جرى تجميعها معاً بوساطة العمل العبثي التّطوّري، وعلى اعتبار أنّ هذا المنظور المتعدد المكوّنات صحيح، فإنّ أيّ محاولة لتمييز جانب واحد فقط من جوانب اللغة على أنّه جوهري أو رئيس يمكن عدّه نوعاً من الخطأ”.
ويتطرّق المؤلّف إلى المشكلات التي يواجهها الوافد الجديد إلى مجال تطوّر اللغة، كمشكلة المصطلحات، يبيّن: “إنّ المصطلحات التّقنية مثل “الركنية” أو “التّكيّف المسبق” أو “التكرارية” أو “القيد التّركيبي” أو “عدم التّناسق الدّماغي” هي مصطلحات غنيّة، لكنّ غالباً ما تمرّ من دون تعريف، وتظهر هذه المصطلحات في علم اللسانيات أو علم الوراثة أو النّظرية التّطوّرية أو علم الأعصاب بشكل متكرر، حتّى الكلمات العادية مثل “رمز” أو “تقليد” تأخذ معاني تقنية خاصّة.. هناك عدد من الفروق والقضايا من هذه المصطلحات الشّاملة التي هي سائدة بما يكفي مصادر للإرباك وسوء الفهم في الماضي”، ليقدّم لاحقاً عرضاً موجزاً وواضحاً للإجماع والخلافات في نظرية التّطور، مستعرضاً أمثلة عن علماء تغلّبوا على عوائق كانت تحول دون التّواصل متعدّد التّخصصات، وأدّت نتائجها إلى إنجازات ملهمة مثل الاصطناع الدّارويني الجديد، وعلم السّلوك الحيواني الحديث، وعلم الأحياء النّمائي التطّوري.
ثمّ يجري “فيتش” مسحاً لمكوّنات اللغة من وجهة نظر علم اللسانيات، وهي في كثير من الحالات عامّة جدّاً، ومعظمها غير مغلّف بإحكام -كما يقول- ويضيف: “أدرك أنّ هناك العديد من المكوّنات المحدّدة التي يمكن اقتراحها لكلّ فئة من الفئات التي قمت بمسحها، وقد يستهين اللسانيون المحترفون بهذه القائمة بسبب سطحيتها”، ليخصص بعد ذلك الفصل الرّابع للحديث عن الإدراك والّتواصل الحيواني، ويستهله بقول لـ”آرثر شوبنهاور” هو “إنّ أولئك الذين ينكرون أنّ بإمكان الحيوانات العليا أن تفهم، هم أنفسهم من يكون لديهم القليل جدّاً من الفهم”، ويخلص منه بقول إنّ الحيوانات تمتلك عالماً معرفياً ثريّاً، لكنّها محدودة تماماً في قدرتها على توصيل أفكارها إلى الآخرين، على الرّغم من أنّ جميع الحيوانات تتواصل، لكنّ خطوط التّواصل مصمّمة بشكلٍ خاص لتلبية احتياجات محدّدة، يقول: “أخيراً.. يقدّم الهيكل الغني للنّظرية التّطورية المتعلّقة بتطوّر التّواصل مؤشّراً واضحاً على سبب كون البشر غير عاديين جدّاً في هذا الصّدد.. هناك حواجز متنوّعة أمام تحقيق أنظمة تواصل منخفضة التّكلفة وصادقة وإخبارية مثل اللغة المنطوقة، وكيف تغلّب البشر على هذه القيود أو تجنّبوها هو سؤال محوري لنظريات اللغة”.
ويتابع في الفصل الخامس الموضوع ذاته، وبالطّريقة ذاتها، وتحت عنوان “لقاء الأسلاف” يستحضر قول “دبليو إن بي باربليون”: “أشعر بالفخر بحجم القرابة مع الحيوانات الأخرى، وأشعر بكبرياء غيور بأسلافي من القردة، أحبّ التّفكير بأنّني كنت ذات يوم فرداً رائعاً مشعراً يعيش في الأدغال، وأنّه قد تمّ توارث هيكلي عبر الزّمن الجيولوجي من خلال هلام البحر والدّيدان والرميحيات والأسماك والدّيناصورات والسّعادين.. من هذا الذي سيستبدل هذه الأشياء بهذين الزّوجين الشّاحبين في جنّة عدن؟”.
وبعد تقييمه للمسح الواسع للتّطور من بدايات الحياة أحادية الخلية إلى ازدهار الرّئيسات في المرحلة الثّالثة، ينتقل “فيتش” إلى نقطة حاسمة لتاريخنا التّطوري، يقول تحت عنوان “إعادة بناء آخر سلف مشترك”: “لقد تطوّر البشر بالمعنى الدّقيق للكلمة بدءاً من اختلافنا عن الشّمبانزي قبل نحو سبعة ملايين عام، وكان هذا زمن آخر سلف مشترك لنا مع الشّمبانزي، أو زمن آخر سلف مشترك لذلك القرد الجنوبي”، مبيناً أنّه لإعادة بناء المرحلة الأخيرة من التّطوّر البشري، يجب الاعتماد على الأحفورات والبقايا الأثرية، وهي مصدر أكثر هشاشة للبيانات، وإنّ الاقتصار عليها يعني الاقتصار بشكل شبه كامل على بقايا الهيكل العظمي وقليلاً من الحمض النّووي الحديث نسبياً، وبما أنّ الكلام واللغة لا يتحجران، فإنّ هذان يوفّران في معظمها أدلّة محيّرة، تخضع لتفسير متنوّع، بدلاً من البيانات المتينة ذات الصّلة المباشرة بتطوّر اللغة” إلى قوله: “على الرّغم من أنّ علم الإحاثة البشري هو مجال مثير للجدل إلى حدّ كبير، لكنّ بعض الاكتشافات الأحفورية المهمة منذ ستينيات القرن الماضي تسمح لنا القيام بالتّصريح ببعض البيانات التّجريبية بثقة، وأصبح سجل أحفوراتنا من البشرانيات وافراً منذ نحو أربعة ملايين عام، أي ما يقرب من ثلثي مدّة تطوّرنا ما بعد آخر سلف مشترك”، مبيناً: “أي مناقشة تفصيلية لعلم الإحاثة البشرانية تصطدم بمشكلة تحيط بالتّفسير الأحفوري بشكل عام: ترسيم الأجناس وتسميتها”، ويخلص إلى قول: “لم يكن التّطور البشري عبارة عن عملية زيادة مطردة في حجم الدّماغ، وحجم الجسم، ولم تكن عبارة عن تعلمّ تقني يحدث في مجموعة واحدة غير منقطعة من البشرانيين المتزاوجين، بدلاً من ذلك تميزت معظم مراحل التّطوّر البشري بأنواع متعدّدة من البشرانيين الذين يعيشون في وقت واحد”، وبالاستناد إلى بيانات قدّمها يتابع: “الإنسان المنتصب مثّل شكلاً جديداً نوعياً من البشرانيين، وهو وسيط معرفي بين البشر المعاصرين وآخر سلف مشترك، ما يشير إلى شكل من أشكال اللغة الأولية مع خصائص معينة للغة البشرية الحديثة”.
“إذا كان يجب التّمييز بين الكلام واللغة، فلماذا تتمّ مناقشة الكلام في كتاب عن تطوّر اللغة؟” سؤال يطرحه المؤلّف ويعلل ذلك بأسباب، أوّلها أنّ الكلام هو نظام الإشارات الافتراضي لجميع الثقافات البشرية، ولا يوجد دليل على أنّ هذا كان خلاف ذلك، وثانيها هو أنّ مؤلّفين عدّة ناقشوا الطبيعة الخاصة للكلام، إمّا على مستوى إنتاج الكلام أو إدراكه، مع افتراض أنّ الجوانب المختلفة للكلام هي جزء من المكوّن البشري الفريد للغة، أمّا ثالثها فهو أنّ الفرضية الدائمة في تطوّر اللغة هي أنّ الكلام هو ذلك المكوّن المفقود المهمّ وهو الذي يجعل الحيوانات بعيدة عن اللغة، وتمّت مناقشة فكرة أنّ بعض جوانب التّشكّل المحيطي تسمح أو لا تسمح بالكلام من قبل العديد من المؤلّفين، وربّما تكون الفرضية الأقدم والأكثر استمرارية في مجال تطوّر اللغة، وقد عدّ باحثون آخرون إعادة تشيل المجرى الصّوتي البشري التّغيير الرّئيس الذي حفّز جوانب أخرى من اللغة، بما في ذلك بنية المقطع والنّحو أو حتّى المراجع، وأخيراً هو أنّ المناقشات الحديثة تركّز في غالبيتها على تفوّق اللغة على الكلام لأنّه الجانب الوحيد للغة الذي لديهم به بعض الأمل في الحصول على أدلّة أحفورية، بناءً على إعادة تشريح المجرى الصّوتي.
يغوص المؤلّف بتفاصيل دقيقة ويدعّمها بأمثلة وصور، وبشفافية ومصداقية ينهي بحثه بالقول: “قد يشعر القارئ، عند وصوله إلى الصّفحات الأخيرة هذه، بالإحباط لأنّني لم أحدّد أنّ أيّاً من الفرضيات العديدة التي ناقشتها في الكتاب أعتقد أنّها صحيحة، كما أنّني لم أضع نظريةً لتطوّر اللغة أعتقد أنّها صحيحة، وبدلاً من ذلك قمت بالتّركيز على نقاط الضّعف والقوّة في العديد من الفرضيات والنّهج ووجهات النّظر المختلفة حول تطوّر اللغة”.