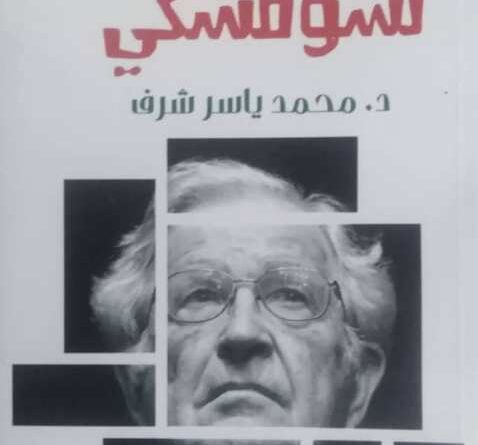“قفزة تشومسكي” والملكة اللغويّة
نجوى صليبه
يقف الدّكتور محمد ياسر شرف في الباب الأوّل من دراسته “قفزة تشومسكي” مع آراء لعالم اللغة الأميركي المعاصر “نعوم تشومسكي”، ولاسيّما تلك الواردة في كتاب “اللغة ومشكلات المعرفة” الذي نقله إلى العربية حمزة بن قبلان المزيني بإشراف تشومسكي ومشاورته، يقول: “بدأ مترجم الكتاب كلمته التّصديرية بإعلانه عن أنّ تشومسكي يتبوّأ مكانة في تاريخ اللسانيات لا يدانيه فيها إلّا قلّة من العلماء، مشيراً إلى ابتداء توجّهه في هذا الموضوع منذ نشر كتابه “البنى التّركيبية” عام 1957، فأحدث ما يشبه قطيعة مع المناهج التي كانت تتبعها اللسانيات وبعداً عن الأهداف التي كانت ترسمها لنفسها”.
ويذكر أنّ المزيني بيّن أن الكتاب الرّاهن الذي يقدّمه موجّه إلى المثقّف غير المتخصّص، فهو بعيد عن الإغراق في المصطلحات المتخصصة، كما أنّه بعيد عن الطّبيعة المعقّدة التي تتّسم فيها الأعمال اللسانية الموجّهة إلى المتخصصين، ويقدّم إليهم صورة كلية لأحدث التّطوّرات التي تعيشها النّظرية التّوليدية، ويوضّح: “أشار تشومسكي في أوّل حديثه عن “إطار المناقشة” إلى حرصه على إبراز غالبية الأفكار المطروحة بطريقة لا تتطلّب معرفةً متخصصة، على الرّغم من أنّ موضوعات اللغة ومشكلاتها متداخلة ومعقّدة، وذكر أنّه سيوضّح “بعض المشكلات الفنّية المتخصصة التي تتصدّر البحث في هذا المجال، والحلول التي يمكن اقتراحها لحلّها، كما أرغب في أن أوضّح السّبب الذي جعل لهذه المسألة الفنّية المتخصصة علاقة وثيقة بقضايا أخرى أعمّ وأقدم”.
جعل “تشومسكي” أوّل هذه المطالب في بيانه “نوع المشكلات” التي تهتمّ فيها دراسة اللغة -كما يذكر شرف- يتمّيز بمظهرين أوّلهما: تقاليد الفلسفة الغربية والدّراسة النّفسية اللتان تهتمّان بفهم طبيعة الإنسان الأساسية، وثانيهما: المحاولة التي تبذل في إطار العلم المعاصر لتناول المسائل التّقليدية في ضوء ما نعرفه الآن، أو ما نأمل معرفته عن الكائنات الحيّة والدّماغ، ويضيف: “لفت تشومسكي انتباه القارئ إلى أنّه في أثناء “مناقشته للتّقاليد الفكرية” التي يرى أنّ البحث اللساني يجد مكانه الطّبيعي فيها، لا يقيم “فارقاً صارماً” بين العلم والفلسفة، إذ لم يُصنع الفارق بينهما سوى في الماضي القريب، بتسويغ أو من دون تسويغ”، إلى قوله: “ولا يقيم تشومسكي فاصلاً صارماً بين مجال اللسانيات وعلم النّفس، فقال: “إنّني أنظر إلى اللسانيات، أو على وجه الدّقة تلك الجوانب من اللسانيات التي أهتمّ بها هنا، على أنّها ذلك الجانب من علم النّفس الذي يهتمّ بالمظاهر الخاصّة لهذا الموضوع، وأودّ التّأكيد هنا أنّني أدخِل جوانب كثيرة من الفلسفة في هذا الإطار، متّبعاً الممارسة التّقليدية لا المعاصرة”.
وينتقل الدّكتور شرف إلى “منهج البحث في اللسانيات الحديثة” الذي قدّم تحته “تشومسكي” ما عدّه المشكلة الجوهرية في هذا البحث، وينقل قوله: “إنّ العقل -الدّماغ- الإنساني نظام معقّد تدخل في تركيبه أجزاء متفاعلة متعدّدة، أحدها الجزء الذي يمكن أن نسمّيه “الملكة اللغوية”، ويبدو أنّ هذا النّظام الفريد في خصائصه الأساسية ومقصورة على النّوع الإنساني وعام في أعضائه، وإذا قدّمت إلى هذه الملكة اللغويّة المادّة اللغويّة الأوّليّة فستحدّد اللغة التي ستكتسب، وسوف تحدّد هذه اللغة عدداً كبيراً من الظّواهر المحتمل وجودها ممّا يتجاوز بشكل كبير المادّة اللغويّة التي قدّمت أوّلاً”.
وتحت عنوان “تصوّر تشومسكي والعربية الفصحى” يطبّق الباحث الأطر العملية لحدوث اللغة العربية الفصحى لدى الأطفال والكبار من العرب الذين يعيشون في بيئات مجتمعية متنوّعة تتحدّث اللغة العربية، وتالياً كشف ما إذا كانت الملكة اللغوية عند هؤلاء تمكّنهم من تعلّم اللغة العربية الفصحى على نحو ما حكاه “تشومسكي” في بعض أمثلته عن الإسبانية أو غيرها، ويوضّح: “إذا كان حدوث الفصحى غير وارد- بطريقته الموصوفة، فإنّ هذا يعني تأكيداً علمياً في أحد الاحتمالات على عدم صحّة شمول تصوّر “تشومسكي” لموضوع الملكة اللغوية كما عرضها، والتي عدّها واحدة من الخصائص العامّة للنّوع من دون أي استثناء، إذ قال تشومسكي بصورة محدّدة إذا افترضنا أنّنا وضعنا طفلاً يمتلك الملكة اللغويّة الإنسانية، جزءاً من إعداده الفطري، في بيئة يتكلّم أعضاؤها الإسبانية، سوف تنتقي الملكة اللغويّة لديه المادّة اللغوية ذات الصّلة من بين الوقائع التي تحدث في هذه البيئة، ويقوم الطّفل مستعيناً بهذه المادّة الأوّليّة بصورة تحدّدها البنية الدّاخلية لها، بصياغة لغة بعينها أي الإسبانية، أو على وجه أكثر دقّة ذلك النّوع من الإسبانية الذي يجده الطّفل مستعملاً في محيطه، وتصبح هذه اللغة بعد ذلك جزءاً من العقل، وحين تنتهي هذه العملية تصبح اللغة التّطوّر النّاضج الذي تحتفظ فيه الملكة اللغويّة، وعند هذه النّقطة يستطيع الطّفل أن يتكلّم هذه اللغة ويفهمها”.
لكن الدّكتور شرف يجد هنا مشكلتين يجب على الباحث اللغوي اللساني حلّهما مهما كانت اللغة التي يجري بحوثه فيها، هما تعيين المقصود تحديداً بما سمّاه تشومسكي “المادّة الأوّلية” اللغويّة و”البنية الدّاخلية لها”، ويقول: “إنّنا نلاحظ بالمقارنة التّحليلية أنّ اللغة التي تحدّث عن تعلّمها “التّلقائي” وعدّها كعمليّات النّمو في البيئة المجتمعية المحيطة ليست هي -قياساً بالنّسبة إلى اللغة العربية المعجمية- ما يعدّ اللغة الرّسمية أو الفصحى التي تحوي أنظمة قواعد الضّبط النّحوي والصّرفي ومهارات التّركيب الشّكلي كالبيان والبديع والبلاغة، وغيرها من أسس وقواعد ضابطة للاستعمال، يتمّ الاعتماد عليها لبيان الصّواب من الغلط في مجالات الاستخدام اللغوية المتعدّدة، وهذا يعني من جهة أخرى أنّ الطّفل العربي أو المولود في مجتمع يتحدّث لغة عربية لا يتعلّم اللغة العربية الفصحى من البيئة بما لديه من “ملكة لغوية إنسانية” حسب تشومسكي، بل يتعلّم ما يتكلّم النّاس المحيطون فيه مجتمعياً من لغة “عامّة”.. وقد تشبه اللغة المتعلّمة ما في الفصحى من تعبيرات بدرجات مختلفة وبسحب معايير متنوّعة”.
ويتطّرق الدكتور شرف هنا إلى مسألة مهمّة في تعلّم اللغة العربية الفصحى واستخدامها، إذ يقول إنّ الباحث اللساني من الناحية العملية المؤكّدة تاريخيّاً يلاحظ أّنّه على مرّ مئات السنين “لم يتقن أفراد غالبية المتعلّمين” في بيئات تتحدث العاميات اللهجية المتنوعة استخدام “الصّيغ الفصحى العربية” المعتمدة على القواعد الرّسمية تماماً حتّى بعد انتهاء دراساتهم الجامعية، وربّما تحصيل أعلى الدّرجات العلمية لأنّها -أساساً- غير موجودة في بيئاتهم المختلفة الحصائل، ويضيف: “تشهد وقائع النّدوات والمؤتمرات والنّقاشات الكثيرة، التي يحضرها آلاف من متحدثي “اللهجات اللغوية العربية” في اختصاصات متنوّعة بأنّ الغالبية العظمى من الأفراد غير المتخصصين باللغة العربية يغلطون في اللفظ والقراءة والكتابة، قياساً إلى القواعد الضّابطة في النّحو والصّرف والإعراب والإملاء، التي يجب أن تكون من محتوى ما سمّاه تشومسكي “الملكة اللغوية”، بالإضافة إلى تفاوت فهمهم لكثير من معاني الكلمات المفردة حسب تعريفاتها في المعاجم اللغوية”.
وهذا يفضي إلى احتمالين -كما يذكر الدّكتور شرف-: “الأوّل هو أنّ كلام تشومسكي عن حدوث اللغة نتيجة ملكة إنسانية في بيئة مشتركة، من دون انتظار تعلّم التّركيبات القاعدية والأصول المنطقية، هو كلام غير شامل لهذه اللغة، على الرّغم من انطباقه المذكور في غيرها، والثّاني هو أنّ اللغة العربية الفصحى ليست ناشئة عن “الملكة اللغوية” الفطرية المولودة مع الإنسان، حسب تصوّر تشومسكي المتقدّم وتركيبها تمّ بواسطة اتفاقات وجهود مختلفة، ذكرنا بعض أصحابها ومراحل إنجازها، وهي لها لغة حديث وكتابة متعلّمين لأغراض قصدية وليست ناتجة عن الملكة اللغوية الإنسانية بنحوها الكلّي وحوسبتها الفورية في بعض الحالات، وغير الشّعورية والتي لا يمكن سبرها بطريقة واعية أو بالتّأمّل الاستباطي”.
ويقدّم الباحث استدراكات وتصويبات، لكن سنركّز على ما يكمل ما بدأناه عن اللغة العربية والملكة، إذ يقول: “سواء حدثت اللغة العربية للأشخاص الذين يعيشون في بيئات مجتمعية تتكلّمها عن طريق ما سمّاه تشومسكي “ملكة اللغة” الإنسانية، أم تعلّموها بتكرار السّماع والتّقليد والقياس وغيرها من طرق رفضها، فإنّ هناك مجموعة من العوائق والالتباسات في نسيجها التّقعيدي لابدّ من تغييرها وتحسينها، لكي يفتح الباب أمام إتقان العربية الفصحى بصور أيسر وأوسع”.
ويتوسّع الباحث الدّكتور محمد ياسر شرف في أصل اللغة العربية والاختلاف الذي ما يزال قائماً بين اللغويين المشتغلين بتاريخ العربيّة وأبنيتها والمراحل التي قطعتها المؤثّرات التي طرأت عليها والصّياغات القديمة التي اتّخذتها قبل صيرورتها، ويعرض آراء بعض الباحثين القدامى والمعاصرين في اللغة العربية، ويتوقّف عند النّاتج اللغوي والأدب وسيطرة ما سمّي “لغة الأدب” وآثار الثّقافات التي تقدّم وفق ما يقول: “تحديات متفاوتة المقادير في التّفريق بين اللغة التي يستخدمها النّاس في قضاء شؤون حياتهم اليومية، واللغة التي يعدّها المتعلّمون وأصحاب الشّأن الثّقافي أدباً”.
يُذكر أن الكتاب صادر عن اتّحاد الكتّاب العرب سلسلة الدّراسات 2023 ويقع في 300 صفحة، منها 19 صفحة مخصّصة للمصادر والمراجع.