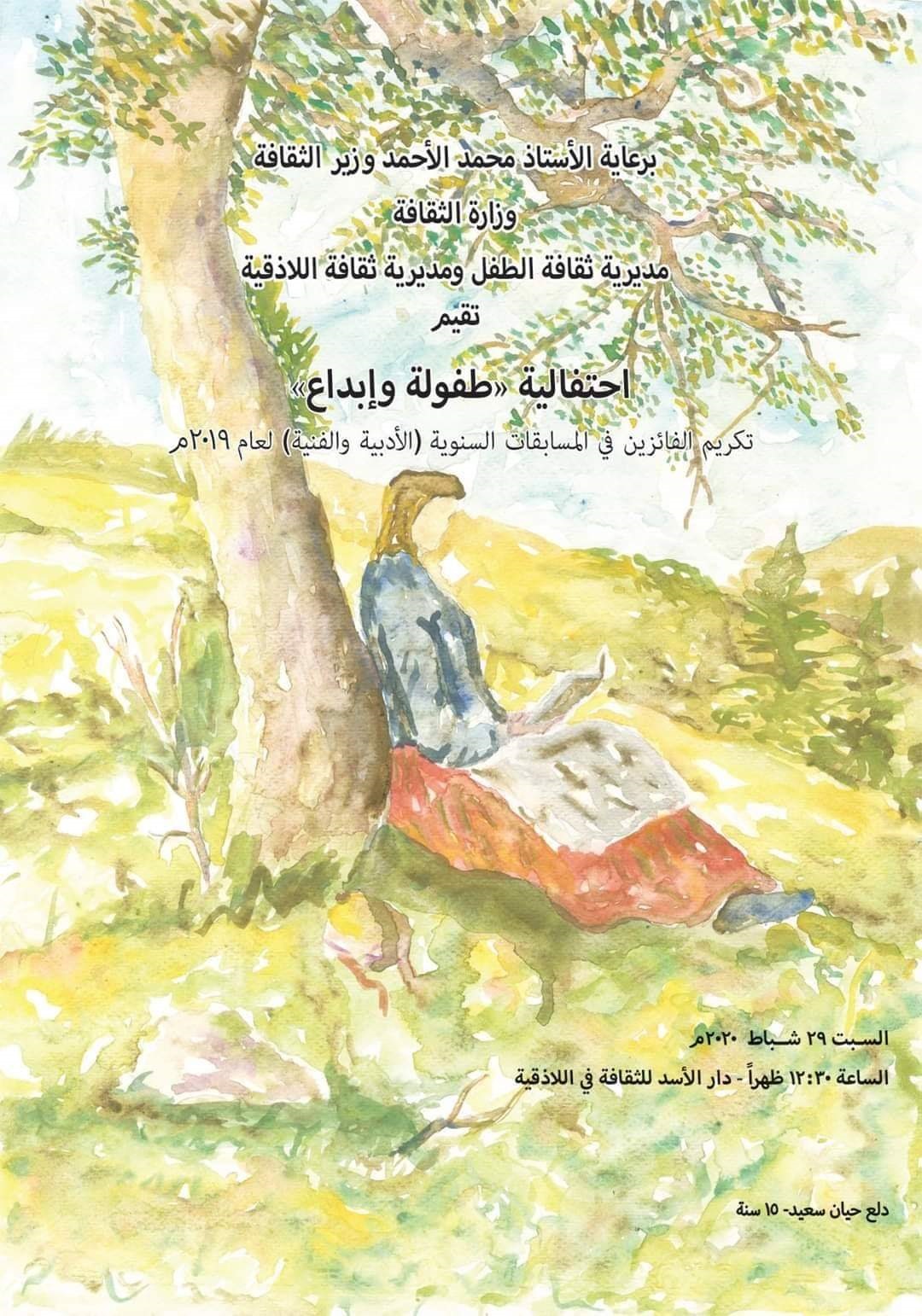الوصايا الافتراضية ودعاة التكنولوجيا
غالية خوجة
تدور الكرة الأرضية أبطأ من السابق، والجليد القطبي يذوب، والعلاقات الاجتماعية تتبخّر، والضغط النفسي يرتفع أكثر من درجة الغليان، والقلوب تفيض بالهموم والكراهية مثل البراكين، والعالم يتزلزل، والأرواح تبحث عن فسحة من الطمأنينة، وهذا الفضاء لم يعد يتسع!.
مشهد مختصر لما يتكرّر كثيراً في حياتنا الزائلة، ولا مخرج للطوارئ على أو في هذه الأرض، على الرغم من أن هناك فسحة من الضوء كتب عنها محمود درويش: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.
يستحقّ الحياة التي وهبها الله له، لكن، لماذا إنسان آخر يأخذ منه هذا الحق بالإيلام وجرح الأرواح وتحطيم النفس واستلاب اللقمة؟.. الإنسان يستحق الحياة في مجتمع تتآلف أرواحه، أو تسعى للتآلف، لأن التنافر يزيد مساحة النفور والبغضاء، وللأسف، هذه المساحة توسّع مساحتها بين أفراد العائلة الواحدة، فما بالك بالمجتمع؟ وما بالك بعلاقات الجيران التي كانت من أجمل العلاقات بين الناس في كلّ مكان من العالم العربي، وكيف كانت الجلسات تعقد صباحاً وعصراً ومساء، وكيف كانوا يتعاونون على البر والتقوى، ويسألون عن بعضهم البعض، فلا تجد جاراً جائعاً، مثلاً، أو محتاجاً لدواء، ولا جاراً غاب ولم يسأل عنه أحد.
هذه المعاملة النقية لم نعد نجدها بين الأهل للأسف، لعلها تبخّرتْ، أو وئدتْ، أو تحولت إلى شخص شفاف لا يراه إلاّ شفاف مثله، فيتشردان في أرض الله الواسعة بحثاً عن أناس شفافة.
والملفت، لمن يطّلع قليلاً على ما تبثّه وسائل التواصل الاجتماعي، أن ينتبه كيف تحتشد الأفكار السامّة بهيئة أنيقة ومقنعة، لدرجة أنها من الممكن أن تحرّف في المعنى وأهدافه، فتجعل الإنسان الذي لا يمتلك وعياً بديهياً ومقارناً أن يصدّق ما يمرّ عليه من هذه الأفكار، ولربما طبّقها ونشرها في محيطه الاجتماعي الواقعي والافتراضي، مثلاً، هناك من يكتب: “قال (..) رضي الله عنه: اعتزل ما يؤذيك”، ولا يكمل القول الصحيح، بل يقتطع منه هذه الجملة، ولا ينسبه إلى قائله الصحيح، ويحدّد لك مَن تعتزل، لكنه لا يحدّد “ما يؤذيك”، وذلك تبعاً لغرض المستشهد بقوله رضي الله عنه، لأن غايته تحريف المعنى والمبنى والأهداف، ويجعل متابعيه يقتنعون بأن عليهم اعتزال ما يؤذيهم حتى لو كان “أقرب المقربين”، على حدّ تعبيره!، ويؤكد المستنصر لقطع الأرحام والعلاقات الاجتماعية: “قال اعتزل ولم يقل احتمل”!.
ترى، ألا يفهم القارئ أو المستمع لهذا المغرض أن عليه اعتزال أيّ كان، مهما كانت صلة القرابة والصداقة والجيرة، لكن ما الأذية؟ ولماذا الإصرار على كلّ هذا الانحراف التراحمي، وعلى تضخيم “الأنا” حتى التقزيم؟.
أمثال هؤلاء الدعاة الإلكترونيين يدرسون الهندسة النفسية والهندسة الاجتماعية، ليتلاعبوا بالناس، وينتجوا “أنوات” سلبية، مريضة، من خلال خديعتها بأنها محور الكون، خصوصاً، الجيل الشاب غير الواعي، فتُقبل الأنا المستهدَفة طائعة على تنفيذ هذه التعاليم والوصايا، لاقتناعها بأنها أهم من أي “أنا” أخرى، فيبدأ المُصاب بفرض ذاته وأفكاره المسمومة و”أناه” الحديدية الجبّارة كعالمة لا جاهلة، وتبدأ المشكلات بالتشابك مثل بيت العنكبوت، لتنقطع العلاقات وتتقطّع تدريجياً، أو دفعة واحدة، وبعد زمن مناسب لكلّ شخصية، سيكتشف صاحب هذه الأنا المتضخمة كيف ظلّ وحيداً مع أناهُ القزمة، تائهاً في دروب الحياة المظلمة.
وهنا، إمّا أن يكون قد انتبه قبل فوات الأوان، وأصابته الصدمة بالوعي، وبدأ بإصلاح ما أفسده مع نفسه والآخرين الذين تنمّر عليهم وظلمهم، وإمّا أنّ الأوان قد فات، وصار مستعبداً للتكنولوجيا، بينما مات أغلب الذين اختار أن يعتزلهم لأذيتهم له على حدّ تعبير المغرض الداعي التكنولوجي لهذا الحطام الذاتي والاجتماعي.