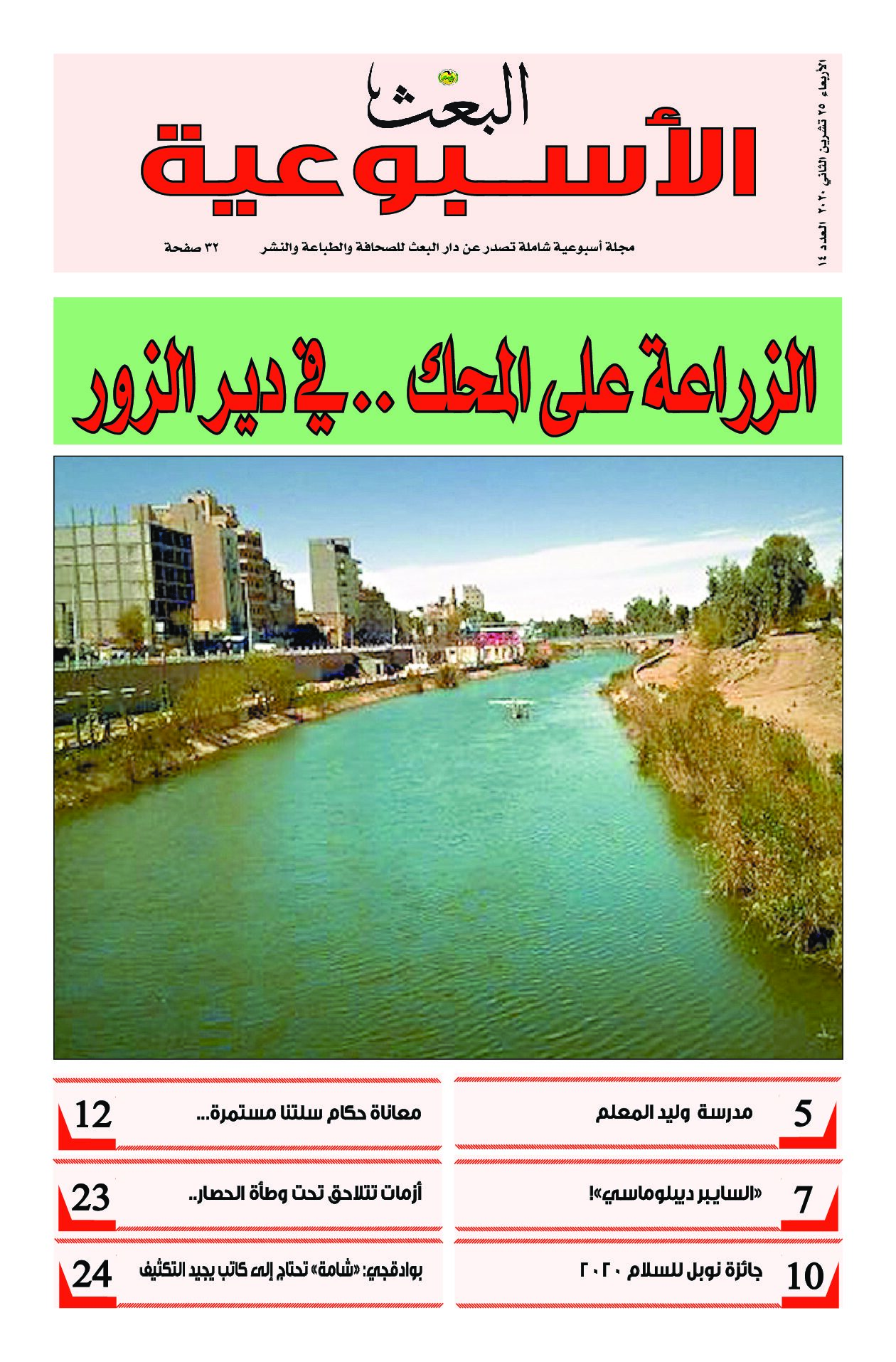أجنحة لنساء السلام وأضرحة لكل ظلام
غالية خوجة
منذ الفينيق، ولنساء سورية أجنحة، وقلوب من شمس وقمر، وحياة تورق بالفصول الحالمات من جديد.
منذ اللحظة الأولى لسبعة آلاف سنة مضت، وتراثنا السوري يمسح الحزن عن آثاره لتضيء الذاكرة، ويعشوشب الأمل متجذراً مثل شجرة التوت التي كانت، يوماً، تتوسط ساحة الحطب في حي الجديدة التأريخي العريق بحلب.
الساحة ـ ورغماً عن الأنقاض والموت تتنفّس من جديد، تستعيد ما غاب من ذاكرتها وتشاهد معنا أزمنتَها التي مرتْ، وعناصرَها التي كانت تزينها، ومنها شجرة التوت المعمّرة التي كانت هنا قبل الحرب العشرية على وطننا.
الساحة تستعيد ذاكرتَها مثل شريط سينمائي وثائقي، وشجرة التوت التي لم تعد هنا، تتذكر كيف كانت تشارك الأهالي أحاديثهم بصمت، لكن أغصانها، الآن، تتكلم من بوابات اللحظة الغائبة، وتحدق في لوحة رمزية مؤلفة من 15 عموداً إسمنتياً اسمها “كان هناك” للفنانة المغتربة ياسمين علي، التي أضاءت قواعد الأعمدة الحاملة لحمامات سيراميكية بيضاء تهدل بأسماء الأمكنة والشخصيات المؤثرة في تأريخ حلب والعالم، فنتجول مع “بيرويا” و”حدد”، ونصغي للمتنبي، ونسافر مع رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، لنعود مع سيف الدولة إلى هذه الساحة، ونرى كيف تُرمّم الأيادي الوطنية جامع “شرف” المطل على ساحة الحطب وأزقتها المرصوفة بطريقة خاصة بالحجر البازلتي الأسود والأبيض وكأنها لوحات فنية، تلمع بظلال الأبواب العتيقة، و”سقاطاتها” المحبة للضيوف.
وضمن هذا المشهد الغرائبي، الناس، هنا، لا تلتفت إلى كوابيس العشرية التي مضت، لأنها ألقت بظلامها في الجحيم، بل تنظر إلى الزمن الآتي، وابتسامة الصبر المنتصر تظهر على الملامح المتعبة المتفائلة، فأرى البعض يعبر متجهاً إلى بيته القريب، أو إلى عمله، أو إلى مشاغله الأخرى، والبعض الآخر يجلس متأملاً بين الحزن والدمع والأمل، ومن هؤلاء، رأيت نسوة جالسات يتأملن المشهد، شاردات بين الحمامات والأعمدة والذكريات، فتعرفت إليهن، وانطلقت معهن من دواخلهن، وسألتهن: ماذا تعني لكنّ هذه الساحة العريقة والعواميد الفنية؟ وما الشخصية الحلبية الأكثر تأثيراً بحياة كل منكن؟ ولماذا؟
فأجابتني وفاء ياسين: صباح فخري، لأنه عمود هام بحلب والتأريخ الإنساني، وأحب من أغانيه “ربة الوجه الصبوح”، أشعر بأن حلب ربة الوجه الصبوح، وهي عنوان الأمل.
وبدورها، قالت الحاجة درية زغنون: أحب الحمام لأنه يمثل السلام الذي يشبهنا، الحمام لم يغادر شرفة بيتي حتى أثناء الحرب، وأضافت بحسرة محترقة: ساحة الحطب أحلى ساحة في حلب، وكم أشتاق لشجرة التوت العتيقة المسنّة التي كانت تتوسسط هذه الساحة وعمرها قريب من عمري، حوالي 100 سنة، وما زلت أذكر طعم توتها، وأسمع صوت أجنحة الحمام الذي كان هنا.
وبدورها، أجابتني الشابة صابرين ابراهيم: أعمل مدرّسة، وأشعر بأن هذه الساحة منطقة سياحية هامة عالمياً، وها هي بدأت تسترجع سكانها ومناخها الحيوي، وتستقبل المعارض الفنية والأنشطة الثقافية، وأصبحت ملامحها أكثر نظافة وجمالاً بعد الحرب، وحالياً، أشعر بمزيد من الأمان والسلام لا سيما مع وجود نقطة للشرطة، وأراني منجذبة لشخصية إبراهيم هنانو لأنها شخصية وطنية بارزة.
وبألم له جذور في الأعماق، نطرت إليّ حليمة ماردنلي وهي تجيب: حزينة لأن الحرب أوصلتنا إلى هنا، ما زال بيتنا هنا، وعدنا إليه منذ 3 سنوات، وأذكر أمي وأبي ـ رحمهما الله ـ وجلستهما هنا على الكراسي الخشبية، في الساحة، تحت شجرة التوت، وأولادي يلعبون معهم.
وشردت قليلاً، وهي تضيف: نحن عائلة تحب العلم والفنون والثقافة، لكن ظروفي لم تساعدني على التعلم، لذلك، قررت، أنا الجدة لعشرة أحفاد، أن أمحو أميتي، ونجحت بمحوها أثناء الحرب، تحت القصف الإرهابي، في مركز يقع في حي المحافظة.
وأضافت ضاحكة: أحب ميادة حناوي، وأغنيتها “هي الليالي كده” لأنها كانت حمامة المحبة بيني وزوجي العسكري، وهي أجمل ذكرياتي.
وابتسمت أختها أمية ماردنلي وهي تقول: كنت ممرضة أطفال سابقاً في الهلال الأحمر، وأنا أفتخر بكل شخصية حلبية مؤثرة في التأريخ والحياة والحضارة، فكيفلا أحب عمر أبو ريشة، أو أبو فراس الحمداني، أو فاتح المدرس؟! طبعاً، أحبهم جميعاً، وسورية علمتنا المحبة، وهي، دائماً، الأمن والأمان والسلام، بينما حلب، ففيها ذكريات الطفولة والشباب والعمر، فيها خلقنا، وفيها نموت.
وداخل المشهد الديناميكي، اقترحت أن تفتح محدثاتي أيديهن أجنحة مثل حمامات السلام لألتقط لهن هذه الصورة المبتسمة بين إيقاعات عملية الترميم وإشارات الفنون والفراغات المتسللة من جذور أرواحنا وأغصان شجرة التوت التي ما زالت أغصانها تنمو في ذاكرة كل منا، فتعيدني إلى جلستي مع أمي رحمها الله وصديقاتها على كرسي خشبي ما زالتأشجاره تئنّ في الأوردة، وتعيدني مع ملامح أبي رحمه الله إلى هذه الطريق التي نعبرها لنصل إلى السبع بحرات والجامع الأموي الكبير وأسواق المدينة وخان الوزير وقلعة حلب.