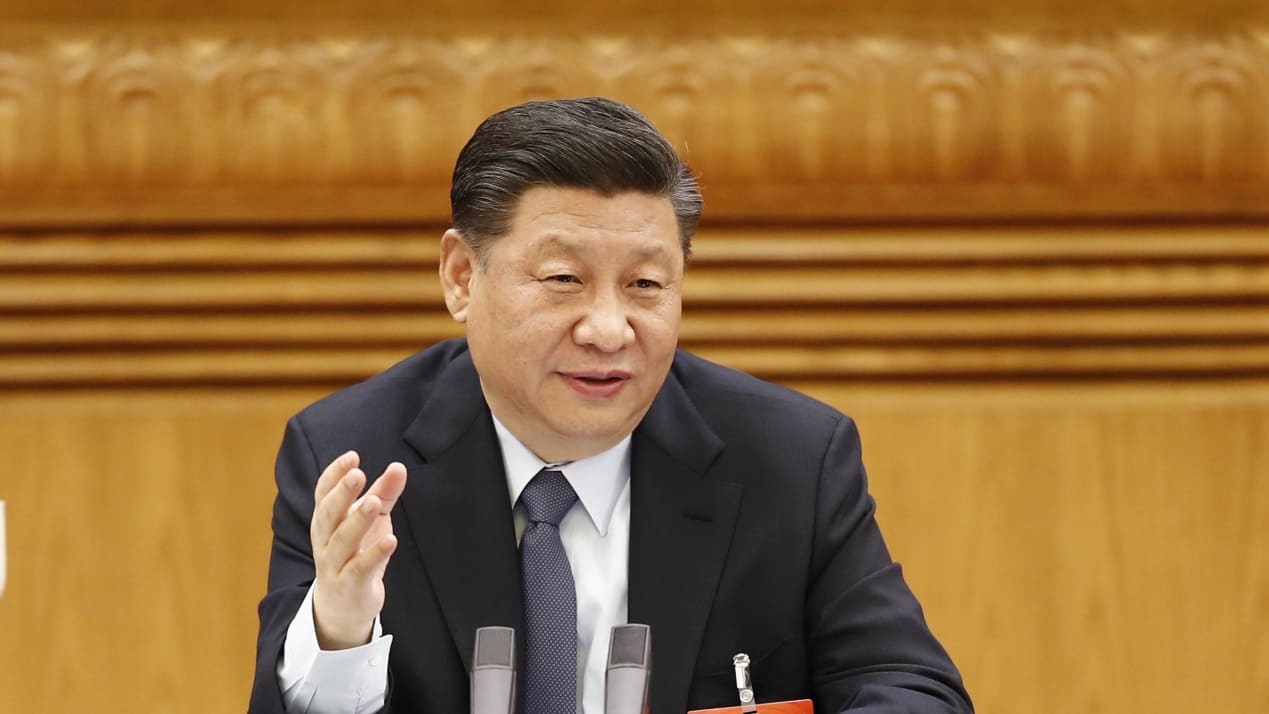الأب عبد اللطيف عبد الحميد
أمينة عباس
يُقال “ربّ أخ لم تلده لك أمك ولكن ولدته لك الأيام”، وعند الحديث عن المخرج السينمائي الراحل عبد اللطيف عبد الحميد يجدر بنا قول “رب ابن لم تلده أمك ولكن ولدته الأيام”.. رحل عبد الحميد وفي رصيده الإنساني ابنته الوحيدة ماريا وابنان روحيان هما المخرج جود سعيد والطبيب عروة شدود ابن أخته، والكثير من الأصدقاء.
الابن الروحي لعبد اللطيف عبد الحميد أو الأب الروحي لجود سعيد كلاهما يصحّان على علاقتهما التي يعرفها ويلمسها الجميع، وقد نعى سعيد عبد الحميد قائلاً: “السينما السورية تنعي بسمتها عبد اللطيف إلى لقاء في عالم أقل وجعاً.. رحل عبد اللطيف عبد الحميد واقفاً، ومبتسماً، وكان بصحة جيدة قبل أيام من وفاته، حيث أجرى فحصاً طبياً وكان وضعه سليماً.. كان رحيله صادماً بالنسبة إلي والكثيرين”.
لم تكن علاقة جود سعيد بعبد اللطيف عبد الحميد علاقة مخرج مع مخرج، بل علاقة ابن بأبيه وأب بابنه: “لا يمكن أن أصف العلاقة به أو أعطيها توصيفاً صحيحاً، فعلاقتي به مختلفة، وأشعر كأنني خسرتُ أحد أفراد عائلتي وأكثر من صديق وأب وأخ.. إن أعظم ما قدمه لي هو الحب”، مبيناً سعيد أن عبد الحميد كمخرج استطاع أن يصنع لنفسه مدرسة خاصة في عالم السينما سُمّيت سينما عبد اللطيف عبد الحميد، ومن خلالها قدم العديد من الأعمال التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش، وحفرت عميقاً في ذاكرة السوريين ووجدانهم، ولا يستطيع أحد أن يكمل مسيرته، وما صنعه يعجز أحد عن إكماله، وأمنيته كانت أن يرى صالات للسينما في سورية، وأن تُعرض الأفلام التي تُصنع وتستوفي حقها بشكل سليم”.
وكان من الصعب على الطبيب عروة شدود وصف عبد اللطيف عبد الحميد حين طلبنا منه ذلك، لكنه قال: “كان عجينة غريبة من الحب واللطف والرهافة.. لمّا خُلقتُ اقترح اسمي، وعاش معي لحظة بلحظة، وكان يمازح والدتي ويقول لها هذا الولد لي.. لقد عشتُ طفولتي وقبلاته تنهمر على خدّي، وكنتُ كلما أراه أبكي وأصرخ ولا أهدأ حتى يحملني على كتفيه، ومع مرور الأيام وفي عمر التسع سنوات بدأتُ أنتبه لذلك البريق في عينيه، ولطالما تساءلتُ هل هي دموع الحزن أم الفرح؟”، ويتابع شدود: “وشيئاً فشيئاً عرفتُ من هو عبد اللطيف عبد الحميد الذي صار مَثَلي الأعلى في النجاح والتفوق، وهو الذي كان يعطيني في الصيف قصصاً وروايات تناسب عمري، وحين تمّ الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة رنّ الهاتف في بيتنا في القرية وكان المتصل هو ليقول لأبي: “أين هو البطل الذي رفع رأسي”، وكان يتمنى أن أصبح طبيب أسنان، وهذا ما حصل، وفي هذه المرحلة من النضج المعرفي والثقافي الذي وصلتُ إليه بدأ يغدق عليّ عشرات الروايات والأفلام، ثم رويداً رويداً بدأ يشاركني بأفكاره السرية عند الكتابة، ويستأنس برأيي خلسة، وعلى الرغم من اطّلاعي التامّ على نصوص أفلامه على الورق، لكنني أبقى محاصَراً بتلك الهالة من الجمال والسحر الذي تمليه سينماه عندما أخرج من العرض الأول لأفلامه”.
وعن سنواته الأخيرة يضيف شدود: “تتالت الأيام، وبدأت زوجتُه لاريسا تحتضر، فسارعتُ للوقوف إلى جانبه في تلك الرحلة العصيبة، وقد عجز الطب عن تقديم أي مساعدة لها، ورأيتُ معه ذبول وردته إلى أن وافتها المنية، ولم أدّخر جهداً كي أساعده في الخروج من محنته، لكن قلبه الذي فتحه دوماً للمحبة والنبل خانه، فدخلنا في متاهة عمليات القلب والاكتئاب والفقد والخذلان، وكان الموت أقرب”.
قبل أكثر من أربعين عاماً تعرف الكاتب حسن م يوسف على عبد اللطيف عبد الحميد بعد تخرجه في معهد “الفغيك” السينمائي في موسكو، يقول يوسف: “أول ما لفت انتباهي بـ”لطيف” كما كنتُ أسميه هو أنه كان لطيفاً جداً، فضحكته خجولة وقد تنتهي بدمعة، ودمعته بيضاء قد تتحول إلى ضحكة طيبة في أي لحظة، وعندما شاهدتُ الأفلام التي أخرجها أثناء الدراسة في موسكو أحسستُ أنني أمام مبدع ذي خصوصية واضحة، ومنذ ذلك اليوم لم يتوقف لحظة عن ادهاشي، حيث كان شغفه الفن السينمائي وحب البشر، فقدّم خمسة عشر عالماً مختلفاً في أفلامه الطويلة، وظل محافظاً على نقاء أسلوبه الإبداعي واستمراريته”، ويضيف يوسف: “أدرك لطيف منذ اللحظة الأولى خصوصية السينما كفنّ وصناعة وتجارة، فأفلامه تكاد تكون هي الوحيدة التي تسترد تكاليفها وتحقق ربحاً أو بعض ربح، وهذا ما حوّل اسمه إلى علامة فارقة تسكن وجدان كلّ من يحب هذا الفن الساحر، ومن المعروف عنه أنه كان يكتب سيناريوهات أفلامه بنفسه، لكنه بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به عقب رحيل رفيقة عمره لاريسا دخل في شراكة إبداعية مع الشاعر والروائي عادل محمود، فكتبا معاً فيلم “الطريق”، وقد أهداه له ولروح رفيقة عمره لاريسا اللذين رحلا قبل أن يشاهداه”.
ووصف الأستاذ مراد شاهين مدير عام المؤسسة العام للسينما الراحل عبد اللطيف عبد الحميد بأنه شخصية لن تتكرر في تاريخ السينما السورية قائلاً: “كتب الجزء الأكبر من تاريخ السينما السورية، وعدد كبير من السوريين عرفوا السينما من أفلامه، لذلك شكّل حالة سينمائية استثنائية، وكان المخرجَ الوحيد الذي تأتي الناس لحضور أفلامه على اسمه فقط من دون الحاجة إلى وجود نجوم معه”، مؤكداً أن “المشكلة الأكبر في حياته كانت رحيل زوجته لاريسا، ومن وقتها لم تستقر حالته الصحية والنفسية، لذلك أقول دائماً إن عبد اللطيف عبد الحميد رحل برحيل لاريسا، وقد ترك لنا أعمالاً فنية جميلة ونظيفة تنمّ عن وعي عميق وثقافة واسعة، وتشفّ عن صفاء قلب ونقاء سريرة، فهو لم يكن يصنع أفلامه ويخاطب جمهوره بلغة القلب وحدها، إنما بكل عصب من أعصابه المشدودة دائماً، وقد سعى إلى تقديم أفضل ما لديه لأن الفن لم يكن بالنسبة إليه مهنة ولا هواية وإنما نمط حياة.. لقد كانت السينما بالنسبة إليه الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه والخبز الذي يقتات به.. لقد كان مجبولاً من نسيج أولئك الناس الذين مهما ارتفعت مراتبهم يظلّون على بساطتهم الأولى وانتمائهم الأصلي والوفاء العميق له وهي صفة أساسية من صفات المبدعين الحقيقيين، لذلك ظل عبد الحميد وفياً لمسقط رأسه وموطن أهله وقريته التي خرّجته ومنحته نسغها وعلامتها الفارقة”، ويختم شاهين: “سأظل أعتز دائماً بأن علاقتي بعبد اللطيف عبد الحميد لم تكن علاقة مدير بمخرج يعمل في المؤسسة التي يديرها وإنما علاقة صداقة عميقة، ملؤها المحبة والاحترام والرغبة في فعل الأفضل للمؤسسة على الرغم من فارق السن الكبير الذي كان بيننا.. إن الفنان العبقري عندما يقضي نحبه ويفنى جسده فإن روحه وصورته تظلان إلى الأبد”.
وكان الكاتب حسن سامي اليوسف صديق عبد الحميد المقرّب قد كتب حين رحيله: “غادرتني ثلاثٌ وأربعون سنةً من الصداقة اليومية.. كنت أشكو خلالها همومي إليك.. كانت هموماً صغيرة، تافهة، فلمن أشكو اليوم همّي الكبير؟ لمن أقول رحل عبد اللطيف؟ رحل الرجل الذي بكيتُ يوماً على كتفه.. من لي سواك يا رفيق عمري؟”.