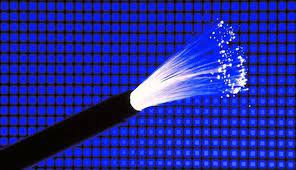التطبيع النفسي والاجتماعي
د. أمجد حامد السعود
قد يشعر البعض عند سماعه لمصطلح (التطبيع) في سياقه السياسي بالسلبية لارتباط هذا المصطلح في وجدان كثير من الشعوب العربية بالصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني، وفي حقيقة الأمر يستخدم هذا المصطلح في علوم إنسانية مختلفة وبالأخص علم النفس وعلم الاجتماع لارتباطه بالعمليات النفسية والاجتماعية التي تجعل من الفرد كائناً اجتماعياً مكتسباً لكثير من الاتجاهات النفسية والاجتماعية التي يتنمذج من خلالها سلوكه بما يتناسب مع النسق الاجتماعي الذي ينتمي إليه بمنظومته القيمية (السلبية – والإيجابية)، فإذا ما تحدثنا عن التطبيع النفسي الذي هو عملية تكيف عقلي يقوم بها الفرد عندما يتعرض بشكل متكرر لمواقف أو لأفكار كانت تسبب له شعوراً بالقلق والرفض ومع تكرارها تصبح بالنسبة له أنها طبيعية ومقبولة، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي التطبيع النفسي إلى تقبّل أمور غير صحية أو مؤذية كأمر طبيعي وهنا يتطلب الأمر تدخلاً لتغيير هذا النمط من التفكير.
هذه العمليات الحيوية في تشكّل شخصية الفرد والتي تبدأ بالضرورة من قبل الأسرة التي يتواجد بها الفرد خاضعةً للكثير من الشحن الانفعالي والعاطفي ذو الأثر المديد في تكوين شخصيته فهو يترجم هذا الشحن على أرض الواقع على شكل سلوك، ولا شك بأن عملية تطبيع الفرد هي عملية مشابهة لعملية التنشئة للفرد والتي من أهم سماتها أنها عملية مستمرة طوال حياته لا تتوقف أبداً بمختلف مناحي الحياة المجتمعية الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية ومرتبطة بالضرورة بديناميات المجتمع وتغيراته وتأثره بما يُسوّق له من مفرزات الحداثة وما بعدها، ولذلك كثير من الأحيان نسمع عن أسر أنها لم تقصر في تنشئتها لأبنائها وزرع منظومات القيم الإيجابية على الإطلاق ومن ثم ومع تقدمه بالعمر يتحول سلوكه إلى سلوك سلبي تماماً، هذا التحول مردّه إلى ديمومة عملية التطبيع والتنشئة بحياة الفرد وارتباطها بمؤسسات مجتمعية أخرى مختلفة عن الأسرة كالمؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية والدينية والثقافية…إلخ.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا في مجتمعنا السوري بالخصوص هل مؤسساتنا فاعلة في مجتمعنا لمواجهة مفرزات الحداثة وما بعدها من نماذج غربية خصوصاً وأن المجتمعات العربية بصفة عامة إلى الآن لم تصل إلى مرحلة الكينونة الحداثية بما يتناسب مع بنيتها الاجتماعية؟
وبنظرة موضوعية لواقع المجتمعات العربية عامة ومجتمعنا السوري خاصة وما يعانيه من احتراق نفسي وإنهاك للحوامل الاجتماعية نتيجة مفرزات الحرب الإرهابية الشرسة التي مورست ضده مع ضرورة الإشارة وبنظرة سيوسيو-تاريخية إلى أننا مجتمعات خارجة من أتون وبراثن حقب استعمارية طويلة الأمد نجد هذا الحنين الذي تلمسه من قبل المجتمع السوري لأيام ما قبل الحرب ليس لأننا كنا في حالة مجتمعية مثالية على الإطلاق وهذا ما أشار إليه الرفيق الأمين العام بأن كثير من مشكلاتنا الحالية مصدّر من الخارج وكثير منها مصنّع في الداخل، ويمكن تفسير هذا الشعور الإنساني بالحنين لتلك الفترة بأنه حالة نكوص نحو “الاستاتيكا” التي كنا نرقد بها والتي بطبيعتها توفر حالة مؤقتة وحد أدنى من السكينة، هذا الواقع وهذا التطبيع النفسي السلبي قد يكرّس واقع الاستكانة والهزيمة خصوصاً وأن من يستهدفنا يعلم تماماً بتفاصيل مجتمعاتنا فتجدهم يزيدوا من الضغوط الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الفرد في المجتمع السوري حالياً والتي قد تجعله في مواضع معينة يقبع تحت هالة الخضوع من أجل الخلاص من هذا الواقع المرير. والسؤال هنا من يتحمل مسؤولية تحصين الفرد في المجتمع السوري من هذا التطبيع النفسي الاجتماعي والتسليم بالانحدار الذي يسير به المجتمع وبشكل خاص اجتماعياً واقتصادياً؟
لا شك في أن الرؤى الإستراتيجية واضحة المعالم والأهداف والمحددة بجدولة زمنية دقيقة هي نقطة البداية في مواجهة أي أزمة تعيشها المجتمعات، وتأتي بعدها السياسات كأداة مرنة تمارسها المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن مسألة تنشئة وتطبيع الفرد نفساً واجتماعياً كالأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والدينية والثقافية ومنصات التواصل الاجتماعي التي أصبح لها الدور الأكبر في هذا الوقت في عملية تلقي الفرد للمكتسبات، فإن لم تكن تلك المؤسسات تمارس سياسات صحيحة من أجل تنفيذ تلك الرؤى الإستراتيجية فإن الفرد في مجتمعنا سيبقى حبيساً للتطبيع النفسي والاجتماعي الذي يريده الغرب لنا بما يضخه من عوامل جذب واستقطاب براقة المظهر خبيثة المضمون لا تتناسب مع الأطر والبنى الاجتماعية لدينا وذلك بما يمتلكه من وسائل قوة نافذة كالإعلام والميديا والتكنولوجيا والانترنت…إلخ، ولابدّ لمؤسساتنا أن تعي بأن السيرورة السوسيو- تاريخية للانتقال من جيل إلى آخر لم تعد كما كان عليه الحال سابقاً وهذا أحد نتائج ومفرزات الحداثة وما بعدها، فالجيل سابقاً يقدّر متوسط عمره مابين (40 – 50) سنة لكل جيل، ولكن التغيرات المتسارعة والخطيرة التي جسدتها الحداثة وما بعدها واخترقت بها المجتمعات وأثرت على بناها الاجتماعية قد اختزلت الزمن وأصبح من الممكن أن يتكون لدينا مكتسبات جديدة على مستوى منظومات القيم والمكتسبات الاجتماعية لجيل جديد كل خمس أو عشرة سنوات، هذه الحالة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تطبيع فرد نفسياً واجتماعياً يتمتع بقابلية واستعداد لقبول نماذج لإنجازات عصرية نوعية محلية غير مستوردة على المستويات المجتمعية كافة، وجود مثل هذه النماذج من شأنه أن يُطفئ على المستوى النفسي والاجتماعي المستحيل واللا قدرة في نفوس الأفراد. وبمقاربة بسيطة لما تحدث به الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في كلمته الأخيرة أمام أعضاء مجلس الشعب عن مسألة التطبيع النفسي على المستوى السياسي وكيف تمّ كسر هالة اللا قدرة والمستحيل خلال ساعات قليلة من انتصارات حققتها المقاومة في صراعها مع الكيان الصهيوني والتي قد أعادت الروح والنمذجة الإيجابية للقدرة في نفوس الشارع العربي.
لا شك في أن مختلف المؤسسات المجتمعية في مجتمعنا السوري ّمعنية بهذا الأمر ومن ضمنها مؤسسات حزبنا العظيم النافذة مجتمعياً بل ومطالبة بأن تبدأ بتنفيذ رؤى إستراتيجية من خلال سياسات وبرامج عمل فعليّة على أرض الواقع ذات نتائج ملموسة تهدف إلى إعادة بناء الشخصية من خلال تطبيع نفسي – اجتماعي وعمليات تدريجية يتم من خلالها دمج سلوك أو ممارسة جديدة محلية غير مألوفة سابقاً تحمل مقاصد وطنية تعيد ضبط البوصلة العقلية لدى الأفراد وبالأخص الشباب نحو تطبيع اجتماعي بسياقاتهم الاجتماعية من خلال ما تقدمه مؤسسات المجتمع النافذة وفي مقدمتها الإعلام المرئي والسوشال ميديا والشخصيات المؤثرة مجتمعياً دينياً وثقافياً وسياسياً وفنياً ..إلخ، وأن يكون ما يتم العمل عليه متناسب مع بنيتنا الاجتماعية بروح العصر وبعوامل جذب واستقطاب لا تقلّ أهمية أبداً عما يقدمه الغرب بوسائله النافذة لتحقيق غايات ومقاصد وتطبيع نفسي واجتماعي سلبي يخدمه ويجعل من مجتمعاتنا مجتمعات فوضوية فاشلة مستلبة الهوية الاجتماعية، وإلا فإننا سنبقى رهن المبادرات الفردية التي قد تكون أشبه بمسكنات ألم وليست حلّ جذري للمشكلة.