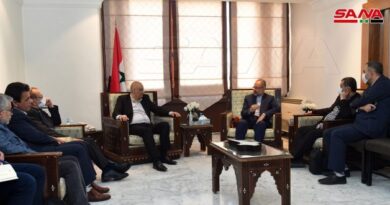في الاستشراق المضمر… القدس خلال العصور
أ. د. عبد النبي اصطيف
قد يختلف الباحثون في تعريف مصطلح “الاستشراق”، وفي تحديد طبيعته ووظيفته، وفي توصيف علاقاته المادية والمعنوية التي يقيمها مع منتجِه ومع موضوعه. ولكن ثمة ما يشبه الإجماع على أنه ضرب من المعرفة يُنتِجه الآخر (غير الشرقي في الغالب) عن الشرق وأهله: تاريخاً وثقافةً ومجتمعات، وأن هذه المعرفة تُوَظَّف، سواء أتم هذا التوظيف بِعلم مُنتجيها وإقرارهم أم لا، في تدبُّر الشرق: استعماراً، وهيمنة، واستغلال خيرات وثروات، وتأمين مصالح: والإبقاء على تبعية للغرب والانضواء تحت لوائه، وليس أدلّ على صحة هذه الإجماع ما نشهده من عيش الشرق وأهله، في مختلف وجوه حياتهم، في ظل التركة الاستعمارية، وتحوّل الغرب، المستعمِر السابِق، إلى الأنموذج الذي يُحتذى في كل شيء، حتى غدا المِثال والمآل.
والاستشراق الصهيوني لا يختلف عامة، في طبيعته ووظيفته وحدوده، عن الاستشراق الغربي، وإن كانت له خصوصيته المتصلة بموضوعه الذي يحكم إلى حد بعيد وظيفته – ذلك أن موضوعه هو “الشرق” الذي قد يضيق، حتى تقتصر حدودُه على فلسطين التاريخية، ويتسع ليشمل الوطن العربي (الممتد بين دول الطوق المحيطة بفلسطين، ودول الأطراف شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً) والعالم الإسلامي برمته.
وفلسطين التاريخية، التي هي موضوعه في حدوده الدنيا، ليست مجرد مستعمَرة ينهب المستوطنون خيراتها، ويحكمون أهلها، ويحددون مصائرهم فيها، بل هي “وطن موعود” فيما يزعمه هذا “المستعمر” – “الطفرة القميئة في تاريخ الإنسانية، القادِم بدايةً مُمَوَّهاً بثياب اللاجئ، بل هي أرض بلا شعب، وقومُه، الذين جاؤوا من كل حدب وصوب، شعب بلا أرض، ولذلك فإن عليه أن يُطهِّرها من ساكنيها، أو يُنكِر وجودهم أصلاً، حتى يُبعد عن نفسه شُبهةَ استعمارها، إنه يعمر صحراء قاحلةً ويحوّلها إلى جنة موعودة، فيؤدي بذلك رسالة إلهية، إذ يجمع فيها كل المنفيين من يهود العالم لتكون وطناً قومياً، وعدهم الله بها منذ الأزل، وأكّد لهم هذا الوعد اللورد بلفور عام 1917. إنهم يستعيدون “أرض إسرائيل”، إذ يعودون إليها بعد نفيهم لقرون منها. هذا هو هدفهم. غير أن عليهم، حتى يكفلوا النجاح في تحقيقه، أن يوظِّفوا المعرفة الاستشراقية، والمعرفة قوّة، مِظلّة يستظلون بها في مسعاهم لاستئصال سكانها الأصليين، ويعمّون ضحاياهم عن هذا المسعى.
ويبدو أن ثمة فئة قليلة، أو أفراداً، اختاروا لغاية في أنفسهم، ولحوافز قبلوا بها، أن يكونوا مُنتِجين لضرب منها يُرضي سادَتهم وسادَتها. وأكثر من هذا فإنهم اختاروا لأنفسهم إنتاج ذلك الضرب المُضمَر latent من الاستشراق، ضرب غير مباشر ولكنه مُبتذَل في آن معاً، لأن أصحابه تخلَّوا عن هدف السعي المعرفي، وهو بلوغ الحقيقة، لصالح قضية مفبركة أريد لها أن تكون المظلة التي تغطي جريمة التطهير العرقي التي ارتكبوها بمساعدة الاستعمارين القديم والجديد.
وإذا ما تطرّق الحديث إلى تاريخ مدينة “القدس”، التي أجمع العالم كله على أنها إحدى أقدم مدنه وأقدسها، وأنها بالنسبة للمسلمين أولى القبلتين، وثالث الحرمين، فضلاً على أنها كانت مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تضم مسجد قبة الصخرة التي عرج منها إلى سدرة المنتهى، فإنه في محاولة للتشكيك في طابع المدينة الإسلامي، وزعزعة انتمائها العربي، يقصر الحضور العربي الإسلامي فيها على فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة قرون، ومن ثَمَّ فإنها تكاد ألّا تُذكر على نحو جدي في مسيرة تاريخها الطويل الممتد خمسة آلاف عام أو يزيد، من بُناتها الأوائل (اليبوسيين) وحتى استسلامها لصلاح الدين الأيوبي في 19 من شهر أيلول / سبتمبر عام 1187، وإخلائها تماماً من جانب الفرنجة في 10 تشرين الثاني من العام نفسه، بعد احتلالها ثمانية وثمانين عاماً. وهو ما نجده في أحدث تاريخ للمدينة ظهر في كتاب نشرته مطبعة جامعة أكسفورد في آذار الماضي من هذا العام 2024، وحمل عنوان: القدس خلال العصور من بداياتها إلى حروب الفرنجة، لجودي ماغنس، أستاذة اليهودية المبكرة في جامعة نورث كارولاينا، في تشابل هيل. فهذا الكتاب، الذي يقع في 624 صفحة، موزع على مدخل وأحد عشر فصلاً وخاتمة وملحق (أريد له أن يكون ترويجاً لزيارة المدينة المقدسة لغير العرب والمسلمين، بمن فيهم الفلسطينيون أصحاب الأرض السليبة) خصص خمسة منها لمستكشفي المدينة المقدسة من علماء الآثار الغربيين، ولاسيما اليهود الصهاينة منهم، ولأربع فترات قصيرة نسبياً ساد فيها بنو إسرائيل واليهود، في حين لم يظفر اليبوسيون، أو الكنعانيون، الذين عمروا المدينة بعد تأسيسها نحوا من ألفي عام، وكذلك المسلمون الذين سادوا فيها نحوا من أحد عشر قرناً، إلا بفصلين، غلبت على إنشائهما المصطلحات والأسماء العبرية والمستمدة من التوراة، حتى في الفترة اليبوسية الممتدة ألفي عام أو يزيد.
ومما يلاحظه المرء من خلال ما تقدم من إيجاز عن كتاب ماغنس، وأنه على الرغم من أن الأدلة الموثقة على بناء مدينة القدس على أيدي اليبوسيين / الكنعانيين، الذين عمروها، كما تقدم، نحوا من ألفي عام، وعلى الرغم من الحضور العربي الإسلامي فيها نحوا من أربعة قرون قبل غزو الفرنجة، ونحوا من سبعة قرون بعد دحرهم منها، مما هو مُقَرّ به على نحو واسع في أوساط كبار العلماء المختصين، بل مما هو مجمع عليه حتى في الأوساط العلمية الغربية، فإن نزعة التمركز حول الذات الغربية، والعنصرية، تغري بعض متعالِميها بمحاولة الالتفاف على حقائق التاريخ الحضاري الإنساني، واختزال حضور “الآخر”، وهو “الأنا” المؤسس للمدينة ومن عمرها ألفي سنة، والعربي/المسلم بشكل خاص، إلى مجرد حضور محدود متواضع، وذلك بوضعه في إطار واسع جداً، يُضائل من شأنه لصالح جهات، أو أطراف، أو أمم أخرى، وعندها يكتفي بذكره على طريقة “مرور الكرام”.