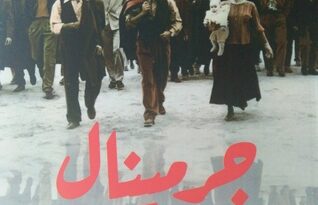مع تراجع العمل به ملف التعقب الأسري.. من “لم الشمل” إلى “وثيقة رصد وإبلاغ حالة” وحسب!!
تراجع العمل بملف التعقب الأسري الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الحرب، وبقي ثابتاً عند الرقم 47 الدال على عدد الأطفال العائدين إلى أهاليهم بعد أن شردتهم الحرب، ورغم أهمية المشروع وضرورته، بات من وجهة نظر “الشؤون” وباعترافها غير ضروري، فوسعت، بمحاولة فاشلة منها، دائرة الاهتمام بالموضوع، ليبقى الحال على وضعه باستثناء الانتقال من مسمى التعقب الأسري ولم الشمل إلى ما يسمى وثيقة رصد وإبلاغ حالة.
توقف غير مبرر
“البعث” كانت متابعة للمشروع من بداية انطلاقته، حيث كان السؤال عن التعقب ومشاكله، وأسباب توقفه، وعدم الترويج له بشكل كاف، وبالتالي عدم تقدمه أية خطوة تذكر، حاضراً بشكل دائم، ليأتي الجواب من أروقة الوزارة ومن مكاتبها المسؤولة بأن لا جديد في هذا الموضوع ، لتبقى مدينة حمص التي انطلق منها مهده ولحده، مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء ميداني دافعت عما تقوم به “الشؤون”، وبيّنت أن التعقب الأسري ولم الشمل الذي يحدث في حالات النزوح الفجائي لم يبدأ بالتزامن مع الحرب، بل جاء نتيجة تزايد عدد الأطفال المفقودين، وانفصالهم عن ذويهم الذي كانت له أسباب متعددة، وفي عام 2014 بدأ هذا المشروع بين اليونيسيف ومديرية الشؤون بحمص على اعتبار أن المدينة شهدت مظاهر خروج ونزوح جماعية، وظهرت الحالات بشكل واضح، ما حتم ضرورة وجوده، وبعدها أخذت الوزارة مخرجاته في عام 2016، وحسب تقرير المديرية تمكنوا من لم شمل 47 طفلاً، وهي إحدى الحالات التي تابعتها الوزارة.
وفي الوقت الذي نشهد يومياً مظاهر لأطفال متسولين ومشردين بالجملة إلى جانب اعتبار بعض المناطق ساخنة إلى حد ما، فإن مديرة الخدمات، من وجهة نظرها، أنه لم يعد للتعقب الأسري حاجة أو ضرورة، لذلك تطور إلى ما يسمى وثيقة رصد وإبلاغ حالة، إلا أن ما قالته ميداني لم يلق الترحيب عند الدكتور محمد عبد الله، مدرّس بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب، واستغرب حديث مديرة الخدمات، مشدداً على أن التعقب الأسري مشروع رائد لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتوقف أو يتوه عن بوصلته، فهو ليس جديداً على العالم، بل قديم ويعود لزمن الحرب العالمية الأولى والثانية، والحروب في اسبانيا وايطاليا وبريطانيا وروسيا وأمريكا، وعرفته كل هذه الشعوب، وتجذر فيها، إذ كانوا يتعقبون الأطفال الذين مرت عليهم ظروف وأزمات بلادهم، وشردوا على إثرها، ما يدل على أهميته، وضرورة تطور أدواته وآلياته، على عكس ما تقوم به الوزارة حالياً.
التفاف
على ما يبدو “تشاطرت” الشؤون على التعقب، فوسعت دائرته كمصطلح وعمل، دون أن نعرف، رغم طرحنا السؤال، كيف تم الاهتمام بجزئية الأطفال ممن شردتهم الحرب، لأنه، وللإنصاف، وثيقة الرصد والإحالة التي تعتبر مخاض التعقب الأسري مهمة للغاية، إلا أنها أضاعت البوصلة عن الغاية الأساسية، مديرة الخدمات أوضحت أن الوثيقة عملت عليها هيئة شؤون الأسرة والسكان مع لجنة وطنية، وقامت برفعها لرئاسة مجلس الوزراء، وتم الحصول على الموافقة لتكون أساس عمل الوزارة، بحيث تتعامل مع حماية الطفل، وتشمل 9 حالات تندرج تحت هذا المعنى، ولا تشمل تعقب أطفال الحرب فقط، ليتطور الملف بعد ذلك لدليل نظام إدارة الحالة الذي وصفته ميداني بالمفيد جداً للشؤون باعتباره سيكون أداة بين يديها، كما تمت الموافقة من قبل رئاسة مجلس الوزراء على الآلية، وتم إنجاز الاستمارة، والدليل التدريبي، كما وسعت دائرة المشروع لتشمل البالغين المشردين، وكبار السن، والنساء المعنّفات، وجميع الفئات التي تحتاج حماية، مضيفة بأن التعقب الأسري لم يتوقف، بل هو أداة عند الجمعيات.
عداوة الرقم
ولتبرير ما قامت به الشؤون، ودفاعاً عن قناعاتها بذلك، أوضحت ميداني أن الفكرة ليست فقط بإيجاد الطفل، بل تكمن الأهمية بالخطوة اللاحقة، وما تلاقيه من صعوبة في التعامل مع الطفل، واستنطاقه في حال لا يتكلم نتيجة ما مر به من ظروف، أما فيما يتعلق بإحصائيات تشير إلى عدد الأطفال الذين تم لم شملهم، بغض النظر عن أسباب فقدهم لأهاليهم، لم يرق السؤال لمديرة الخدمات، حيث لم تستطع إخفاء انزعاجها وامتعاضها من السؤال قائلة: لا تسألونا عن الإحصائيات، لأن الرقم الإحصائي يجب أن يكون بعد دراسة شاملة، وتنفيذ مسح وعينة، أما إعطاء رقم خلال هذه الجلسة فهو غير منطقي، فالوزارة معنية بجمع الأرقام وتصديرها للحكومة للإعلان عنها بشكل رسمي، وما يحدث أننا متابعون للتعقب الأسري كأداة عند جميع الجمعيات، ومنها على سبيل المثال جمعية حقوق الطفل، إذ تم توقيع اتفاقية شراكة، وعلى إثرها تم تسليم معهدين لوضع الأطفال المشردين والمتسولين، إلى جانب عملها كتعقب أسري ليتم التواصل بين الطرفين في حال الوصول لأية حالة، مبيّنة أنه بعد توسع المشروع ليشمل الأطفال الذين فروا من أهاليهم بسبب شجار ما، أو تعنيف، باتت الوزارة لا تعطي رقماً إجمالياً إلا بعد دراسة منطقية ومنهجية، بحيث تتابع التقارير الصادرة عن الجمعيات التي تتضمن عدداً من الأطفال بمختلف الحالات، كما لا يمكن تصدير رقم كبير قد يحدث بلبلة وضجة، وهو غير موجود على حد تعبيرها مضيفة: “لا نريد أن نقول إن المشروع توقف، لأن ذلك غير منطقي، فالوزارة أصبحت تعمل ضمن تركيب منهجي، بمعنى المهم والأهم، ووضعت سياسة اجتماعية للعمل من خلالها”، بدوره بيّن الدكتور عبد الله أن ثمار العمل والـ 47 طفلاً تم لمّ شملهم خلال فترة الحرب قليلة جداً وخجولة، فالجميع يعلم حقيقة أن الأزمة شردت الكثير، وكان حريّاً بالوزارة الحصول على نتائج أفضل، والتشبيك مع نظيرتها الإدارة المحلية، ومجالسها في المحافظات، والوجهاء، والعشائر، والمعلمين، والمؤسسات العسكرية، وكذلك الشرطة للبحث عن الأطفال، وبالتالي الحصول على أرقام.
احتكار وزاري
ورغم أهمية المشروع وضرورة وجود شريك حقيقي يعي كيفية التعامل مع مجتمع عانى ويلات الحرب، مازالت الشؤون تصر على “احتكار” التعقب الأسري لصالحها، وهذا ما يشي به الملف، فهو خال حتى اللحظة من أي تعاون مع وزارة الإدارة المحلية، رغم أنها شريك مهم، إن أرادت الشؤون، إضافة لجهل الشارع بالمشروع، فمنذ انطلاقه لم نر أي إعلان عنه بأية وسيلة، ولم نشهد سلسلة حلقات تلفزيونية تتحدث عنه، إلى جانب جهل الدكاترة في كلية الآداب بوجود هكذا مشروع، فالدكتورة شفاء مصري، “كلية الآداب قسم علم الاجتماع”، أكدت أنها تجهل وجوده في سورية تماماً، إضافة لزملائها ممن التقيناهم بغرفة الهيئة التدريسية، بدورها أكدت مديرة الخدمات أنه لا يوجد أي تعاون مع الأكاديميين باستثناء رئيس هيئة شؤون الأسرة الدكتور أكرم القش، معيد بقسم علم الاجتماع وهو يترأس اللجنة التي أقرت العمل بالتعقب الأسري، والمتضمنة عدداً من الوزراء، وهنا كان للدكتور عبد الله ردة فعل جرّاء عدم التعاون مفادها أن الأكاديميين ربما يشكّلون خطراً على القائمين في وزارة الشؤون لأنهم سيأخذون من وجهة نظرهم الأماكن والقرار، لذلك لا يستعينون بهم، فالربط بين الطرفين ليس عيباً ولا تقصيراً على حد تعبيره، بل التعاون في جميع مؤسسات الدولة للتقصي والبحث عن الأطفال مهمة الجميع كي لا يذهبوا لأحضان الغير، وما لذلك من تداعيات كتجنيدهم والإتجار بأعضائهم، فمؤسسات الدولة قادرة على احتضانهم، موضحاً أن هناك أكثر من طريقة للوصول إليهم كالإعلانات ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمكتوبة، والترويج للموضوع، إضافة للمسؤولين في المحافظات، والإدارة المحلية، والأكاديميين الكبار عبر الندوات والمحاضرات.
قرار لا اختيار
ومع أن الدكتور عبد الله لم يلق باللوم على وزارة الشؤون، عازياً ذلك إلى صعوبات قد تكون واجهتها الوزارة، لكنه في الوقت ذاته عدها المعني الأول والأخير بالتعقب الأسري ولم الشمل، منوّهاً إلى ضرورة توفر كوادر مؤهلة لديها من أجل الدعم النفسي والاجتماعي للطفل، والبحث عنه عوضاً عن الكلام، وإعطاء المثاليات، والتصريح في وسائل الإعلام المختلفة، ولابد من الخروج للميدان والبحث عنهم بطرق مختلفة، ورأى أن مشروع التعقب الأسري يجب أن يقوده أكاديميون أساتذة من الجامعات السورية، وخاصة من كلية الآداب قسم علم الاجتماع، ومن كلية التربية من أجل تزويد الطفل بالدعم النفسي والاجتماعي ليصبح فيما بعد رجلاً له مكانة ووزن، ويساهم في عملية البناء والتطوير في بلده، وفيما يخص المنظمات الدولية، ومدى أهمية الدور الذي قد تلعبه، فإن عبد الله كانت له وجهة نظر أخرى، إذ وصف التعاون معهم بسلاح ذي حدين، متخوفاً من أن تكون لهم أهداف قد تكون بعيدة أو مشاريع، مستغرباً من عدم الاعتماد على النفس، والمنظمات الحكومية والأهلية، برأيه، قادرة على البحث والتقصي إلى جانب الأهالي والوجهاء الذين بإمكانهم أيضاً أن يلعبوا دوراً هاماً، وهذا أفضل من إلقاء اللوم على الآخرين، في الوقت الذي نتكاسل ونتباطأ عن مهامنا، والقول للدكتور، في وقت شدد على ضرورة أن يكون الكادر التأهيلي من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأطفال ممن أصيبوا بحالات خاصة جراء مشاهدات الحرب كالخوف، وصعوبات النطق، وحتى البكم، وهذا لا يأتي من فراغ، بل عبر المتخصصين بعلم الاجتماع، والتربية، والسيكولوجيا، أي علم النفس، فالوصول للأطفال على حد تعبيره لا يكفي، فالمرحلة التي تليها مهمة جداً، ولا تقل عن أهمية إيجادهم، لاسيما مع معاناتهم من الخوف والقلق وويلات الحرب.
مقترحات
تشكيل فريق عمل مكوّن من أساتذة بقسم علم الاجتماع، والتربية، وعلم النفس، يرفد وزارة الشؤون، ويقوم بمهمة التقصي وتعقب الأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب، أهم الاقتراحات التي خلص إليها الدكتور عبد الله، إضافة لإقامة ندوات تلفزيونية تقوم باستضافة متخصصين على مرأى القطر بعد التشبيك مع وزارة الإعلام، والشؤون، والجامعة، ومتخصصين أكاديميين لتعريف الناس بهذه الظاهرة، خاصة أن الكثير من الناس وحتى المتعلّمين يجهلون ماهية المشروع وحتى وجوده، إضافة لضرورة إحداث مراكز تأهيل لأطفال الحرب والمفقودين لتعليمهم وتأهيلهم، ومن ضمنها مراكز صحية ومهنية.
نجوى عيدة