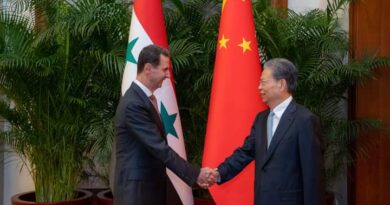في مديح السوداوية!؟
د. نهلة عيسى
يتهم البعض مقالاتي بالسوداوية, وبأنها على حد قولهم تثير الكثير من الوحشة في نفس من يقرأها, وقد استجبت مرات لهذه الاتهامات, وقلت: أنا أكتب الحقيقي وليس المثالي, أكتب ما يجري في دمي, ويرتطم بروحي بلا هوادة, بطريقة يستحيل معها اقتلاعه أو تجاوزه أو حتى التصالح معه بدون وضع الأصبع على الجرح, أو على الأقل الإخبار عن الجرح, لعلي بذلك أكون منادياً يستدرج سامعاً وربما مؤيداً, أو يستنفر طبيباً معالجاً.
سوداوية؟ ربما اتهامهم ليس عارياً من الصحة, وربما هم فقط يلامسون سطح ما أقول فيجدونه خشناً, فيخافون أن تنتقل إليهم عدوى وجع أخفيه بالعري الفاضح, لأحتفظ للحزن بكبريائه, ولا أظن أنني مضطرة, أو من واجبي إصدار نشرة عن طقسي النفسي, وكيف أتلمس الوقائع من حولي, توزع إلى “من يهمه الأمر” في الصالونات المكيفة, تملقاً واستجداءً للتأييد الاجتماعي, لأضيف حدثاً بائساً آخر إلى أحداث أيامنا المجللة بالستائر الكاتمة للنور!.
سوداوية؟ لا مانع لدي من القول: ربما!؟ فأنا لا أنام في اليوم سوى ساعتين, وأصحو كالملدوغة مثلكم جميعاً لأبدأ جحيمي اليومي, لئلا تراق القطرات الأخيرة من ماء الوجه, ولستر شقوق تتسع يوماً بعد يوم في نسيج كراماتنا, محاضرات “بالشوالات”, امتحانات مستديمة, إمضاءات, مراجعات, اجتماعات, نقاشات حادة على الصواب وعلى الخطأ, ومشاجرات حتى على ركن السيارة, وادعاءات متواصلة بفرح لقيا بشر لديهم الكثير من الوقت, فيرتشفون أعصابي ووقتي قهوة, وثرثرة, وطلبات, وحرد أنني لا أرد الزيارات, وحسد مبطن أنني أبدو بخير, وأنني على قدميّ ما زلت أسير!.
سوداوية أنا؟ (كليشيه) شبيهة بالمقصلة تطالني وتطال من يرفع الصوت بأن تشارك الآه في البلاد مع العباد هو نوع من التصبر, وفعل مقاومة, وقرع جرس لئلا يصدأ الجرس, فيشيخ الغد بانتظار أن يكون غداً, ليُسوق الخوف من الحقيقة, وتُعوم الأخطاء, وتنزع مخالب الجرأة, وتقص أجنحة الحلم, وتغطى بحروف بيضاء محايدة, منشاة, خانقة, كياقات قمصان السهرات, حيث الإيهام بالفخامة والأهمية هدفاً, بغض النظر عن حال المشنوق والمخنوق بها.
سوداوية, بات اتهاماً مطاطاً, لجداول لامتناهية من المحظورات والحواجز الكلامية والعملية, التي يضاف إليها كل يوم عشرات البنود الجديدة, الممنوع مناقشتها أو التساؤل عنها, والتي تلغي وتجرم كل إشارات التعجب والاستفهام, بل حتى التأوه والأنين, والصدق مع الذات والآخرين والوطن, لدفعي, بل دفعنا جميعاً للتساقط عن شجرة الصدق واحداً تلو الآخر بعدما تم قنصنا كالعصافير, لأننا لا نراعي من يريدون النوم على حرير بأن الغد يولد كما الجنين “ورزقه معه”!؟
سوداوية!؟ ماذا يفعل أمثالي ممن فشلوا ببيع رؤوسهم لنشرات الأخبار, وتخلوا عن كل إغراء في الدنيا, سوى إغراء العلن, إغراء النور, بجد, ماذا يفعل أمثالي, الذين يرون في الصدق سفينة نوح, أو على الأقل أنبوبة أكسجين, تخفف من تلاحق وتهدج أنفاس الوطن, وتخفف من ازرقاق جلده, وتعيد لوجهه بعض النضارة والحيوية, وترسم خطاً فاصلاً بين صواريخ العدو, ومدافع الصديق, وبين الموت ذوداً عن الوطن, والموت كمداً من تجاره, وأسعاره, ومعلقات التجلد التي تتالى على أسماعنا, دون أن تقول لنا إلى متى وكيف؟.
ماذا يفعل أمثالي ممن في قلوبهم جمر, وعلى ألسنتهم أسئلة برسم الوأد بفعل رصاص بندقية تترصد السؤال والحنجرة, ولا تتورع عن الوقوف بخشوع متقن, في السرادقات لتلقي العزاء بالسؤال والسائلين, لأن موتهم متطلب المرحلة!؟ وسط طوفان من التبجح, والمزايدات الوطنية, والقصائد (الشاعرية) التي يتغنى ويتغزل أصحابها بخرابنا وآلامنا, ويجدون تفسيراً (جمالياً) لكل القبح الذي نعيشه, والقيح الذي نتجرعه, والقلق الكابوسي على الوطن ومن فيه؟ صدقوني: ضاق الخيار, وشعرة “معاوية” انقطعت ألف مرة ومرة, وقصصت شعري, ووصلته ألف مرة ومرة, وكل مرة أجد نفسي أمام سؤال, تصرون أن لا أجيب عليه, وإذا تمردت, قلتم: سوداوية, والحقيقة فقط أنني حنجرة الناس, وقارعة جرس, ومن قال: أن وقع صوت الجرس جميل على أسماع النائمين؟!.