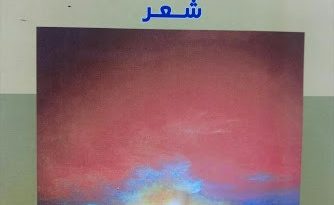ذكرى غياب محمد الماغوط.. مرور خافت لهدير نيزك سوري مايزال مشتعلاً !…
إنه الموت وضجيجه الصاخب مرة أخرى، يطغى بأنين أصوات البسطاء والمقهورين على ذكرى غياب “محمد الماغوط” هذا العام أيضاً، فالصخب والعنف الذي يدور في بلاده، لا بد وأن جعله يتململ في قبره، مرة من شدة الألم على ما يحدث في بلاد ترك روحه تهيم فوق ثراها على اختلاف تقلباتها “من فرح قليل إلى قهر وحزن/ ومن حب عاصف إلى خيبة رافقته كذراعه”، ومرة من السرور ربما، لأنه ليس فوق التراب ليرى ما نراه ونعاني ما نعانيه، بل تحته يبكينا بصمت.. إنها ذكرى الماغوط أيها السادة، مرور خافت لهدير نيزك سوري..مازال مشتعلاً..
بين (حزن في ضوء القمر) 1959 و(البدوي الأحمر)، حيوات مرت متقلبة على يقين الظنون، وخيبة الرجاء، إذ لم يدرك الفتى العائد من ثانوية خرابو الزراعية في غوطة دمشق إلى مدينته السلمية، بعد أن أحرجته رسالة والده الفلاح الفقير إلى مدرسته ليرأفوا بابنه، بأنه سيكون من روّاد خميس الشعر الأكثر جدلاً وإثارة؛ خصوصاً في الفترة التي احتدمت فيها معركة المصطلحات الشعرية التي بدأتها الشاعرة العراقية نازك الملائكة برفضها تسمية قصيدة النثر، معتبرة أن ما ينشر في مجلة شعر هو ما أسمته الشعر الحر، مستخدمة قصائد الماغوط دون غيره من شعراء المجلة في محاججتها الشعرية.. أدار صاحب ديوان “حزن في ضوء القمر” ظهره لكل تلك المهاترات “الفاضية” كما كان يسميها، مؤثراً أن ينحت الكلام من الهواء والماء والطيور والأشجار والنساء والخمر، بأسلوب شعري فريد ومتميز، إن كان بالسرد اللغوي الذي جاء عنده عفوياً وتلقائياً، بعيداً عن التصنع والثرثرة الفائضة عن الحاجة، أو بطريقته المدهشة بإنزال الشعر من مراميه الفلسفية وأبعاده الماورائية وجدله البيزنطي، إلى حرارة الحياة اليومية بكل تفاصيلها، بألفتها وقسوتها، بفرحها وحزنها، بضجرها ودهشتها؛ لتأتي مجموعته الشعرية الأولى “حزن في ضوء القمر” تتويجاً للحالة الشعرية العالية التي كان يحياها بعيداً عن صخب الكلمات الطنانة، ولتصبح حديث مجلة شعر والعديد من الدوريات الثقافية والفكرية التي أرعبها ذهولها ووقوعها قي غرام هذا الكلام البسيط والمدهش في آن.. أحدثت تلك المجموعة الشعرية الرائعة لشاب مغمور نقلة نوعية في طريقة التفكير بالشعر، وكانت بمثابة ضربة جناح قوية لطائر في فضائه بما تضمنته من قصائد امتازت بكثافة الصور الشعرية الرشيقة والمتلاحقة، كما لو أنها فيلم سينمائي يسرد شعراً بالصورة المرئية، ومن أجمل قصائد هذه المجموعة الشعرية قصيدة “القتيل” التي يقول فيها: “كانوا يكدحون طوال الليل، المومسات وذوو الأحذية المدببة، يعطرون شعورهم، ينتظرون القطار العائد من الحرب، قطار هائل وطويل كنهر من الزنوج، يئن في أحشاء الصقيع المتراكم على جثث القياصرة والموسيقيين”.
لم تكن القصيدة بالنسبة إلى صاحب “غرفة بملايين الجدران” تصدر عن وعي مباشر وإدراك حسي واعٍ، بقدر ما كانت تنبع من أعماق نهر يتفجر في داخله، تنبعث منه الكلمات والصور من رقادها في أعماقه، لتصير كائنات من لحم ودم على الورق، بتلات ورود حقيقية وخصور نساء تلمسها عيناك وأنت تقشر لحظة قراءتها كبرتقالة يسطو على عبقها الندم..
ونادراً ما كان الماغوط يعيد صياغة قصيدته بعد أن يكتبها لأول مرة؛ لأنها تولد من رحم خياله مكتملة النمو وناضجة، تاركاً للبرية التي سقت نظراته بمدى لا ينتهي أن تجتاحه، أن تتموضع فوق الورق كما يريد أو كما تريد لا فرق، ما دام يكتبها وتكتبه، يحضنها وتحضنه.. يقول هذا النبي الجديد في قصيدة “أغنية لباب توما”: “أشتهي أن أكون صفصافة قرب الكنيسة أو صليباً من الذهب على صدر عذراء تقلي السمك لحبيبها العائد من المقهى، وفي عينيها الجميلتين ترفرف حمامتان من بنفسج”.. رغم كثرة النقد اللاذع الذي تناول القصيدة الماغوطية، واتهامها بأنها تقوم على الصور المسطحة التي لا عمق فيها، وبأنها تفتقر إلى الحركة الداخلية، وأن شعره بحاجة إلى روافد جديدة من المفردات المبتكرة والصور الجديدة، إلا أن قصيدته استطاعت أن تكون القصيدة الأكثر وصولاً إلى قلوب الناس، إن كانوا من البسطاء العاديين أو من المثقفين النخبويين الذين وجدوا في الماغوط الشاعر الفرنسي”رامبو”، بصوفيته العميقة، وسرياليته المتجددة، والقوة الإيحائية المنبعثة من الطاقة الهائلة التي تولدها مفردات قصيدته من علائقها المتشابكة.
لعب محمد الماغوط بعد عودته إلى دمشق دوراً كبيراً وفعّالاً في تظهير المشهد الثقافي السوري، بمنطق ومظهر جديدين، مفارقين للسائد بكل تشعباته، إن كان في الشعر أو المسرح أو الدراما؛ فكما كان طائراً برياً في الشعر، هكذا كان شأنه في المسرح، عندما عمل على تأليف عدد من النصوص المسرحية، عمد فيها إلى تكسير كل القوالب المسرحية الجاهزة برتابتها وضجرها ولغتها الخشبية، تلك النصوص التي أعادت للمسرح ألقه وجمهوره وجعلته فن الشعب، بملامسته الحقيقية لهموم الشعب وأوجاعه بطريقة متهكمة، وساخرة، ومؤلمة حدّ الحزن، في طرحه لمواضيع لا تابوهات فيها من الديني والسياسي والجنسي، مؤمناً بحقيقة أنه لا يوجد جمهور رديء، بل يوجد فن جيد وفن رديء، والفن الجيد هو الذي يعكس نبض الشارع، ويرفع صوت صرخته عالياً، ولكم كان لتعاونه مع العملاق الفنان دريد لحام كبير الأثر في إعادة الحياة إلى مسرح نقابة العمال في العديد من الأعمال المسرحية التي مازالت حتى اليوم تتركنا مشدوهي الأبصار ونحن نتابع كيف يستطيع المبدع الحقيقي أن يستشف المستقبل، ويحذر من التشوهات الاجتماعية التي بدأت تضرب الأرضية الصلبة لسورية الجريحة اليوم، وكأني به يقول وهو يرى ما يرى: “لم نستطع تدريب إنسان عربي واحد على صعود الباص من الخلف والنزول من الأمام، فكيف نبغي تدريبه على الثورة؟”، و”أنا لا أؤمن بالثورة التي تريق الدم”.
تمام علي بركات