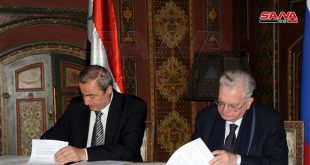في باحة المدرسة..وطن وجدت الطريق تقودني صباح اليوم إلى مدرسة ابنتي “بلقيس” أمي الصغيرة
لا أدري كيف ومتى قررت أن أزور مدرستها الابتدائية، فهذه العادة التي كانت دارجة عندما كنت في عمرها، صارت من ذكريات زمن قديم، بعد توفر الاتصالات كالجوال والانترنت وغيره.. ولم يعد هناك من يسمع عن أب غاضب من تدني مستوى ابنه الدراسي، فانفعل وعاقبه بصفعة مخزية أمام الرفاق، أو عن أم غير راضية عن أداء معلمة ابنتها. اختفت تلك الحكايات.. وكأنها لم تكن.
قبل أن أصل بلحظات سمعت أصوات الطلاب وهم يخرجون بفرح إلى الباحة.
قالت لي المستخدمة: “هكذا كان اسمها، لا أعلم إن بقي اللقب مستمراً حتى الآن إلا أن شكلها هو هو لم يتغير، مربوعة القامة، بشوشة الملامح ،رائحتها أليفة كخبز خرج للتو من الفرن”.
قالت: الطلاب في الباحة ومن المستحيل أن تجد ابنتك وسط زحام الطلبة وصخبهم وضجيج أجنحتهم الملائكية، طلبت إليها أن تنادي عليها بالميكرفون، ثم شعرت من ردة فعلها وكأني أقول لها عجباً.
طلبت إليها أن تسمح لي بالنزول إلى الباحة لأجد بلقيس بعد أن استفزني كلامها بأني لن أجدها وسط الزحام، قائلاً في قلبي إن لم أجدها أنا ستجدني هي ودون أي عناء وهذا ما حدث.
لم تمانع بعد أن أخذت بطاقتي الشخصية لحين خروجي وأخذت أيضاً حقيبتي لحرصها وخوفها بعد ما فعل الإرهاب بمدارس أبنائنا وبطفولتهم ما فعل من قتل وتدمير.
هبطت إلى الباحة كأب يريد أن يرى ابنته، وما إن وضعت قدمي داخلها، حتى عدت طالباًً، أردت أن أركض بها وأن أعطش فأذهب إلى صنابير المياه الرائعة تلك. أن اشتري من الغرفة الصغيرة التي تبيع الأطايب الشوكولا والبسكويت والعصير، كم كانت طعمتها مدهشة ذاك الزمن “سقى الله”.
أردت أن أطير في رحابها، فأردا أجنحتي أنا أيضاً، بعد أن شعرت بجناحين خفيين ظهراً في روحي فجأة.
أعادني صوت بلقيس من وهم عميق وكأني كنت في عالمي ذاك قبل 30 عاماًًً.
بابا تمّام، قفزت إلى حضني، وجاءت رفيقاتها ورفاقها الصغار تحلقوا كشموس حولي، فتاة لطيفة من رفيقاتها اسمها “ألمى”، ضيفتني “شيبس”، أشهى ما ذقت في حياتي ،انتبهت أنني أتصرف بولدنة بسبب نظرات الاستغراب التي مصدرها المعلمات المنتشرات في الباحة بين التلاميذ للحرص عليهم.
أمسكت بلقيس من يدها، وعدت أباً، أعطيتها نقوداً، مسحت على شعرها، كانت فرحتها لا توصف، قالت لي معلمتها: إنها من أذكى الطلاب وأكثرهم نشاطاً، شعرت بفخر لا يوصف وكلام معلمتها يهطل على مسامعي كمطر حبيب.
ودعت بلقيس “بعضة خفيفة على خدها كما أفعل عادة”، وخرجت من المدرسة.
لحظات ووصلني هذا الصوت الأليف: استعد، استرح أسبل. وصوت من يعطي الإيعازات للطلاب وهو يقول لهم نفس الجمل التي كنا نسمعها صغاراً: “وين الصوت..اللي بتمو علكة يشيلا”.. أي سحر قادني إليه قلبي دون حتى أن يستشيرني.. أي فرح وأمل يحمله هؤلاء الصغار بقلوبهم ليكنسوا القسوة التي عشناها وتجرعنا حنظلها.
إن نظرة عامة على وضع البلد، يدرك فيها المرء كم تغيرت بعد ما حل بها من قسوة وخراب ودمار وموت. إلا أن نظرة أعمق إلى جوهر هذا الوطن “سورية”، كفيلة بأن تؤكد أن لا شيء تغير بهذه البلاد، لا شيء تغير بالوطن الأرحب والأطهر والأنقى.
أحيانا أسأل نفسي بجدية: هل هناك حقاً وطن غير سورية يستطيع الإنسان أن يحيا فيه بشكل طبيعي؟ مستحيل أن تنطبق مفاهيم كلمة وطن بمعانيها وإيحاءاتها وأبويتها وأمومتها معاً، على مكان آخر في العالم إلا هذا البلد الأمين ..
تمام علي بركات