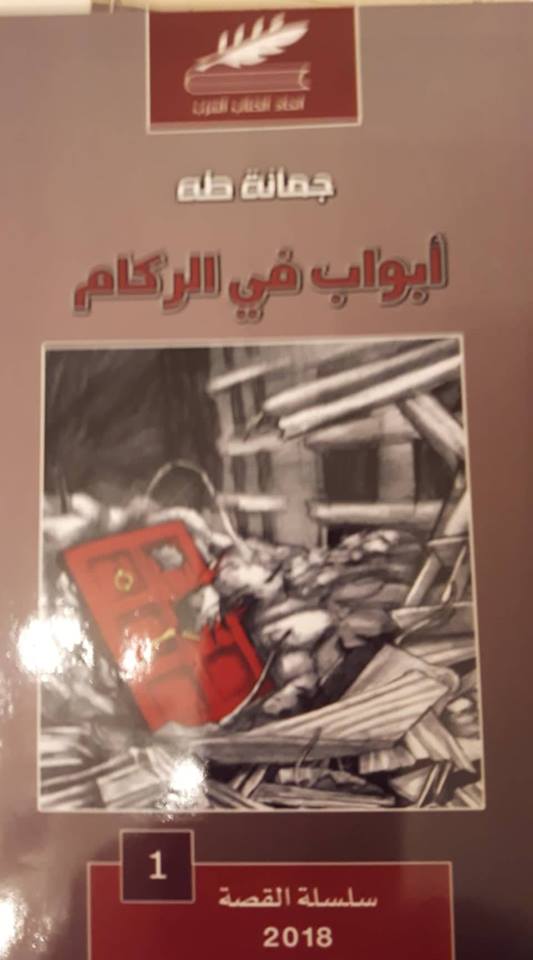ممارسة الفصحى
«أبجد هوز حطي كلمن شكل الأستاذ بقى منسجم.. إن جاء زيد أو حضر عمرو وما لنا إن شا الله ما حضروا».
أغنية ليلى مراد هذه تشي بالمطلوب، فإن بقيت الأبجدية، وبالتالي اللغة العربية، عند قولنا:
جاء زيد وحضر عمرو، فلا شأن لنا بها، لأن المطلوب لغة متجددة متداولة، لاسيما وسط أجيالنا الطفلية والشابة، فكيف نصل إلى هذا الهدف العظيم المأمول؟.
في الجذور
كانوا في الجزيرة العربية يرسلون أبناءهم في”بعثات دراسية” إلى الصحراء، حيث القبائل ذات اللغة المتجذرة أصالة، وكلنا يذكر أن رسولنا محمد (ص) أرسله جده عبد المطلب إلى قبيلة حليمة السعدية كي ترضعه بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب، وبينهم يتعلم اللسان القويم، ويمارس الفصحى على أصولها أيضاً، لذلك عندما تحدث الوليد بن المغيرة عن كلام الرسول قال:
إن لكلامه سحراً، وإن له حلاوة، وعليه طلاوة.
بعد ذلك جاءت جماعة إلى الخليفة، فقدموا منهم يافعاً للتحدث باسمهم، وإذ استُهجِن فعلهم قالوا:
إن المرء بأصغريه: قلبه ولسانه.
وما اللسان إلا قدرة على القول الفصيح، والبيان الجلي الموظف بشكل متقن سليم.
من تجاربي
ما خرّب لغتي الانكليزية في نهاية المرحلة الإعدادية مثل الأستاذ “موعد”. كان يدخل الصف، يرتاح قليلاً على كرسي الخيزران، وهو يمسح عرقه الغزير، ثم يقوم إلى السبورة، يكتب كلمات الدرس الجديد، يُتبعها بترجمتها إلى العربية، بعد ذلك يقول جملته التي راحت مثلاً للتندر فيما بيننا نحن طلاب إعدادية الميدان الأولى: “اكتبوهن واحفظوهن”، ويجلس على الكرسي مجدداً، بينما نحن نقرأ الدرس– كيفما اتفق– وسط كلمته المتخمة بالخمول الناعس: “نيكست نيكست” حتى تنتهي الحصة، لكن في ثانوية ابن خلدون كان الأستاذ شوقي بعاج يرفض سماع كلمة بغير اللغة الانكليزية، حتى إنه علّمنا شرح الكلمات بألفاظ بسيطة معبّرة، فإذا صعب على أحد منا ذلك يشجّعه بالقول:”try again please” فإن أخطأ يحيله إلى رفيقه، كي يصلح له، ما يبث فينا روح النشاط والمنافسة، ويعطينا مثالاً أن أهمية اللغة ليست الإجابة عن أسئلة الامتحان فحسب، بل قدرتك على التواصل مع الآخرين في بلد أجنبي، قد تسافر إليه، وأن تفترض نفسك تلتقي مصادفة بشخص، لا يتحدث إلا الانكليزية، وتستطيع التفاهم معه، فعدّل- أسكنه الله فسيح جنانه – كفة الميزان، ليدخل كثيرون منا إلى كليات متقدمة في الجامعة مثل الطب والهندسة والصيدلية كذلك المعهد العالي للبحوث العلمية وغيرها.
عدو ما يجهل
بعدما سمع أن زوج أخته أسلم جاء ينصت ناظراً من خلال النافذة، فإذا الرجل يتلو من صحيفة في يده، ويدفع أبو حفص الباب داخلاً، فتقف أخته أمام زوجها مدافعة عنه في مواجهة أخيها الذي يسأل:
ـ ما هذا الذي تقرؤه؟ أرني.
ـ ليس قبل أن تتوضأ.
ـ وكيف هذا؟.
بعدما توضأ أخذ الصحيفة وقرأ: “طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى…” فخشع فؤاد الرجل الفظ القاسي عمر بن الخطاب، وأنزل الله الإيمان على قلبه عبر ذلك الترتيل العظيم، فأسلم، وقبل ذلك استطاعت شهرزاد عبر لغتها التي حاكت بها حكاياتها الممتعة إنقاذ نفسها، مع بنات جنسها اللطيف، من سيف شهريار، فقد تزوجته، وأنجبت ولدين، وبنتاً مثل القمر، كما تفيد لوائح الشؤون العائلية في السجل المدني لألف ليلة وليلة.
أداة محادثة
لأن اللغة حسب علماء النفس: نظام اصطلاحي مؤلف من رموز تعبيرية، وظيفتها النفسانية أن تكون آلة للتحليل، والتركيب التصوريين، ووظيفتها العملية أداة للتخاطب بين الأفراد، تمكّنهم من إنتاج عبارات كلاماً وكتابة، وعلى هذا فلا توجد لغة خارج المتكلّمين بها للتعبير عن الحاجات، والرغبات، والأحاسيس، والمواقف، كما الاتصال بالآخر لتنمية الأفكار، والتجارب، والإبداع.
ويؤكد علماء التربية أن القراءة مهارة واكتساب، ما يعني أن علينا نحن الكبار القيام بعملية القراءة للأطفال، كي يتمكنوا من التعرف على طبيعة الأصوات اللغوية، ويدركوا الفروق بينها، ومن أجل أن يعوّدوا أنفسهم على القراءة الصحيحة، والإلقاء الحسن، فيصير الحديث بالفصحى، أو ما يسمى السليقة، ملكة سهلة، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام موجة تجاهل للغة الفصيحة: فالبعض يكتب ما يريد إيصاله للآخرين- إن كان عبر الأنترنت أو المحمول- بأحرف أجنبية، وغيرهم يكتبون بالعامية المبتذلة.
مستويان ممكنان الآن
الأسرة: فلماذا لا نتحادث بالفصحى مع أبنائنا، بأن نجري حواراً معهم حول رغباتهم ومجريات يومهم، ولو لبعض الوقت خلال تواجدنا في البيوت بينهم.
في المدرسة: أن تكون لغة الدرس خلال حصة اللغة العربية على الأقل بالفصحى، وما إيرادي لشاهد الأستاذين موعد، وبعاج إلا للتأكيد على أن المطلوب من حصة “العربي” ليس مجرد الإجابة عن أسئلة الامتحان فحسب، بل أن نتعوّد على التفكير، وبالتالي التحدث بها.
نعم مهم أن يكون المعلم جديراً بتدريس اللغة العربية، فليس المطلوب أن نكتب القاعدة، ونحفظها كالببغاء، على حدّ تعبير الأستاذ موعد: “اكتبوهن واحفظوهن” بل كيفية ممارستها، وتطبيقها في كلامنا، لأنها أداة محادثة بالدرجة الأولى، وهنا لا مفرّ من البحث عن مدرسين أكفاء، يتذوقون الأدب حتى لو لم يمارسوه حرفة، كي ينقلوه حلواً عذباً محبباً إلى أسماع الطلاب، وأفئدتهم الغضة الصافية، وعليه أقترح انتقاء بعض الأدباء، واستضافتهم كـ “أساتذة زائرين” بين الحين والآخر في مدارسنا وجامعاتنا، كما أقترح إقامة مسابقات بين الطلاب للتحدث بالفصحى ارتجالاً عن موضوع ما، وهذا لا يكلّف كثيراً سواء على مستوى المدارس، أو المسابقات الأدبية المعتمدة، وحول الكتابة الأدبية أؤكّد أنه مهما كانت هذه الكتابة مبدعة، فهي كمن يضع كنزاً في كيس مثقوب- على حد تعبير أحد الزملاء القاصين- عندما نهمل الفصحى، وعليه فلا إسقاط للغة بحثاً عن الإبداع مهما كان مستواه رفيعاً.
الفصحى أجمل
أتذكر من أيام دراستي في كلية الهندسة المدنية/جامعة دمشق أن بعض الزملاء في السنة الأخيرة كانوا يحضرون مادة المعدنية، مُقرر سنة رابعة، للدكتور فيصل خليل، فسألتهم:
ـ لماذا تحضرون هذه المادة؟.
أجابوني: لأننا نحب الاستماع إلى الدكتور، وهو يلقي محاضرته بالفصحى.
وكم كنت خلال عملي في قسم التصحيح/ صحيفة الثورة أسعد لحديث الأستاذ رئيس الفترة الليلية، وهو يتحدث خلال فترات الاستراحة حين لا مواد لتصحيحها، أو بانتظار مادة من السورية للأنباء “سانا”، ما جعلني أحضر مبكراً، وكثيراً ما أتأخر بعد انتهاء العمل للاستزادة مما يقوله الأستاذ حسن قطريب –رحمه الله- بلغته الفصيحة المتمكِّنة مثلما اللحن العذب، يقع على الأكباد برداً وسلاماً، لذة ومتعة للسامعين.
أخيراً: لا ننسى أن الخلفاء، وأكابر القوم كانوا أيام زمان “يوظِّفون” معلمين لأبنائهم، يدرِّسونهم، ويهذِّبونهم، وقد جاء في الموروث: “خذوا العلم من صدور الرجال”.
أيمن الحسن