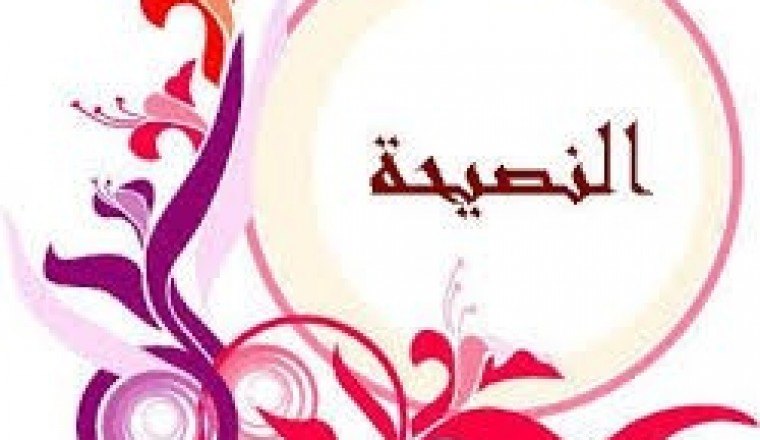القراءة.. حرية
ربما لم يعد مجدياً ترداد عبارات من قبيل: “أمة اقرأ.. لا تقرأ”، أو من قبيل: إن المعدل السنوي للقراءة عند الأمريكي هو أحد عشر كتاباً، وعند العربي هو ربع صفحة، وإن ما يترجمه العرب مجتمعين لا يعادل خمس ما يترجمه اليونانيون، وما إلى ذلك من مقارنات مختلفة، فقد جفت الأقلام ـ في هذا الشأن ـ ورفعت الصحف، فعلياً لا مجازياً.
وربما هي الدنيا وتغيراتها، وهذا، على كل حال، دينها وديدنها، بيد أن السؤال الأساس هو لماذا تطالنا هذه المتغيرات أكثر من غيرنا، وكيف “نجا” الأمريكي واليوناني وغيرهم منها، ولم ينج العربي، صاحب “ثقافة النص”، كما توصف الثقافة العربية والإسلامية.
للباحث المصري الدكتور نبيل علي، مقولة معبّرة مفادها “نحن ما نقرأ”، وهذا يعني، وفق المؤشرات السابقة، أننا ربع شيء، لأننا لا نقرأ سوى ربع صفحة، خاصة وأن القراءة، كما يقول الدكتور علي، “تؤدي دوراً مؤثراً في إيقاظ وعي الفرد وتوجيه سلوكه الاجتماعي، وتعميق إدراكه بمكامن الحياة الحقيقية والأصيلة داخله، وهي مقومات باتت لازمة كي يتصدى لمجتمع يحاول صياغة أفراده على نمط معياري مقنن مجهز من قبل”، وهنا، على ما يبدو، بيت القصيد، فهناك من خطط لعدم القراءة، كي يصل بنا إلى هذا النمط المتخلف، الذي هو “موجه ومخطط له ومتعمد، وليس أبداً نتيجة لجهل الناس بشروط التقدم”، على رأي الراحل د. حامد خليل. أما لماذا؟، فتلك قصة معروفة، وإذا انطلقنا من بعض التعريفات التي تصف الإنسان بأنه “حيوان اجتماعي”، ما يعني، في مكان ما، حتمية الاجتماع وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار، عبر وسائل التعلم المختلفة من التلقين الشفهي وصولاً إلى الكتاب، وبالتالي الارتقاء بالإنسان إلى آفاق أخرى، وتخفيف القيود والأغلال التي تمنعه من الطيران نحو المستقبل، أي أن القراءة حرية، فإن أولياء الأمر، وجدوا، محقين، في هذه الحرية خطراً داهماً عليهم، ما دفعهم لاستنباط الوسائل التي تحوله ـ أي الإنسان ـ إلى كائن منفرد متوحد، يسهل توجيهه والسيطرة عليه، عبر “الأخ الأكبر” الذي يحتكر المعرفة، بكل أنواعها الدينية والدنيوية، مانعاً، بالتالي، الوصل والاتصال، وهما أساس الثقافة والمعرفة الإنسانية، وأساس الحـــــــيــــــــاة الإنســـــانية ذاتها، من حيث هي تراكم واع، وهو ما يميزها عن الحياة الطبيعية المجردة، التي تتمثل بمجرد البقاء على قيد الحياة، دون تطوير أو تغيير.
بيد أن الأمر لا يحدث بهذه الفجاجة والمباشرة، أي ليس بحمل “العصا” ومنع الناس من القراءة، فتلك آليات “قروسطية” أكل عليها الدهر وشرب، رغم استمرار بعض صورها هنا وهناك في تجليات داعشية بامتياز، فكان البديل العصري “منح” الإنسان “ثقافة” أخرى، ولكن بعيداً عن الكتاب برمزيته المعروفة، ثقافة للاستهلاك مرة واحدة فقط، تقدم معرفة منقوصة مبتورة متشظية، ينساها المرء بعد قراءتها فلا تراكم ولا بقاء، ثقافة تمنح الوهم بالحرية، لكنها ليست إلا حرية كاذبة، واهمة وواهية في الآن ذاته. هنا تحديداً يأتي دور وسائل الإعلام الحديثة، وهي رغم أهميتها الهائلة، ووهم فكرة الاستغناء عنها، إلا أنها، وهي تساهم في تشكيل الوعي الجمعي، تساهم أيضاً في تتفيهه وتحويله إلى وعي استهلاكي محض، ما يعني، بحسب كاتب عربي، الإسهام “في تكوين بيئة مسطحة فكرياً وثقافياً ومعرفياً، بما يؤدي إلى إعادة إحياء أيديولوجيات تاريخية متحجرة، أو إنتاج أيديولوجيات جديدة تعمل على تفخيخ ما تبقى من وعي، ونسف آليات العقل، واستبدالها بالتعصب الديني والطائفي”، وهو عين المطلوب، وهو أيضاً عين ما نشهده اليوم على امتداد ساحاتنا العربية التي لا تقرأ، بل “تتفرج” وتنفذ أيديولوجيات جعلها الضخ الإعلامي الهادف لمستهلك جاهز حقائق نهائية ناجزة، ومن يمتلك الحقائق النهائية لا يُعنى بقراءة الجديد أو قراءة الآخر، فـ “العلم” بين دفتي كتابه هو، ولكن كما يقدمه، ويقرؤه له، سدنة الهيكل، ويكفي العودة، عودتهم هم، إلى الماضي لمعرفة ما يحصل الآن وما سيحصل لاحقاً، أما هو فمجرد متلق مؤمن سلبي بالمطلق، وتلك وصفة الخراب والزوال والاضمحلال الذي نعيشه.
وفي العودة للراحل “حامد خليل” فإن البشر “لا يتكونون في الفراغ، ولا هم ودونما سبب على هذا النحو أو ذاك، وإنما هم نتاج ما يصنعونه”، ومنذ أن أضعنا حلم “المأمون” بالقراءة والترجمة، وطردنا “ابن رشد” ـ بما يعنيه من قراءة عقلية حرة ومفتوحة ـ من ساحتنا، ونحن ضائعون في هذا العالم، ويبدو أن طردنا النهائي من ساحة الفعل، باستثناء فعل السلب، وساحة الوجود ـ باستثناء الوجود الفيزيائي الذي تمارسه كل المخلوقات الأخرى من أكل وشرب وتزاوج ـ سيكون موعده قريباً جداً. وربما هذه قراءة متحيزة، وقد تكون كذلك، لكنها على كل حال قراءة تطمح إلى فتح المجال أمام قراءات أخرى، مؤيدة أو معارضة، في هذا الموضوع المصيري، علّنا بذلك نتحاور في أمور المستقبل ومتطلباته، بدل البكاء المستمر على اللبن المسكوب.
أحمد حسن