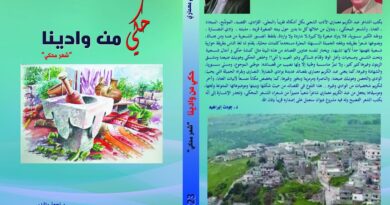أيّها المُبدِع.. لا تدَعْها تَدفُنُكَ حيّاً
بشرى الحكيم
حين اتصلت “فرانسواز كلوزيه” الصحافية في “فرانس برس” بالفيلسوف الفرنسي الشهير “جان بول سارتر” تبلغه فوزه بجائزة نوبل التي ينتظرها الجميع؛ أعلمها برفضه الجائزة بكل برود العارف مسبقاً بالنتيجة؛ الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في حينه؛ ليس في فرنسا بلد الفيلسوف فقط؛ إنما في العالم أجمع؛ إذ من لديه كل تلك الثقة والأَنَفة لرفض جائزة هي المعيار والمقياس العالمي لكل إنجاز في العالم؛ يتقاتل الجميع للحصول عليها حتى لو انحدر في تنازلاته إلى الحضيض.
فيما بعد صرح “أندريه غيغو” المتخصص في فلسفة “سارتر” للصحف موضحاً الأسباب التي تقف خلف قرار الرفض؛ تلك التي تمثلت في خوف منطقي لدى سارتر من أن تكون السبب في “دفنه حياً قبل أن يكمل رسالته في الحياة” ناهيك أنه كان أوضح في العديد من المناسبات أن أفكاره أساساً تتعارض بل تقف ضد أي شكل من أشكال المؤسسات التي يراها” مميتة” وعائقاً كبيراً أمام كل إبداع إنساني.
وبرغم مرور السنين على الحادثة إلا أنه لم يكن للرفض بحد ذاته أدنى تأثير على شهرة أو مكانة سارتر الأدبية، لا بل إن الأمر رفع من مكانته لدى مريديه على امتداد مساحة العالم.
وبرغم كل المبررات والأسباب التي قد تدفعني أو سواي للشعور بالبغض تجاه الضمير الغائب أصلاً أو المغيب للإنسانية أو حتى للتساؤل والاستغراب إلا أنني لا أشعر بأي حزن عندما تحجب نوبل لهذا العام أيضاً عن المبدع السوري أدونيس. بل إن التساؤل المنطقي الذي أرى أنه يجب أن يشغلنا هو؛ هل أصبحت جائزة نوبل هي الوسيلة الوحيدة لتحديد قيمة أي عمل إبداعي أو إنساني أو اكتشاف علمي في هذا العالم؟.
ترى هل نالها يوماً “كارل وينر” مكتشف “شجرة الحياة” التي تربط الكائنات الحية بعضها بالبعض الآخر؛ وأديسون هذا الذي كان السبب في إنارة هذا الكون المعتم الذي يصر على الذهاب إلى الهاوية بنفسه، وهل تساءل عنها يوماً “ستيفن هوبكنز” مكتشف الثقوب السوداء والتي باتت جزءاً هاماً وأساسياً من علوم الفيزياء والتي أدت للتقدم اللامحدود الذي تم تحقيقه في نظرية المعلومات، و”كريغ فينتر” وزملاؤه؛ مكتشفي تسلسل الحمض النووي “DNA” الذي فتح الباب واسعاً أمام العلاج بالجينات وتطوير العلاجات الطبية والأدوية الجديدة، أيضاً. وأيضاً “تيم بيرنوز لي” مكتشف الشبكة العنكبوتية “الانترنيت” الوسيلة التي وفرت هذا الكم الهائل من المعلومات للمليارات من البشر وفتحت الأبواب على الملايين من المشاريع الصغيرة والكبيرة وفرص العمل التي لا تحصى، كل هؤلاء وسواهم الكثير مضوا إلى نهاياتهم خاليي الوفاض أو على الأقل رحلوا دون أن تتذكرهم المدعوّة “نوبل”.
وبرغم الرغبة “الغريزية” والدفينة لدى الجميع بما فيهم أكبر المبدعين على السواء؛ إلا أن السعي للحصول على الجوائز أياًّ كانت كنوع من الإقرار والاعتراف بقيمة المبدع لا يسوّغ تسوّلها؛ فتفقد بريقها وألق صاحبها. لتبقى الغيرة على مبدع كبير يعتبر قامة أدبية بصرف النظر عن الكثير من المواقف والآراء؛ إلا أنه وسواه من الكثيرين الذين يستحقون التقدير لا يمكن أن يجعلنا ننسى أن الحصول على نوبل وسواها من الجوائز؛ قضية ترتبط بأمر أكبر بكثير من قيمة شخص واحد، وأعظم بكثير من قيمتها المعنوية، هي قضية بلد بأكمله، بقي حتى الساعة عصياً على أن يكون مجرد رقم يدور في فلك المنصاعين والمنقادين خلف مهازل تلهث كبريات دول العالم كي تقودنا إليها حتى لو اقتضى الأمر حرباً عالمية جديدة.
معيار وحيد متاح نربأ بمبدع كبير، هو سليل عشتار وزنوبيا ، حفيد هنيبعل وجلجامش الباحث عن الخلود، نربأ به أن يلجأ إليه؛ يكمن في التحلل من كل مبدأ وإيمان نشأ عليه؛ الأمر الذي بات منطق هذه الإنسانية المعوجّ، إذ كيف يستوي أن تحصل عليها في السلام، أسماء تتناقض فيما بينها “من مارتن لوثر كينغ فكيسنجر، إلى الأم تيريزا وبيغن، ثم نيلسون مانديلا، السادات، بيريز ورابين؛ ثم راعي الحروب التي تتوالى على هذا العالم باراك أوباما”.
* * * *
… فإلى أدونيس شاعرنا الكبير..”لا تدع نوبل تدفنك حياً” ولا تحزن وقد خانك الأمل مرة جديدة، إذ يبقى لك شرف كتابة اسمك في قائمة طويلة وثمينة لاتنتهي من الكبار الذين أدارت لهم ظهرها “نوبل” الملوثة بنوايا القائمين عليها.