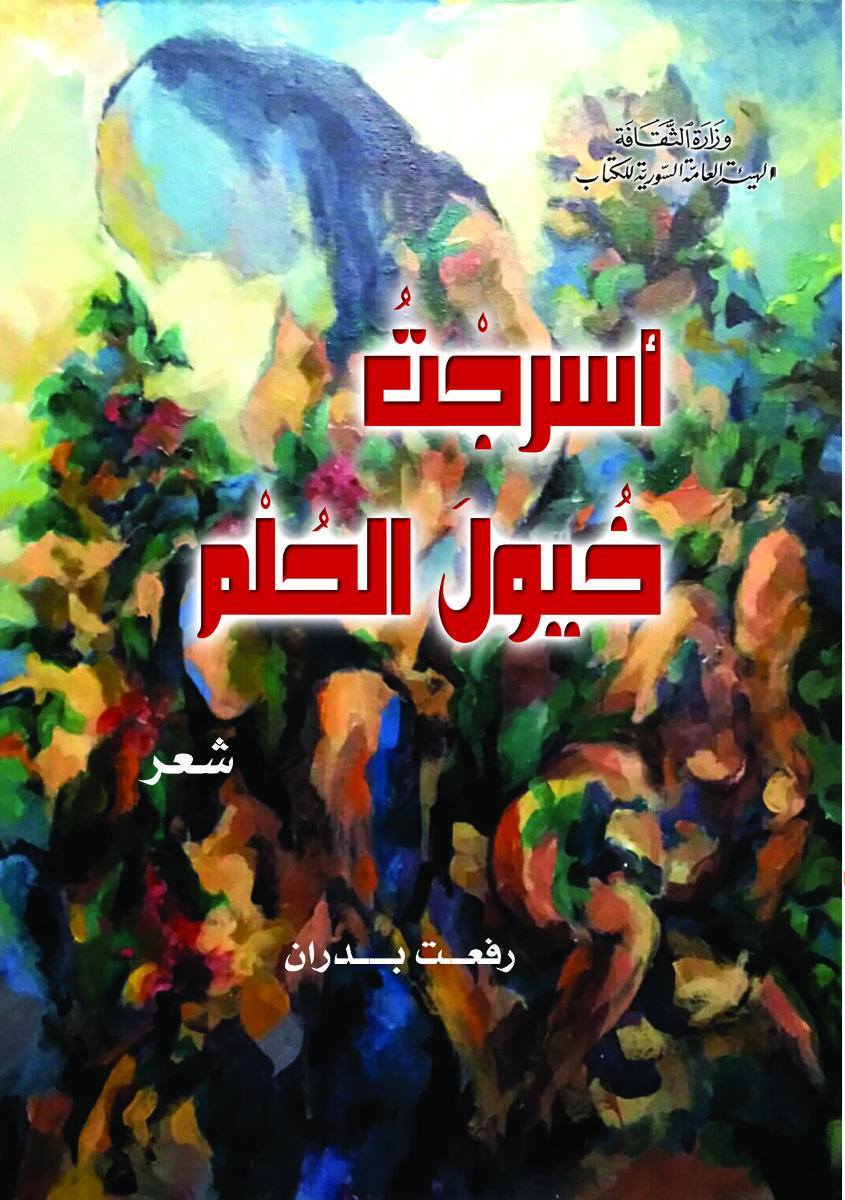” فرانكشتاين في بغداد” ..سوريالية واقع موجع
بعد الغزو الأمريكي الذي تعرضت له العراق في العام 2003، حيث عمت الفوضى والعنف بأشد صورهما عبثية وابتعاداً عن منطق العقل، وكما في الرواية التي نعرفها جميعاً عن فرانكشتاين الكائن الخرافي الذي صنعه خيال العالم من بقايا أشلاء بشرية من هنا وهناك، مخلوقاً جمع بين الإنسان والوحش، خرافياً في كل شيء حتى في القبح وحجم الكراهية التي سكنته، تلك التي لم يسلم منها حتى صانعه العالم.
هادي العتاك
في الرواية يتسيد المشهد كائناً خرافياً مماثلاً يليق بالحالة العبثية لما بعد الغزو؛ عنف وإرهاب وأعمال قتل وثأر وانتقام، متكررة، باتت من يوميات المواطن العراقي؛ في منطقة البتاويين في بغداد، حيث يجتمع كل صنوف البشر من قتلة ومرتزقة، تجار حرب وتجار أسلحة وعقارات، وبشر عاديين أيضاً؛ رعاة لعمليات إرهابية، ومفخخي سيارات ولصوص، في هكذا أجواء مفتوحة لكل قباحات العالم؛ لا بد لشخص مثل هادي العتاك أن يجد له مكاناً مناسباً، والعتاك تاجر خردوات ، يحرص على تجارته كما على مساعده الذي خسره في واحد من التفجيرات، وكان بمثابة ابنه وبقية عائلته، يملؤه هذا الفقد حقداً وشعوراً بالخوف؛ وتوقاً للانتقام ممن كان السبب وراء هذا الدمار الذي عم المكان.
“ولأن ناهم ليس له صلات أو عائلة كبيرة سوى امرأته وابنتيه الصغيرتين، فقد ذهب هادي إلى المشرحة لتسلّم جثته، وهناك أصيب بصدمة كبيرة، حين شاهد كيف اختلطت جثث ضحايا التفجير مع بعض، قال الموظف في المشرحة لهادي؛ اجمع لك واحداً وتسلّمه، خذ هذه الرجل وتلك اليد وهكذا، الأمر الذي تسبب بصدمة كبيرة لهادي …” تماهى الرجل مع الأمر إلى أقصاه.
“عاد هادي العتاك إلى بيته، تحسس أرضية الحوش بحثاً عن دماء أو بقايا أشلاء بشرية؛ من تلك التي يعرف تماماً أنه أمسكها بيديه وعالجها تقطيعاً وخياطة حتى أنجز الجثة بشكل مقبول” ص69.
اخترع كذبة تناسب مخططاته؛ صدقها وبات يغذيها في العقول من حوله، وخصوصاً في عقل العجوز “إيليشوا أم دانيال” التي رحل ولدها خلال حرب الثمانينيات ولم يعد، وما زالت تحيا على أمل عودته، تتشبث بالمكان والبيت القديم ترفض الخروج وإغراءات الهجرة إلى الخارج من قبل بناتها اللواتي أصبحت مصدر قلق لهن ببقائها في العراق والحرب تدور فيها.
“حتى النساء في الكنيسة أصبحن أكثر برودة حين تتحدث أمامهن عن ولدها الذي فقدته في الحرب، بعضهن لا يتذكر دانيال هذا رغم أنهن يعرفنه، فهو على أية حال شخص ميت واحد مر على ذاكرتهن التي ملئت واتخمت بالميتين خلال سنوات طويلة” ص14.
كذبة العتاك التي باتت حديث الناس ورواد المقهى في منطقة البتانة وشغلهم الشاغل حول كائن خرافي جسده عبارة عن بقايا جثث لضحايا التفجيرات التي شهدتها بغداد ولا تزال، يدمن القتل سبيلاً للبقاء حياً؛ حجته حراسة المكان والثأر للضحايا الذين يشكلون أجزاء جسده الغريب.
الصحفي
يتعرف محمود السوادي على العتاك بينما يؤدي مهمته الصحفية في المنطقة المنكوبة، وكان ذاع صيته من خلال قصصه التي باتت أقرب إلى هلوسة المجانين، وحيث أصبح الشك يحوم حول كل ما يخبره من أحداث غريبة، وهو بالرغم من ذلك بقي مثار الاهتمام بدافع الفضول البشري وحب التلصص على خفايا القصص، السبب ذاته الذي يدفع بالسوادي للاقتراب منه أكثر؛ إذ وجد فيما يرويه مادة شيقة ودسمة تكون أساس بناء لمادة صحفية تشكل ضربة العمر تؤهله على الأقل لتثبيت مكانه في الصحيفة إن لم يكن الترقي إلى الأعلى؛ ولذا فهو لم يتردد بتزويد العتاك بآلة التسجيل خاصته لإجراء حوار مع “الشسمة” بالطبع حجة العتاك الجاهزة هي إمكانية تعرضه لانتقام مخلوقه الخرافي إن اكتشف أن الأمر ينطوي على كشف قصته للعلن، وبدهاء الصحفي الباحث عن فرصته يقنعه محمود بما في الحوار من فرصة ذهبية لإثبات روايته وتحسين صورته التي نالها من التشويه الكثير.
الشسمة
“هل هذا العتّاك المسكين والدي حقاً؟! إنه مجرد ممر ومعبر، لإرادة والدي الذي في السماء، كما تحب أن تصفه والدتي إيلشوا المسكينة.. كلهم مساكين، وأنا الرد والجواب على نداء المساكين.
سأقتص بعون الله والسماء، من كل المجرمين. سأنجز العدالة على الأرض أخيراً، ولن يكون هناك من حاجة لانتظار ممض ومؤلم لعدالة تأتي لاحقاً، في السماء أو بعد الموت.
أنا ولأني مكوّن من جذاذات بشرية تعود إلى مكونات وأعراق وقبائل وأجناس، وخلفيات اجتماعية متباينة أمثل هذه الخلطة المستحيلة التي لم تتحقق سابقاً. أنا المواطن العراقي الأول” ص161.
ولأن القصة في الحقيقة أكبر من شخص العتاك إذ سيتبين لقارئ الرواية من خلال مجريات الأحداث أن ثمة مجموعة كبيرة هناك بالإضافة إلى هادي؛ أتباع ومريدون بانتماءات مختلفة التوجهات، هناك مجانين؛ وساحر ؛ وكذلك الأتباع العاديون، كان الجميع يطلق عليه لقب “القدّيس” ويعملون معاً كما في ورشة عمل من أجل إعادة ترميم جسد قديسهم بعد كل عملية يقوم بها، إذ ربما يتعرّض للإصابة أو فقدان أحد أعضاء جسمه، حتى أن بعضهم كان يمده بالمعلومات الضرورية لضمان أمانه أثناء تحركاته الليلة.
سوف تتفشى حالات القتل الغامضة وقصة “الشسمة” الغريبة لتبدأ السلطات البحث عن وسيلة للقبض عليه، فتلجأ إلى المنجمين والمشعوذين على مبدأ “وداوها بالتي كانت هي الداء”.
في القراءة الأولية للرواية يخيل لنا أنها مجرد مقاربة للحكاية التي باتت أقرب للموروث الشعبي، أو تجسيداً للفيلم الذي نال ضجة كبيرة في حينه، لكن وببعض التفكر يمكن القول أنها تصوير رمزي لواقع موجع عاشه العراق وما يزال؛ من خلال فكرة رمزية لصورة واقعية، إذ في واحد من تصريحاته حول فكرة الرواية قال السعداوي أنها أتت بناء على حوار دار بينما كان يستقل سيارة عمومية شاهد ركابها محاولة رجال الشرطة نقل جثة رجل ميت إلى داخل سيارتهم، الأمر الذي ولد لديهم نقاشاً وتساؤلات من نوع: “من هذا الرجل؟ إلى أي طائفة ينتمي! أهو مذنب أم بريء؟… أسئلة حركت تساؤلاته أيضاً حول النتيجة التي انتهى إليها حوار الركاب” الرجل القتيل يستحق الموت، لو لم يكن مذنباً لما حصل له ذلك”. لتأت روايته صورة سوريالية للفوضى والعنف سمات بارزة حتى الأفكار لم تنج منها، ولعل في الشسمة “وهو بالمناسبة في لهجة أهل العراق يعني الذي لا أعرف، أو ما اسمه” ليس إشارة بل دليل أن العنف والقتل الحاصل إنما وُلد نتيجة الغزو والاحتلال الجائر للأرض، من خلال تعبير شديد البلاغة عن وعي وفهم لواقع اجتماعي وسياسي وموروث متأصل تجسد بروايته “فرانكشتاين في بغداد” الرواية التي نالت جائزة البوكر العربية للعام 2014.
بشرى الحكيم