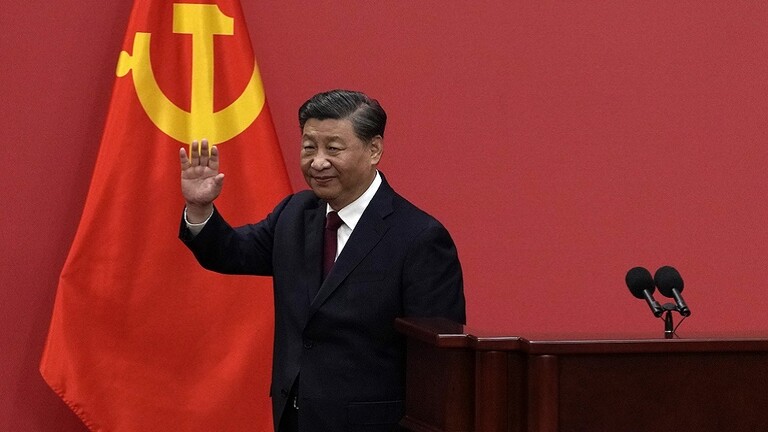هدوء.. هناك من يعمل بتفانِ
المتابع للأنشطة والفعاليات التي تقيمها وزارة الثقافة، لا بد أن يشعر بالذهول والاستغراب، من حجم العمل الذي تقوم به، وبجودة التنفيذ أيضا، فالفنون في البلاد على أحسن ما يرام، ولا يعرقل نشاطها العالي أي شيء، فلا يكاد يتوقف مهرجان “دعم سينما شباب” حتى يبدأ مهرجان “دعم مسرح الشباب”، ولا ينتهي عرض فيلم سينمائي طويل من إنتاج حكومي، حتى يبدأ عرض مسرحية من إنتاج جهة حكومية أخرى، تتبع لنفس الوزارة؛ مراكز ثقافية لا تهدأ عن المحاضرات في الأدب وأمسيات الشعر، والملتقيات الفنية، عدا عن طباعة مالا يحصى من الكتب والدوريات المنوعة فنيا وفكريا وفلسفيا وغيرها.
الجهود الحقيقة السابقة تستوجب الشكر، وذلك في أيام السلم، فكيف في زمن الحرب؟ إن دولة غربية أو دولة متقدمة وغنية تفوق ميزانيتها ميزانيتنا نحن، قد تعجز عن هذه الجهود، ما يعني أن هناك تفوقا على مستوى الكم أولا، وثانيا على مستوى الظروف الراهنة وتحديها.
سورية تمر بحرب، ربما ما مرت بمثلها منذ أن اخترع أبناؤها الأبجدية، أو ربما منذ أن اكتشف ذلك الفلاح القديم في ترابها، حبوبا تدعى “القمح”، منذ تلك الأزمنة، لم تصلنا لا وثيقة تاريخية ولا أركيولوجية، تخبرنا عن حرب تعرضت لها البلاد، أو الأجداد، كانت أقذر من هذه الحرب، يقول نزار قباني في واحدة من قصائده: “أشُهرك في وجه البشاعة سيفا من الياسمين وأعلن انتصاري”، يبدو أن ذلك ما تحاول أن تفعله تلك الجهود، وهو إشهار الفنون في وجه بشاعة هذه الحرب، لأن ذلك يعني انتصارا، في حرب قائمة أصلا ضد سورية بما تمثله من قيم حضارية وجمالية.
هناك قصة تروى عن “ونستن تشرشل” ولكنها في الحقيقة، هي للزعيم الفيتنامي الشمالي، ففي واحدة من حروب الاستقلال التي خاضها، وعند سؤاله إذا كانت الحكومة تريد أن تستمر في دعم الفنون أثناء الحرب، أجاب: “إذا كنا نريد أن نتوقف عن الفن خلال الحرب، فعن ماذا ندافع إذا ولماذا نحارب؟” وهذا ما ينطبق تماما على رؤى وفلسفة القائمين على هذه الجهود.
ما سبق من حراك ثقافي منقطع النظير، لا يحدث فقط في العاصمة دمشق، بل وفي درعا والسويداء وحمص، حلب، طرطوس واللاذقية، ولا يلبث هذا النشاط أن ينتقل إلى أي مدينة أخرى عندما تعود إلى حضن البلاد، ما يجعل الأمر يبدو كمقارنة، بين مناطق ظلامية تحظر الفنون، وأخرى يسود فيها الفن إلى جانب الشرعية الدستورية، وهي مقارنة ليست فقط أمام السوريين، بل أمام العالم برمته.
هناك إذا رسالة قوية إلى كل الأعداء، أعرابهم وأغرابهم، مفادها أنه وفي مقابل كل قذيفة غادرة يطلقونها، سيظهر فيلم، وعند كل سيارة مفخخة يعدونها للموت، ستنبثق مسرحية، وكلما تدمرت محطة كهرباء، فسوف يضاء مركز ثقافي، وعند كل خطاب عنصري أو تفريقي بين السوريين، ستسمعون أمسية شعرية، لماذا؟ لأن سورية جميلة، وكلما ازداد العدوان عليها ازدادت جمالا وفنا، وعيناها من خلال الدموع ترق فتنتهما ويضج بريقهما بالجمال.
إن هذا الدعم للفنانين السوريين من مسرحيين وسينمائيين وشعراء وأدباء، سوف ينشئ جيلاً من المثقفين الذين عايشوا الإبداع خلال الحرب، و شيئا فشيئا، سيشكلون اتجاها فنيا تعلم عنه الأجيال القادمة، فتكون هذه التجربة بوصلة لأبناء المستقبل، كيف يمكن التصرف في الأوقات الصعبة كهذه.
وأيضا يشكل رسالة أخرى إلى الفنانين العرب، الذين يجب أن يستلهموا هذه التجربة، لأنهم يعرفون عن سورية أنها سباقة في كل شيء، لا بد أنهم يتساءلون الآن، ويضربون لبعضهم الأمثال، ولربما يقولون لمواجهة الإحباط، انظروا كيف يعمل الفنان السوري في أسوأ الظروف، وكيف تزدهر الفنون في البلاد خلال الحرب.
إن ما يحدث الآن لا يختلف ولا يخرج عن عادات التاريخ السوري، وعن شيم أهله عند مختلف العصور، فالبلاد التي فيها كبريات المسارح الأثرية، وأيقونات العمارة، وإليها ينسب أهم الشعراء، لا بد أنها لم تنجز كل الفنون التي أنجزتها وهي في حالة سلام، فسورية كانت دائما مقصدا للغزاة؛ مثلما فعل الأجداد في الماضي، تحاول هذه الجهود أن تفعل الآن، وبهديهم يهتدون.
إن تراكم هذه الأعمال، وشحذ همم وعقول المشتغلين عليها، سوف تتيح لهم، ملاحظة أشكال أخرى من الفنون، ليصار أيضا للعناية بها، وملاحظتها لا تأتي عادة إلا بعد تراكم الخبرات الفنية، ومنها مثلا الفنون الشعبية غير المدرسية، أي التي تنشأ بتلقائية بين الناس، وتصبح جزءا من تاريخ وهوية المنطقة، قرنا بعد قرن، فالأغنية الشعبية والعتابا، والرقصات التي تختص بها كل محافظة سورية، وشعر الزجل، والشعر المحكي، والنماذج العمرانية الفريدة التي تتميز بها بعض المحافظات، وغيرها من الفنون التراثية الأخرى، هي أيضا شؤون ثقافية، وتحتاج إلى رعاية شأنها في ذلك، شأن الفنون المدرسية.
هذه الجهود الجبارة والضخمة في الطرح والتنفيذ، جعلت السوريين يؤمنون بعناد أشدّ، أنهم صُناع حياة بيد، وحُماة حضارات بيد أخرى، وهاهم وها هي فعالهم.
تمّام علي بركات