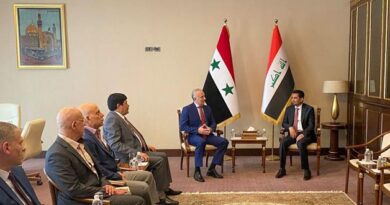“دم المماليك .. النهايات الدامية لسلاطين المماليك”
غلبة اللون الأحمر على الغلاف والعنوان “دم المماليك.. النهايات الدامية لسلاطين المماليك” كافية ليعرف القارئ ما تحمل صفحات هذا الكتاب بين طياتها من مؤامرات واغتيالات بشعة وسيل الدماء الذي ستُكتب به حروف الرواية التي فضل الكاتب “وليد فكري” أن يأخذنا من خلالها في رحلة في رحاب التاريخ لقراءته بشكل جديد بعيداً عن التقليد، مليئاً بالإثارة والترقب،عصر المماليك الذي امتد لقرنين ونصف من الزمان شهد خلالهم أكثر من أربعين انقلاباً عسكرياً، وتعرض أكثر من عشرين ملكاً للقتل بأساليب تتدرج وتتفاوت في درجة الشناعة، عصر دموي كانت قاعدته “عاش الملك.. مات الملك” و”الحكم لمن غلب” مختصرة سياسة الحكم في عهد المماليك وكأن العُرف الذي ساد بين الحكام حينها أنه لا مشكلة بالقتل والغدر وسفك الدماء بيننا نحن الحكام والأمراء، وفي ذات الوقت نراعي ازدهار الحضارة والثقافة في البلاد لتكتمل بهذا المزيج المتناقض دهشة القارئ من هذه الحقبة.
“لم يكن المماليك ملائكة، وكذلك لم يكونوا شياطين، ولكنهم بكل الأحوال قد أقاموا دولة عظيمة قدمت للعالم محتوى حضاري هائل، وتركت بصمة في الإدارة والحكم”.
بدأ الكتاب بحديث موجز عن خيانة أيبك لأقتاي لكي يرضي شجرة الدر، ثم خيانة شجرة الدر لأيبك وتآمرها عليه وقتله، ثم تموت شجرة الدر رميًا بالقباقيب بانتقام من زوجة أيبك، التحولات الدرامية ستُصدم بلا شك عندما يزعزع وليد فكري ثوابتك التاريخية التي ترسخت في عقلك مما درسته قديماً عن مشاهير ملوك وقادة هذا العصر كالملك (قطز) و(بيبرس)، حيث هناك وجه آخر لم يذكر في المقررات الدراسية المهتمة بتمجيد الانتصارات الحربية على حساب تجاهل باقي الأخطاء والسقطات المؤكدة منها وغير المؤكدة، فنجد مثلًا أن هناك أدلة مقنعة على أن (قطز) كان هو اليد الخفية وراء قتل (شجرة الدر) و(أيبك) لبعضهما البعض كي يصل إلى كرسي الحكم، فيما يشكك البعض في أن (الظاهر بيبرس) قد انتحر بالسم، وبغض النظر عن صحة الأدلة من عدمها، إلا أن الكاتب يقدم رأياً موضوعياً مع تحليلات مقنعة وفي النهاية لا يحاول “فكري” أن يفرض وجهة نظره، إنما اكتفى بعرض الحقائق ملحقة بالمراجع والكتب التاريخية للتحقق معطياً المساحة الكافية للقارئ في تكوين قناعاته الشخصية.
الكتاب يتحدث فقط عن النهايات الدامية لسلاطين المماليك، وليس عن حياتهم وانجازاتهم، يتطرق للمؤامرات والاغتيالات والتي تكاد تكون مكررة بطريقة تثير الدهشة، لا يخلو الكتاب من بعض الشخصيات التي تتعجب من كيفية وصولها لكرسي الحكم بل وبقائها عليه لسنوات عديدة كأبناء الملك (الناصر محمد بن قلاوون)، الذين كان منهم الشهواني الشاذ، الطفل الساذج، السفيه العربيد، السفاح غير المبالي، المنحوس الغبي، والسكير حد الخرف!.
سيتعرف القارئ على “محمد قاتباي” الذي كانت هوايته القتل للمتعة “فكان يتسلل هابطاً من القلعة متنكراً في زي العوام ويذهب لأحد سجون القاهرة ينتقي بعض المساجين ويحملهم للقلعة، ضحيته الأولى كانت شاباً يكبر السلطان بسنوات قليلة – فالسلطان يبلغ من العمر 16 سنة-، لا يعرف فيما سجن ولا يهمه، فقط رأى أن يجرب التوسيط في جسده النحيل، قبل أن يتمرن على ممارسته على أجساد أكثر سمكاً وقوة، رفع السلطان السيف عالياً وهوى به ليشق الجسد الممدد تحت سرته، لكن دون أن يتم قطعه لنصفين كما تقتضي الصنعة، تقدم من الشاب المحتضر وأخذ يرمق رقصة رجليه في نزعه الأخير، ارتجل لحناً بدندنة شفتيه على إيقاع التشنجات الأخيرة للسجين المحتضر تشمم بفضول الدم الذي تفجر ليتناثر عليه ويصل إلى وجهه رفع نظره للمشاعلي قائلاً بمرح: “لماذا لا تختلف رائحة دم هؤلاء عن رائحة دماء جنسنا؟”.
سيعلم القارئ أن “قنصوه الغوري” لم يتول السلطنة إلا راضخاً وهو يبكي، فهو لم يرد أن يخلص أمره كما نهايات الآخرين ممن سبقوه، فلم يقبل الحكم إلا بعد أن أخذ تعهداً بأنه يصرف صرفاً جميلاً وألا يقتل أو يحبس، حاول التخلي عن السلطة إلا أنه لم ينجح، كان يشعر بأنه في جب مسكون بالأفاعي، كان يجد متعته في جلسة سمر أو مجلس نقاش أدبي محاولاً فيها أن ينسى السياسة وألاعيبها إلا أن القدر كان له نظرة أخرى فكتب عليه أن تكون سلطته شؤماً على دولة المماليك ويكون سقوطها مقروناً باسمه عند احتلال العثمانيين لمصر.
يحاول الكاتب في صفحات كتابه القليلة، لكن المليئة بأحداث كثيرة مكثفة وموجزة بطريقة رائعة والتي قدمها بشكل أدبي روائي حتى لا يكون التاريخ بليداً فأضفى لمسة ترغب القارئ في غرف المزيد من المعلومات عن عصر طويل من الانقلابات والاغتيالات والمؤامرات وسفك الدماء، عصر يصبح عنصر المفاجأة في أن يستمر السلطان في الحكم ويتوفى وفاة طبيعية، يلخص فكري التاريخ قائلاً: “يخطئ البعض فيحسبون أن التاريخ يعيد نفسه، وإنما ـ في حقيقة الأمر ـ الإنسان هو من يعيد ارتكاب أخطائه”.
عُلا أحمد