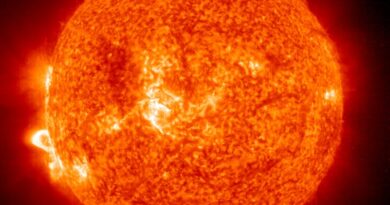اليويو!؟
د. نهلة عيسى
أنا رفيقة وفية للطريق, أي طريق, سواء كان براً أو بحراً أو جواً, إذ بالكاد يمر أسبوع في حياتي لا أكون فيه على سفر, ومكرهة أرى, لكن تراكم ترون ما أرى؟ بأن أيامنا هذه مصابة بما يشبه الجنون, أو بمن يكون سالماً, هادئاً, مسالماً, عائداً إلى بيته آخر النهار, وفجأة عند باب البيت يكتشف أنه أضاع مفاتيح البيت، فيقف مذهولاً, خائباً, ظاناً أنه بلا ستر ولا غطاء, وأن زناة الليل على المفارق يترصدونه وهو بلا باب, لكي يغلق الباب!؟ فيتصاعد نشيج البكاء في حلقه, ويكتم الدموع, ويرد على السؤال العبثي: أين مفاتيحك؟ بالهراء, بأن المفاتيح مع الحراس, والحراس سراة ليل, تخفيهم العتمة, ولذلك لا يراهم, ولكن المفاتيح في أمان, والبلد أمان, وحراسها ساهرون.
تراكم ترون ما أرى؟ أن حياتنا بكل تفاصيلها باتت أشبه “باليويو”, نرميه باتجاه الأرض فيرتد إلى وجوهنا في طريقه إلى الأعلى, وكلما ظننا أننا عليه سيطرنا, اكتشفنا أننا نحن “اليويو”! وأن اللعبة التي نخوض أكبر من كل سيطرة, فيتصبب العجز من وجوهنا دموعاً, ونقول في سرنا: عقولنا تداري جنونها أوراق التوت, وليس أبشع من الجنون, سوى مدارة الجنون!.
تراكم ترون ما أرى, أن صمتنا الممدود كالنداء, أقرب إلى الاستغاثة ما يكون, فنراهن على النسيان, ربما يكون حلاً لفك شراك العنكبوت من عقولنا المتعبة, لعله يكون الدواء, ولكن كل ما في حياتنا يحدق فينا بوجوم أقسى من الإدانة, ويهمس: خاسر رهانكم, لا دواء لجنونكم, في عقولكم رعد, وأسوار, وأمطار, ومساحات من ليل بهيم, ونوافذ مغلقة سوداء, وراءها أسئلة, وخلف الأسئلة صخور, كلما فتحتم نافذة داهمكم سؤال, وكلما بحثتم عن إجابة, اصطدمتم بالصخور!
أعود للسؤال: هل ترون ما أرى, وإياكم والغمغمة, والقول: ربما لو استرحنا, ربما لو غفونا, ستفتح النوافذ على نهار بأجوبة, لأن ذلك هراء الهراء, نحن نحدق في صخر, فيرتد البصر جداراً, فنتسلق الجدار على ركام ما بقي في عقولنا الخربة من ذكريات, فنقع, فنعاود المحاولة, نعانق الجدار, نتحايل على قساوته بنقش الأسئلة, وندمدم في أذني الجدار: نعرف أن أجوبة أسئلتنا انتحار, فلا تبح بما ترى, ولا تقل لنا ماذا جرى, فيتلقف الجدار الثرثرة: يا صاح أنت وهو, مات الذين يجيبون, ويعرفون ما كان وما سيكون, خوفكم هو الصخرة, والحقيقة هي الجدار, المعرفة وجع, وأنتم هاربون من الوجع بالجنون، والهارب لا يحق له السؤال: لماذا أنا؟ فقد كنت من الواقفين على الضفاف, لا قاتلت بسيف الحسين, ولا أكلت على موائد يزيد, لماذا أنا؟ فقد وضعت في أذني سماعتين تبثان صوت كمان, لا أزيز رصاص أسمع ولا صوت القذائف, ولكن بغتة صار الكمان كعوب بنادق, وصار يمام وحمام الحدائق قنابل تسقط فوق الرؤوس في كل آن, لماذا أنا, ولماذا غاب الكمان!؟
لأنه دون أي تلعثم, ولا ارتباك, ولا ملامح جنون, سيصيح في وجهه ألف وجه ووجه: يا صاحب الكمان, وقوفك على الضفاف, منتظراً ملكاً أم كتابة, قادك إلى الصخور, لأنك لم تحسب حساب أن من يرمي العملة يتلاعب بالمراهنين, فالعملة وجهان, وجه لملك يبني رامي العملة عرشا له من الدماء, والوجه الآخر للمراهنين البائسين, وليس للكتابة!؟
يا بائس الرهان: من يرمي العملة يمسك بالوجهين ليضيع الوطن بين بين, بين صخور وقف عليها أمثالك المراهنين, فدارت الأرض دورتها, وباتت صخوركم بصر, وبين الحالمين بملك وجاه ومال على جماجمنا, يدفعون ثمن كل ذلك.. وطن، يا صاح: أنت وهو, عودوا إلى ادعاء الجنون, لاشيء في ما نطقتموه صواب سوى أنكم تهربون من ارتداد “اليويو” نحوكم, فتصبحون “يويو”!!