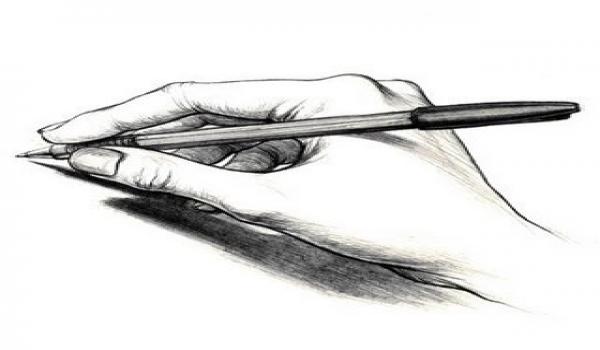غياب النّقد والسؤال الفلسفي يؤبّد الصّنميّة الفكريّة
هل من شكّ بأنّ من أسباب تخلّفنا الفكري عموماً، غيابُ النقد عن أدبيّاتنا وثقافتنا الموروثة، والمعاصرة عموماً؟، وأقصد هنا النقد الثقافي الذي تنضوي تحت عباءته كلّ صنوف النقد المختلفة، ومن ضمنها النقد الأدبي. وحتى لو وُجِدَ لدينا بصفةٍ ما، فهو نقد متخلّف عن حركة الإبداع شعراً ونثراً وثقافة وفنوناً مختلفة، نقد بأدوات عتيقة صفراء أكل عليها الزمن وشرب. وهذا ما نراه في الكثير من المؤسّسات الثقافية التربوية والأكاديميّة. حيث يُعاد إنتاج المكرور والمستنسخ بشكلٍ دائم.
ما نريد توضيحه هنا بالتّحديد هو غياب النقد المواكب والمقوّم للحركة الأدبيّة عموماً “شعريّة ونثريّة”، وبقاء الأسماء المكرّسة ذاتها، لعقود طويلة في واجهة المشهد الأدبي، رغم أنّ التربة العربيّة والسّوريّة خصوصاً، تربة ولاّدة وخصبة. حيث يوجد الكثير من النِتاجات التي حقّقت حضوراً مختلفاً وإن بنسبٍ متفاوتة. إذ يكاد لا يعرف الكثيرون في المجال الشعري أسماء شعراء غير “نزار قباني، وبدوي الجبل وعمر أبو ريشة والماغوط”، وهذا الأخير بالتحديد، عُرفَ نتيجة انتشاره مسرحيّاً وتلفزيونيّاً، لا شعريّاً. ولا يُعرف في المجال الروائي سوى “حنا مينه” أيضاً ليس بسبب كثافة قراءته، كما يبدو لأوّل وهلة، لأنّنا نعيش مرحلة من مراحل السّبات الذّهني والأميّة الثقافيّة التي لا نحسد عليها، بل لانتشاره بصريّاً، حيث اسُتلهِمَ الكثير من أعماله كأفلام ومسلسلات تلفزيونيّة، وحقّقت رواياته العديد من الجوائز، كذلك بسبب تخصيص جائزة باسمه في وزارة الثقافة. كما لم يسمع الكثيرون باسم “حيدر حيدر” إلا بعد الضّجّة واللّغط اللّذين أثيرا حول روايته “وليمة لأعشاب البحر”، فكيف باسم الروائي المهمّ “هاني الراهب”!. وربّما سمع البعض باسم “عبد الرحمن منيف” بسبب صدى بعض رواياته السياسيّة “شرق المتوسّط، بنسختيه الأولى والثانية ومدن الملح”، أمّا الرّوائي “ممدوح عزّام” فالزّوبعة التي أُثيرتْ حول روايته الجميلة “قصر المطر” كانت السبب في انتشاره. أمّا في القصّة القصيرة فتكاد تغيب حتى أسماء الجيل المؤسّس لها عن الأذهان “من أمثال سعيد حورانيّة، وعبد الله عبد، وزكريا تامر وغيرهم”.
ربّما سيتضح السبب لنا بغياب الجديد والمبتكر لدينا، إذا قارنا مجتمعنا العربي بالمجتمع الأوروبي، بل وحتى إذا قارنا المرحلة الحالية بمرحلة النهوض في الستينيات مثلاً، حيث شاعت الأسئلة والطّروحات الفكريّة الجديدة المتأثرة بحركة الترجمة في الغرب. والذي حدث هناك هو، أنّ النّقاد والمفكّرين هم من قادوا وحفّزوا النّهضة الإبداعيّة الأدبيّة. فمثلاً المفكّر الوجودي “هايدجر” هو من أضاء على تجربة الشاعر “هولدرلن”. والنّاقد البنيوي “رولان بارت” هو من وضع أسساً جديدة لتلقّي النص الأدبي الجديد، وكذلك فعل كلّ من “تودوروف وباختين”، و”سارتر وميشيل فوكو” وغيرهم في حفريّاتهم المعرفيّة المختلفة.
طبعاً المقارنة قد تبدو تعسّفية إذا أُخذَتْ بالمعنى الشكلي، فنحنُ لا نتجاهل الاختلاف الكبير بين طبيعة وبنى المجتمعات الغربية ومثيلاتها العربيّة، ولا الفعل التراكمي الموضوعي لكلّ مجتمع حسب خصوصيات تاريخه وثوراته الفكرية والسياسية والاقتصاديّة المسبقة التي أنجزها ليحقّق ثورته الثقافيّة الشاملة هذه، لكّننا نحاول أن نضيء جانباً مهمّاً غيّب لسببٍ أو لآخر، وهو غياب الأسئلة الفلسفيّة والفكرية بالدرجة الأولى، حيث يكاد يكون السؤال معدوماً لمصلحة الإجابات المعلّبة الجاهزة، فلا جواب عصرياً لدينا، بل كلّ أجوبتنا في الماضي الذي أنجز لنا كلّ شيء، ومن ثمّ توقّف الزمن عنده بلا حركة. وهذا طبعاً أبسط ما يُقال فيه أنّه ضدّ الحقيقة العلمية والتاريخيّة حيث لا ثبات في شيء. هكذا تُحاصر الأسئلة لدينا بذهنيّة ضيّقة لا تجرؤ على الخروج من سيطرة النصّوص التاريخيّة التي أكسبتها الأعراف صفة القداسة. وأصحاب هذه الرؤية يتجاهلون حقيقة أنّه حتى النص المقدّس، ما هو إلا نصّ ثقافي حيويّ قابل للقراءات والتّأويلات المختلفة التي تحترم خصوصيّته وغناه في الوقت نفسه. الفرق الجوهري بيننا وبين الآخر، هو أنّ الغرب كسر أصنامه الفكريّة ونحن حافظنا عليها بحجّة الخوف من ضياع الهوية، وهنا نسأل سدنة الماضي الأجلاء: أحقّاً لدينا هوية واضحة الآن؟.
الحصار الذي يعانيه الفكر والإبداع العربيان هو حصار الفكر من قبل الذّهنيّة السلفيّة المجترّة والقراءة ذات الطيف الواحد للموروث ونصوصه المقدّسة، وحيث ينعدم الفضاء الفكري سينعدم المحيط الصّحي الذي تتطلبّه الأسئلة لتتنفّس بحريّتها، الفضاء الذي ستكسر مطارقه كلّ جليد وتكلّس يغلّف الفكر ويحدّ من نموّه. ولن نجد مثل هذه الأجوبة الواسعة ولا الأسئلة الجادّة والجديدة التي تؤسّس لنقد حقيقي، مع هذا الحضور الكثيف للمسلّمات الفكريّة وغيرها من معرقلات التطوّر. ومع غياب الجدل، لن نرى إلا ما نراه من الخفوت الشّديد للرؤية النقديّة. إن انعدام الحريّة الفكرية يخنق السؤال الفلسفي ويعدم مفردات التّجديد، والغياب القسري للنقد والفكر الفلسفي يجعل الإبداع بلا ضوابط حقيقيّة، أقصد بالضّوابط الحقيقية لا المعايير الصارمة، بل فقط تلك التي نستطيع من خلالها فرز الغثّ من الثمين، والتي قد يعكس غيابها أحياناً حالة صحيّة في مرحلة ما من مراحل النّضج.
باختصار، ما ينقصنا من حيث الجوهر، هو القدرة على إنتاج أسئلتنا الفكريّة بحريّة، تلك الأسئلة التي ستحفّز بدورها وديناميّتها أسئلتنا النقديّة، وبذلك ستوضع عربة الإبداع على السّكّة الصّحيحة، العربة التي يجرّها حصان النّقد لا العكس.
أوس أحمد أسعد