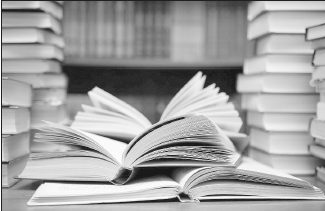لوثة القراءة والحفاظ على شباب الحواس!!
“البعث الأسبوعية” ــ أوس أحمد أسعد
للقراءة طقسٌ يخصّها، شيء أشبه بصلاة يوميّة يؤدّي فروضها الكائنُ تقرّباً من ذاته المفطومة على السؤال أوّلاً، وتآلفاً مع وجوده الاغترابي في هذه الحياة ثانياً، إذ لا بدّ لكلّ قارئ حقيقي أن يستفتح يومَه، بصلاةٍ “باشلاريّة”، يوجّهها لإله القراءة، تقول: “اللّهم أعطنا كَفاف يومنا من غذاء الروح والعقل، اللّهم أنزل لنا من السماء أكداساً من الكتب لنلتهم فحواها، وسلالاً من ثمار المعرفة وعناقيد الحكمة والفلسفة، لنسير بهديها، أليستْ السّماء مكتبة هائلة؟!”.
حقيقة، القراءة مرض مزمن، لا يكاد يخرج أصحابُه من لوثة ارتياد المكتبة إلّا ليعودوا إليها من جديد، فهم قوم لا يشبعون من المعرفة، ولا يتركون كتاباً إلّا بعد أن يحيلهم عبر دهليز مراجعه إلى حديقةٍ خلفيّة مليئة بالكتب؛ كائنات مهووسة بتحصيل المعرفة وهضم مضامينها؛ كل حيّز لديهم هو مشروع مكتبة: الصالون، الكرسي، غرفة النوم، المطبخ، وسيلة السّفر، الحقيبة.. إلخ؛ كلّ فراغ تقع عليه أعيُنُهم يمكن تحويلَه بلمحة بصر إلى مشغل ثقافي يعجُّ بالأوراق والقصاصات والمراجع والأغلفة والعناوين الدّسمة التي تدعوك لالتهامها، وتحويل فحوى كتبها إلى وجبة أساسيّة يوميّة تضيفها إلى وجبة إفطارك الشّهي؛ وثمّة عناوين تراوغكَ لفترة، وما إن ترى منك غفلةً، حتى تُلقي بنفسها في مهبّ رياحك، فلا تجد مناصاً – وأنت الكائن المتقلّب المزاج – إلّا أن تلبّي نداءَها الدّفين، وستلمس سرعة مفعول إكسيرها عليك فهو سينتشلكَ من كلّ كربٍ، مرمّماً فراغات روحك وتصدّعاتِها، محلّقاً بكَ في فضاءات التّيه.
وهناك التّعلّق الهوسي أيضاً، هل جرّبتَه يوما؟! أن تكون مهووساً بكتابٍ ما سبق وأهملته دون وعي، وها هو يعود إلى شاشة ذاكرتك بطريقة ملحة، غريبة: من مرأى حصاة أتقن النهر صقلها وتشذيب حوافها، أو من منظر عشبةٍ تغفو تحت ظلّ فراشة، أو من رسمٍ ماطرٍ على جدار الأفق تجلّى لكَ في لحظة انخطاف وديع، أو من لثغة نبعٍ تناهتْ إلى مسامعك من أعماق الجبل، وكنت على أهبة الموّال؛ وسرعان ما ستتساءل بدهشةٍ، وأنت المستغرق في مرايا ذاكرتك ومخيّلتك: كيف أهملتَ يوماً الكثير من الشّذرات المعرفيّة والكتب؟ لماذا لم تتقن موهبة الانتباه أكثر ممّا انتبهت؟ لماذا لم تصغِ إلى نبض الأشياء أكثر مما أصغيت؟ لماذا لم تتحاور مع الموجودات اليانعة التي تحفّ بكَ من كلّ الجوانب؟ لماذا أهملتَ أغصاناً وعثاكيل، مثقلةً بالثمار، كانت تتدلّى من حولك وتستمطرُك قطفاً؟ لماذا مررتَ مرور المحايد بتلك الجملة التي تكاد تثمُل الرّوح من ثقل خمرتها؟ ولماذا؟ ولماذا؟ وبالوقت نفسه ستندم على تحمّلك حماقات وأفكار الكثير من الكتب التي هدرتَ وقتكَ في قراءتها.. حينها، ستعي أنّك كنت ضحيّة سطوة أسماء كتّابها المكرّسين ونجوميّتهم الفارغة، الذين كنتَ تنبري للدّفاع عن أقوالهم المستهلكة بهشاشةِ وثقةِ قارئ مسحورِ متمرّنٍ على الصراخ والمنبريّة، بصرف النّظر عن قيمتهم الإبداعيّة والفكريّة، عموماً. أمّا وقد وعيت لكلّ هذا الخراب في الذائقة والهدر في الطّاقات، فما عليك سوى الغربلة والاصطفاء لكلّ ما لا يليق بك ككائنٍ معرفي ثقافي، بأن تنزع من رفوف مكتبتك الكثير من العناوين البرّاقة التي تبيّنَ بالتّجربة القاطعة أنّها، لا تصلح أكثر من وقود للحمّامات. كما يجب عليك، بالوقت نفسه، أن تعتذر إلى كتبٍ أخرى كنت قد تجاهلتها لنقصٍ معرفي، وأن تنفض الغبار عن أغلفتها؛ وستصل هنا، إلى اكتشافٍ مذهل بأنّه لا توجد معرفة مكتملة ولا أجوبة نهائيّة، ولا كتاب شامل يُغني عن غيره؛ لذلك بدل أن تنام على مخدّة ثقافتك وحريرها، مدّعياً الامتلاء، علّم قلبَك وروحَك التّواضعَ، علّمهما فنّ تلقّي الأشياء بفطرة مثقفة جديدة، ولا تدع الزمن يقف عائقاً دون تحقيقكَ ذلك، فما اكتشفتَه مبكراً كنتَ جديراً به، وما ستكتشفُه متأخّراً سيكون له بريق البهجة والإضافة والدهشة الأجمل؛ وستتساءل بحرقةٍ: كم من المسافات الزمنية المهدورة التي انقضتْ، يوماً، بين القراءة المتأنية على ضوء الشّمعة أو “قنديل الكاز”، والقراءة السّريعة، الآن، على ضوء الفضاء الأزرق الافتراضي اللّامتناهيّة. ما كان يلزمُك، كقارئ حقيقي، لتحظى بكنز خصوصيّتك المستحَقّ، هو موهبةَ الاهتداء إلى هسهسة المطمور تحت جلد الأشياء، وأن تبادر إلى نبشه بثقة آثاريٍّ حكيم يجيد إزالة طبقات الأتربة المتراكمة، بإبرة دقيقة، أو بقشّة، بحثاً عن بقايا حجرٍ مدفونٍ منذ مئات السنين، محاذراً ألّا يخدشَ غفوته الأبديّة، بحثاً وتنقيباً عن المعلومة الحقيقيّة المثمرة، والإيمان بها بقوّة. ومن ثمّ الجرأة على نسفها وتقويضها أيضاً، لو تطلّب الأمر ذلك. أليسَ السّعي المحموم لاستكمالِ النّقصِ هو الدّافع الأهمّ للمعرفة؟!
في سرديّة من سرديّات “ألف ليلة وليلة” (الحكاية تحت حدّ السّيف)، أقصد مرويّات شهرذاد وشهريار، تجتمعُ الحكمة والشّاعرية بآن: الحياة والموت في سلّةٍ واحدة، موهبة القصّ المشوّق التي أطالت حياة شهرذاد والشّغف الطفولي المعرفي لدى السّياف شهريار، الذي ساهم بأنسنة ذئبيّته، فكان أن أدّى لنموّ موهبة الإصغاء لديه. تلك الموهبة التي يجب أن نتدرّب على تحصيلها جميعاً – نحن أبناء الثّقافة الصّراخيّة – وأن نتقنها كفنّ حقيقي من فنون المعرفة المثمرة، دون خوفٍ من سيف مسلّطٍ فوق أعناقنا، إذ ما الذي جنيناه من الصراخ والصّخب، وهدر الوقت حتى الآن كمجتمعاتٍ عربيّة وأفراد؟! ما ينقصنا هو حسن الهضم المعرفي، والإصغاء إلى موسيقا الأشياء وهي تتغلغل على مهلٍ في تلافيف الكون.. يكفينا أن نشمّ طبخة الكتاب من السطور الأولى، من عنوانه الباهت، أو الصقيل، لنعرف أهميّته من عدمها؛ وقد يتسرّبُ عطر سرّي من مفازات عبارة لا يتعدّى حجمُها الكلمات الثلاث، يجعلنا ندوخ “السّبع دوخات” قبل أن نصل إلى قواريرها، وقد لا نصل؛ ففي المحاولة متعة، ويا لها من متعة! وما علينا أخيراً سوى أن نحافظ على شبابِ حواسنا، ونحميها من صدأ التّنميط والاستنساخ، لأنّ في شيخوختها مقتل لكلّ معرفة مهما كانت.