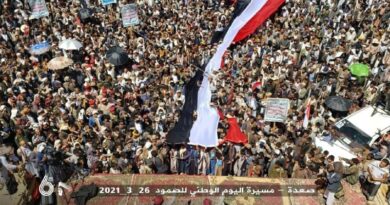التّرجمة فنّ أم صنعة؟
يقول المشتغلون في مجال التّرجمة، بأنّ أصعبَ أنواعِها وأكثرَهَا مسؤوليّةً: ترجمة النصّ الإبداعي الشعري، حيث لا يكفي الإلمام باللّغتين أو الثّقافتين الناقلة والمنقول منها، ولا الحِرَفيّة وطول الباع في هذا المجال، على أهميّة ذلك، بل ثمّة حساسيّة إبداعيّة خاصّة لابدّ من توفّرها لدى مترجم الشعر بالتّحديد تضاهي حساسيّة منتجِ العمل الإبداعي نفسِه في ثقافته وبيئته الأصليّة قبل ترحيل النّصّ إلى حاضنته الجديدة، كما يجب أن يكون هناك تكافؤ بين طاقات وجماليّات اللّغتين. إنّها عمليّة كيميائيّة معقّدة تتطلّب مزجاً للعناصر المختلفة من هضم وتمّثل وإعادة إنتاج وتحويل. فما يبدو ظاهريّاً وكأنّه مجرّد نقل عادي للنّص من لغة إلى أخرى، هو بالجوهر تحويل حيويّ من ثقافة إلى أخرى، ومن تداول إلى آخر، ومن مزاج تلقٍ إلى آخر، من ذائقة إلى أخرى. تحويلٌ ديناميّ يُتقن التقاط إشارات وشيفرات النّص بجيناته المتوارثة في بيئته الأم، وإعادة شحذها وتفعيلها في اللّغة الأخرى كشأن عمليّة “طفل الأنبوب” عالية الدّقّة، وما تتطلّبه من توفير صحّي لكامل مقوّمات نمو الجنين في رحمه الجديد، وهنا تظهر التحّديّات والعراقيل جليّة أمام مترجمي الشّعر، كأن يكون المترجم من أنصار المدرسة الحرفيّة المعجميّةـ لعلّ التّرجمة الحرفيّة هي أقصر الطّرق وأيسرُها، فينقل النصّ الشعري الضّاج بالحيويّة المشتعل نشاطاً من رحم مياهه البدئيّة الدافئة، إلى وسط مياه لها سمات فيزيائيّة مختلفة، نقلاً ميكانيكيّاً، ليبدو أشبه بجثّة لا رجاء منها. وحجّة المترجم الواهية هنا: هي عدم خيانة النصّ.
وثمّة أخطاء جسيمة يجب ألّا تهفو عنها أيّة ترجمة تتعلّق بمعنى وجوهر النصّ وفشل المترجم في نقله إلى اللغة البديلة، أمّا الهفوات البسيطة فيمكن استدراكها نسبيّاً كتلك التي تتعلّق بإعادة تّدقيق النّص وأسلبته وصياغته بشكلٍ أفضل. أمّا الطريقة الأجدى والأدقّ والأصعب، فهي أن يختار المترجم الخوض في مرجعيّات تحفّ بالنصّ الأصلي من ثقافة وتداول ومزاج لينتج مقابلات مقبولة لها، لكنّها محفوفة بمزالق عديدة قد تؤدي إلى إساءة القراءة وأخطاء في التّأويل، وهذا ما تتكشّف عنه التّرجمات المختلفة لرباعيّات الخيّام، وترجمات سونيتات شكسبير إلى العربيّة، الأشبه بالتّعريب، حيث يُنقل النّصّ من لغته الأصليّة بتصرّف، بما يتناسب وشروط البيئة الجديدة ولغتها ومحرّماتها الثّقافيّة، وتلك طريقة مترجمي عصر النّهضة، كالمنفلوطي مثلاً.
وهناك أيضاً من يقول بأنّ الترجمة الأدبيّة “فنّ” بينما الترجمة الوثائقيّة “حرفة” أو صناعة وهذا برأي البعض خطأ شائع، حيث الفنّ ليس سوى الدرجة المتقدّمة من الحِرَفيّة، وهذا يتطلّب التزاماً أكبر بالمعايير والاستراتيجيّات الصّارمة، فالجودة الأدبية لا تأتي من خارج المعنى، والنص الأدبي يخاطب العقل والأحاسيس بما يشبه إثارة الاضطراب والخلخلة التي ستؤدي إلى ما يشبه التّنظيم أو التّطهير، بينما ترجمة العمل الوثائقي لا تتطلّب سوى العقل، لذلك طاقة العمل الأدبي تتناسب طرداً مع طاقة المؤلف وقدراته على إقلاق القارئ وتحفيزه للانفعال الأمثل، عبر شحذ ملكة التّخييل لديه. وهنا سأذكر بعض الأعمال الأدبيّة الماتعة على الأقل بالنسبة لي، والتي تمكّن أصحابها من تحويل النصّ الإبداعي الأدبي “شعراً، رواية” بكامل طزاجته وحيويّته وجودته إلى اللغة الأخرى، ليبدو وكأنّه يتنفّس برئات ثقافته ذاتها. ينطبق هذا على ترجمة “أدونيس” لـ”سان جون بيرس” و”إيف بونفوا” عن الفرنسيّة. التّرجمة التي جعلت القارئ يذهب بتخييله إلى الحدّ الأقصى متفاعلاً مع لغة النصّ المجنّحة القابلة للكثير من التأويل. وهذا ما لمسته في ترجمة “عبد المعين الملّوحي” لكتاب “داغستان بلدي” من الرّوسيّة إلى العربيّة، لمؤلّفه الشاعر “رسول حمزاتوف”، حيث تبدو فيها الرهافة الشّاعريّة والحساسيّة الأدبيّة المتشبّعة بجماليّات ثقافة الآخر واضحة، لا تقلّ عن مقابلاتها في اللغة العربيّة الزّاخرة بكل صنوف الجمال والثّراء. وكذا الأمر مع رواية “زوربا” التي ترجمها الشاعر ممدوح عدوان، بكامل روحيّتها المتعويّة الأبيقوريّة وفلسفتها الوجوديّة، لتصبح عند الزّورباويّين مذهباً في فنّ الحياة والعيش. وهذا ما وجدته أيضاً في ترجمات الصّديق “عبد الله فاضل” المهجوس برؤية تقديم نصّه بصيغةٍ إبداعيّة تضاهي قيمته الأصليّة في لغته الأم. رؤية تتبنّى معايير تقديم النّصّ كمنتج ثقافي، يتمتّع بالجودة والأمانة المطلوبتين، وهذا ما نجده عموماً في ترجماته لكتب مختلفة تتعلّق بتحرّر المرأة. لكنّني أقصد هنا بالتّحديد، ترجمته لرواية الكاتب البريطاني “جورج أورويل” “الخروج إلى الهواء الطلق”، إذْ استطاعت روحه الشفافة وحرفيّتهِ أن تلمّا بكلّ تفاصيل عمليّة الترجمة الإبداعيّة، ليبدو النصّ المنقول وكأنّه نتاج بيئتنا العربيّة ذاتها. وذلك لما يتمتّع به المترجم نفسه من حسّ جمالي شاعريّ ورهافة التقاط ومجسّات مثقّفة بأدواتها، دائبة البحث عن كل ما يُغني ويُضيف. مجسّات لا يستقرّ لها بال وهي تنقّبُ عن جذور وتاريخ الكلمة ونموّ إشاراتها ومدلولاتها التّاريخيّة والثّقافيّة في لغتها الأمّ، قبل نقلها بكامل حيويّتها وطاقتها الإبداعيّة إلى اللّغة العربيّة. وكم بدتْ البيئة اللّندنيّة في أربعينيّات القرن العشرين شبيهة ببيئتنا العربيّة ومفرداتها الثّقافيّة المتداولة إلى حدّ الإدهاش.
نهاية نقول: بما أنّه لا يوجد نصّ إبداعي مكتمل -كون الاكتمال صفة مرادفة للانغلاق وبالتالي النّقصان- لذلك لا توجد ترجمة باعتبارها إعادة خلق جديدة للنص، مكتملة.
أوس أحمد أسعد