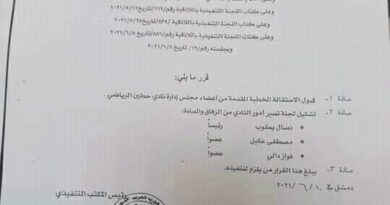كيلا يُفهم الإسلام من أعدائه الرئيس الأسد: زمن العقائد لم يولِّ
د. عبد اللطيف عمران
في نهاية القرن الماضي، وبعد سقوط منظومة أوروبا الشرقيّة، انتقل الغرب من استراتيجية العداء للشيوعية إلى العداء للإسلام وتوظيفه، في سياق طرح مستشاري الأمن القومي الأمريكي لـ” نهاية التاريخ”، ولـ “صدام الحضارات”، وساد في العالم فهم للإسلام من خلال أعدائه في الداخل) التطرّف والإرهاب)، وفي الخارج (مركزية الغرب) المرعيَّة من الليبرالية الحديثة، والإمبريالية المتوحشّة، والعولمة العابرة والمحطّمة للحدود الوطنية تحت ظل المحافظين الجدد، فكان (الجهاد) كذلك من رعاية الداخل والخارج، رعاية البترودولار، فدخلت اللفظة كما هي كجذر لغوي JIHAD دون ترجمة إلى لغات العالم.
وفي الوقت الذي كرّست مركزية الغرب طرح سقوط الإيديولوجيا والعقائد، فإنها ركزّت استهدافها الإحيائي للأصولية في الشرق، وتحديداً الشعوب الإسلامية، فتحولّت الأصولية من) الأصل) إلى التطرف، فالتعصب، فالإرهاب.
في هذا السياق، طرح الرئيس بشار الأسد سؤالاً مهمّاً في لقاء سيادته مع الاجتماع الدّوري الموسَّع الذي أقامته وزارة الأوقاف، في جامع العثمان بدمشق، يوم: 7/12/2020 من المسؤول عن تقدّم الأعداء وتراجعنا؟. وأتى هذا السؤال مشفوعاً بالإجابة في سياق حديثٍ غنيٍّ جدّاً، ومتنوِّع، لكن الفكرة المركزيّة فيه هي: وضع الخطط القائمة على الحوار وليس على الغضب وردّات الفعل لنتقدّم نحن ويتراجع الأعداء.
حديث السيّد الرئيس سيبقى مهمّاً، ومثيراً لعدد من التساؤلات والأفكار والآراء، ومنها: هل قرأت الحديث؟. نعم سمعته وقرأته وفهمته لكنني بصراحة بحاجة لأثق بإجابتي إلى إعادة قراءة – هل تستطيع أن تلخصّه لي؟. لا، الحديث موسّع جدّاً لا يمكن تلخيصه، بالعكس هو بحاجة إلى شرح –ما الهدف من الحديث، وما الرسالة التي يحملها، وهل الخطاب موجَّه إلى المؤسسة الدينيّة وحدها، والتي نغبطها على حظّها الجيّد في هذا الحديث التاريخي؟.– ولماذا لم نسمع هذا بُعيد2011؟ هناك ضرورة لترجمته إلى أكثر من لغة، وطباعته، وتوزيعه ليندرج في التصور العالمي المغاير عن الإسلام والعروبة، وبالمحصلة لابد من إعادة قراءته لأنه أهم مما سيُكتب عنه…
لا شك يستحق هذا التركيز على الإسلام (كدين) إعادة القراءة، لأن الغرب يصوغ تصوّراً عالميّاً عنه يدخل في نطاق التوظيف، فالاستثمار، فالابتزاز، ويسهم في هذه الصياغة بأشكال متباينة باحثون إسلاميّون من غير العرب، من أمثال إعجاز أحمد، وطارق علي، وطلال أسد، وسلمان رشدي … إلخ. أما من العرب فالإخوان المسلمون وداعش والنصرة، وهذه معضلة اقتضت من السيّد الرئيس هذا التوسّع، فالغرب يدرك أن (الشرق عقائدي ديني يدخل الدين في جوانب الحياة كلها، لذلك يعمل على أن يكون الدين أداة لتخريب المجتمعات، ولو لم نمتلك عوامل المواجهة لغرقنا من الأسابيع الأولى التي تم فيها توظيف الدين لضرب عقائد المجتمع ورموزه.. ونحن مصالحنا لا تنفصل عن عقائدنا…، فزمن العقائد لم يولِّ).
نعم، لم يولِّ، ويبدو أنّه لن يولّي، فمفكّرو الغرب يعترفون بأن الإدارة الأمريكية عبّأت القوّات الإحيائيّة – الصحويّة – لليمين الديني الأمريكي قبل، وخلال، غزو العراق.
وفي الغرب سجال واسع ومهم وغنيّ حول دور الدين في الحياة العامة، ومنه ما يطرحه أهم مفكّر فيه الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني هابّرماس، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وغزو العراق، وحتى اليوم عن دور (الدين في الفضاء العام) – نشره عام 2006 – من أننّا نعيش في عالم “ما بعد علماني” الذي يجب عليه التكيّف – التصالح – مع الوجود المستمر للدين الذي حظي بأهميّة سياسيّة غير متوقّعة حتى الآن، فنقدَ هابّرماس التصوّر الأوروبي المهيمن على (أديان العالم)، ودعا تسهيلاً للتواصل العقلاني إلى إدراج الأصوات الدينية في الحياة العامة، حتى السياسية منها، كيلا يكون التصوّر الديني محصوراً بعدسة غربيّة، بل مرتبطاً بالوعي التاريخي.
لذلك أكد السيد الرئيس على علاقة الدين بالمجتمع في معرض حديثه عن معضلة: (اتبّاع الرسول “ص” في العقيدة ومخالفته في السلوك)، وإلى: (توسّع العمل الديني الجماعي ليكون هناك حوار مع الطوائف المسيحية، فالدين القوي لا يخشى من رأي الآخرين بل يحترم خصوصياتهم ورغباتهم ومصالحهم). وفي هذا السياق، كان الحديث عن الدين – كدين – إسلامياً كان أم مسيحياً، مرتبطاً بالعروبة التي تحدّث فيها سيادته (بالمعنى الحضاري وليس بالمعنى العرقي) إشارة إلى الدور الذي سجّلته المسيحية العربية في النهوض بالفكرة القومية، ولم تمنعها مسيحيتها من العمل لتمكين لغة القرآن وثقافة الإسلام العروبي، وليس من المفارقة في شيء أنهما تتعرضان اليوم في وقت واحد لهجمة مشتركة يشنّها تحالف إسلام البترودولار مع المسيحية الغربية الاستعمارية.
وبقدر ما كان الحديث مع العلماء والعالمات إسلامياً، فإنه رسالة إلى السوريين جميعاً، وإلى العروبيين، إلى الفرد والمجتمع والمؤسسات والدولة، حيث المعاناة من أننا (نعيش كمجتمعات أزمة هوية منذ العهد العثماني.. لضرب العروبة والإسلام، ولضرب جوهر المجتمع)، وها هي الأزمة تُستحضر الآن مع العثمانية الجديدة والحاقد أردوغان الذي يستثمر في العنف وفي المقدّس على السواء، ما يذكّر بأهمية ما طرحه رينيه جيرار في كتابه المهم (العنف والمقدّس) من أول فصل حول: الأزمة الذبائحية، إلى الأخير: وحدة جميع الطقوس.
وللحقيقة، والواقع (لو تخاذل الجيش لانتصر الإرهاب، ولو تخاذلت المؤسسة الدينية لانتصرت الفتنة)، إذ لا قتل بلا فتنة، ولذلك قيل: الفتنة أشد من القتل، وستبقى روحانية الشرق وعقائديته وتديّنه النقي عامل القوة الأكثر تأثيراً في صياغة موقعه ودوره، حيث لا يكون الدين مرادفاً للطاعة والاستسلام، ولا في مواجهة التحرر والتوق إلى التخلّص من الأغلال التي تحاول تقييد الإنسان إلى (جوهر) مبتذل.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة قراءة الحديث وإلى مثاقفته، والحوار في مضامينه وأبعاده.