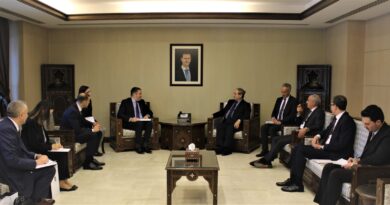د. بندك: التاريخ مسرح بلا حدود أغلبه مزيف
حلب- غالية خوجة
منذ بداية السبعينيات، كانت فترة التأسيس والعمل مع فرق الهواة كممثل، والاشتراك في المهرجانات المسرحية التي تقام بين دمشق وحلب، ومنذ عام 1980 بدأت بتجربتي الإخراجية الأولى، بهذه الكلمات بدأ الحوار مع الدكتور وانيس بندك المولود بحلب عام 1955، وهو من أوائل المخرجين المسرحيين السوريين الذين تحدوا كافة الظروف المعيقة، وأثبتوا أن الفن والثقافة سلاح حضاري نوراني، ومن سيرته أنه عمل على تحديث المسرح الحلبي نصياً وإخراجياً، وأسس عام 1970 الفرقة الفنية للاتحاد التي أصبحت فرقة المسرح العمالي بحلب، ثم أسس فرقة الشهباء المسرحية مع الفنانين رضوان سالم وماهر الدروبي، وبدأ منذ بداية التسعينيات بالإخراج نتيجة خبرته المتراكمة والنوعية، ومنها “إذاعة أبو محمود/1996″، وبطلها الذي استمد منه نصاً وإخراجاً لهذه المسرحية بحالاتها المتنوعة، وأهمها الوطنية، كان أبي رحمه الله، لأن عائلة بندك كانت من جيراننا القدماء الأوفياء، ومازال يتابع مسيرته الإبداعية إخراجاً وكتابة قصصية ومسرحية، ومن إصداراته: “الصيف المجنون”، “الكلب المطرود من الغابة”، “لا شيء يحدث.. لا أحد يجيء”.
ولكن، ماذا بين دراسته للتأريخ في جامعة دمشق، ودراسته للفن المسرحي في جامعة يريفان؟
أجابنا بندك: التاريخ مسرح كبير لا حدود له، فهو مليء بالأحداث والشخصيات، لذلك، العلاقة بين المسرح والتاريخ كبيرة، رغم أن الذي يكتب التاريخ، دائماً، هو المنتصر، ولذلك فإن أغلبه مزيف، لكن جزءاً منه يبقى حقيقياً، وهذا ما يهمني من التاريخ الذي أعطاني مجالاً للتفكير أكثر بالماضي والحاضر، وحركته وصيرورته، كما أنه وسع خيالي ومعرفتي وجعلني أستفيد منه في المسرح بشكل إيجابي، وعندما قدمت أطروحة الدكتوراه في جامعة يريفان بأرمينيا استفدت من التاريخ، خصوصاً من الأساطير، فكانت بعنوان: “الأسطورة في المسرح السوري والأرميني المعاصر”، وخصصت فصلاً كاملاً عن الأسطورة وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في المسرح، وبعد أن أنهيت دراستي عدت إلى وطني سورية، وعملت أستاذاً في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق لفترة من الزمن، وعملت توالياً مديراً لكل من المسرح الجوال، والمسرح المدرسي بحلب.
– ماذا عن تجربتك الكتابية بين القصص والمسرح؟ وما الثيمة الفنية المشتركة بينهما؟ ماذا تكتب مؤخراً؟.
— بدأت تجربتي في كتابة القصة القصيرة بوقت مبكر قبل سن العشرين، وترافقت مع عملي في الإخراج المسرحي، وما لم أكن أستطيع قوله في المسرح كنت أقوله عبر القصة، لأن الكتابة تعطيك حرية أكبر من العمل المسرحي الذي يخضع لشروط العمل الجماعي من إدارة وممثلين وفنيين ورقابة، وهؤلاء جميعاً يحدون من طموحك ورغبتك في إيصال ما تريد.
وتابع: أما كتابتي للمسرحية فقد بدأتها في وقت متأخر، وتحديداً في سن الأربعين، لمعرفتي بصعوبة الكتابة للمسرح وخصوصيته، وذلك بعد تجارب كثيرة في التمثيل، والإخراج، والدراسة الأكاديمية، وكتابة النقد المسرحي. أما العلاقة بين كتابتي للقصة والمسرح فقد استفدت من كتابة القصة القصيرة في كتابة المسرحية القصيرة المكثفة ذات الأبعاد الكثيرة بعيداً عن السرد والإطالة، فكل كلمة وجملة يجب أن تكون موظفة بشكل دقيق يؤدي إلى الهدف الأعلى للمسرحية، ربما لهذا السبب نالت كتاباتي التي نشرت، سواء في الصحافة أو الكتب التي نشرتها وزارة الثقافة، الإعجاب من قبل القراء والنقاد الذين وجد بعضهم فيها وصولها لمستوى العالمية، وأعتقد أن المستقبل سيكون لصالح النص المسرحي القصير المكثف في عالم المسرح بشكل عام، وفي حياتنا الجديدة والمعاصرة. أما الثيمة المشتركة بين القصة والمسرحية التي أكتبها فهي الدفاع عن الإنسان المقهور على كافة الصعد، وحالياً، أحاول أن أكتب عن أحباء فقدناهم في الحرب، أو بسبب وباء كورونا.
– تهتم بالإنسان، لاسيما المهمش من الناس، هل أوصل المسرح رسالتك؟ كيف ولماذا؟.
— لقد حاولت أن أوصل هذه الحالة بشكل عام للجمهور رغم تعقيدات الظروف التي نعيشها، والتي تخلق إشكالات تحول دون أن تستطيع تأدية مهمتك الأساسية، وذلك في كثير من المسرحيات التي أخرجتها مثل: “الدراويش يبحثون عن الحقيقة”، و”سكان الكهف”، و”إذاعة أبو محمود”، و”هيا اقتلني يا روحي”، من خلال التعبير عن هذا الإنسان بلغة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، فالإنسان المهمش يستحق أن تسبر أعماقه وتكتشف الجماليات التي في داخله، لا أن ترصده كحالة تستحق الشفقة والرأفة، كما كان يحدث في بعض المسارح التي تلامس السطح، ولا تتوغل في الأعماق، لذلك كانت تتحول تلك الأعمال المسرحية إلى “ميلودراما” تدعو إلى الرثاء، وليس إلى أعمال ترقى إلى التألق والخلود.
– ما أهم الجماليات في العمل المسرحي؟.
— العرض المسرحي له جماليات كثيرة لا يمكننا تلخيصها في بعض السطور، وتبدأ تلك الجماليات في مكان العرض المسرحي، وتنتهي بالجمهور، وهذا يحتاج إلى ثقافة وتقاليد مسرحية، وهذا للأسف غير متوافر، فالمسارح عندنا ليست مناسبة للعرض المسرحي الحقيقي، فأغلبها غير نظامية ضمن المقاييس العالمية، ومازال جمهورنا يبحث عن الترفيه لا عن الفن والتثقيف.
وما بين صالة العرض والجمهور هناك النص المسرحي الحقيقي الذي يكتنز ثقافة فنية وإنسانية عميقة، ورؤية إخراجية ناتجة عن معرفة وتجربة غنية وكادر تمثيلي وفني صاحب تجارب عملية وعلمية وثقافة إنسانية شاملة، لا مجرد محاولات سطحية ومشاركات مسرحية هنا وهناك دون أي أساس حقيقي لهذا الفن العظيم.
وأضاف: إذا كانت اللوحة التشكيلية مشهداً ثابتاً يدعو المشاهد إلى التفكير والتأمل، فإن المشهد في المسرح متحرك، فهو يخلق حالة فنية لا تجعلك تسترخي، بل عليك أن تشغل عقلك بسرعة فائقة، ثم تؤلف أنت عرضاً مسرحياً يخصك، وتكتشف كل لحظة فنية على حدة، ثم تصل إلى المقولة الأخيرة التي تترك أثرها فيك لفترة طويلة وليس للحظات عابرة.
المسرحية الواحدة تضم مئات اللوحات التشكيلية المتحركة، بالإضافة إلى عشرات المقطوعات الموسيقية، والمؤثرات الصوتية المناسبة للعرض المسرحي، كل هذا يمكننا أن نسميه “سينوغرافيا العرض المسرحي”، فهو يضم كل الفنون التشكيلية من ديكور ورسم ونحت ومجسمات فنية وموسيقا وإضاءة مدروسة، وكل ذلك يحتاج إلى مايسترو يقود كل هذه المكونات الفنية ببراعة هو المخرج، وهو يحتاج إلى ثقافة شاملة وعلم وتجربة فنية غنية وطويلة.