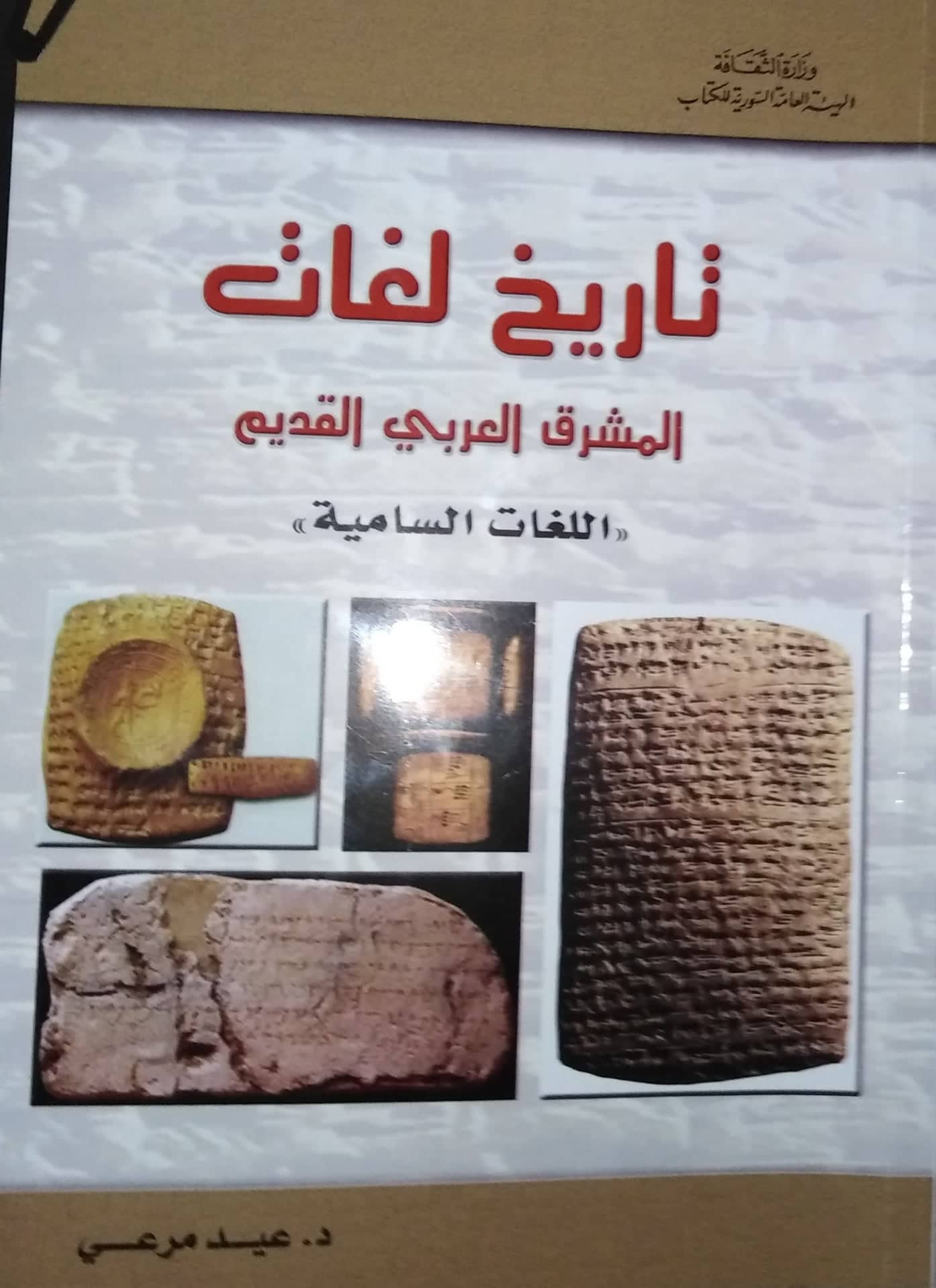همنغواي.. يبكي!
نعم، ها هو همنغواي (1899 – 1961) يبكي ناحباً في يومياته ومذكراته التي كتبها عن الحياة التي عاشها، يبكي غربته عن بلاده (الولايات المتحد الأمريكية) التي تركها بعد أن حاز على الشهادة الثانوية، ومضى إلى بلاد أوروبا التي كان الأمريكان يعدّونها، وربما ما زالوا، جنّة الدنيا، لأنها بلاد العمران، والعلم، والآداب الفنون، على الرغم مما شهدت هذه البلدان من حروب كاوية، أذابت فرح سنوات طوال شُغل أهل أوروبا خلالها بثقافة الكراهية والقتل والتدمير ولأسباب كثيرة ربما لا يأتي عليها جميعاً عقل واع!
يبكي همنغواي تشرده في الليالي، ومطاردة اللذائذ، والخيبات الكثيرة التي واجهها، لأنه ما أحسّ بالطمأنينة في مكان من الأمكنة التي عاشها في أوروبا، وأنه بسبب هذه الغربة رمى بجسده وروحه في أتون الصراعات التي عرفتها أوروبا وعمره لم يتجاوز عشرين عاماً، حتى المناسبات الرياضية ذهب إليها بعقله وروحه وجسده لعله ينتهي من أسئلة القلق وتعب الجسد، وأنه كان يتوق إلى العودة كي يعيش الطمأنينة التي عرفها قبل أن تأخذه يد الغربة اغترافاً من الأسئلة التي طرحها على نفسه آنذاك، ولم يجد لها الأجوبة!
ويمضي همنغواي سارداً وجوه غربته وما عاناه، على الرغم من أنه التقى بأدباء وفنانين وقراء أثنوا على كتاباته، مثلما أثنوا على خروجه من الولايات المتحدة (التي راحت تقلّد آداب أوروبا وفنونها، من دون أن تطرح جديداً لافتاً للانتباه) كي يكون قريباً من عالم الإبداع والصياغة للآداب والفنون في أوروبا، ومن بين هؤلاء الأدباء والفنانين الذين أثنوا على كتاباته وخروجه عزرا باوند (1885-1972) المهاجر الأمريكي أيضاً إلى جنة أوروبا، وبابلو بيكاسو(1881-1973) الذي أعجب بتفرّد تجربته الأدبية ، وتعدد مغامراته التي أغنت أدبه!
كنتُ، وأنا أقرأ يوميات همنغواي ومذكراته التي جعلها تدور نائحة على غربته وتشرده، ولاعنة حظّه النكد الذي رماه خارج فضاء الطمأنينة، فلا هو يطمئن إلى البيوت التي عاش فيها، ولا إلى الزوجات (والصديقات) اللواتي عاش معهن، ولا إلى الكتابات التي كتبها عن الحرب العالمية الثانية (التي شارك فيها سائقاً لسيارة إسعاف، الحرب التي ملأت جسده بالشظايا)، ولا الكتابات التي دارت حول العنف في الرياضية، أو العنف الذي يواجه المغامرات مجهولة الطُّرق والنهايات، لا بل إن هذه الكتابة والمغامرات أورثته أسئلة القلق المرضي مما جعله يعيش سنوات حياته الأخيرة في حالة مرضية من الاكتئاب الشديد ، وسؤاله الخرافي يجول في لهاته: ما جدوى الحياة، وأيّ غربة عشت!
حين انتهيت من قراءة يوميات همنغواي ومذكراته، وما فيها من بكاء، وأحزان، وقلق، وخوف، وأسئلة، وأحلام، قلت بعالي صوتي منادياً عليه: يا عم همنغواي، أنت تقول هذا عن حياتك في أوروبا وبعدك عن الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا نقول نحن، كتّاب المنافي وفنانوها، وقد هجّرنا وشرّدنا ظلماً وعدواناً من بلادنا فلسطين، وفي قلب كلّ منا أسى لفقدان جد، أو أب، أو أمّ، أو أخت، بعد فقدان الأرض، والعيش في الخيّام التي أنسناها وجعلناها بيوتاً كي تحيط بأحزاننا؛ الخيّام التي حافظت على روايتنا وأحلامنا، والخيّام التي أخفت ضعفنا، وجمّرت وعينا، وعزّزت انتماءنا، كيف لنا، ياعم همنغواي، أن نقارن غربتنا بغربتك؟! همنغواي العزيز، لو عرفت الغربة حقاًّ، كنت التفت إلى غربتنا ومأساتنا، وأنت الذي أخذتك الغربة إلى كلمنجارو!
ترى هناك، في كلمنجارو، ألم تسمع نشيج أمهاتنا اللواتي يودّعن الأبناء الشهداء على حدود المقابر التي اتسعت أكثر من القرى، وأكثر من المدن؟!
بلى، يا صاحب “الشيخ والبحر”، الفارق بين غربة وغربة كبير، بأول كبير جداً !
حسن حميد
Hasanhamid55@yahoo.com